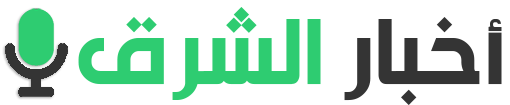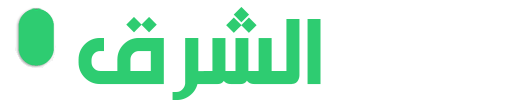“أدب النسيان”.. فك الارتباط بالماضي
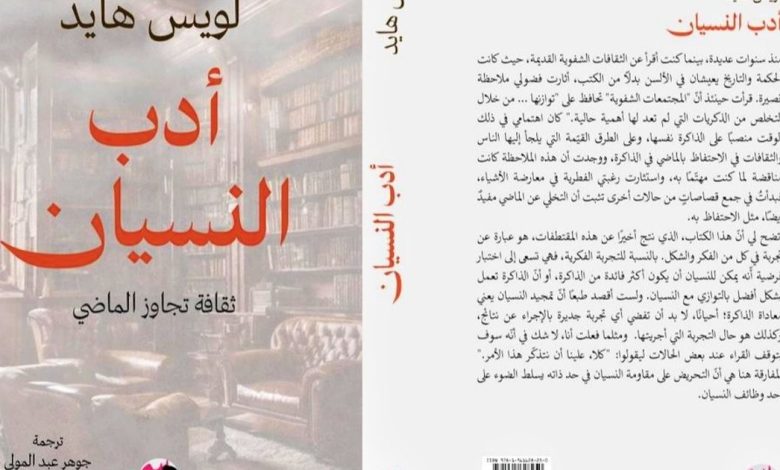
يجمع الكاتب الأميركي لويس هايد في كتابه “أدب النسيان”، الذي صدرت ترجمته العربية عن (منشورات وسم)، بين الارتباط الحر والنسيان الحر أيضاً، ويرى أننا مخلوقات متقطعة، متناثرة في الزمن، ومعنى وجودنا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتخيله.
يعتقد هايد أن النسيان هو الشكل الوحيد للمغفرة. إنه الانتقام الوحيد والعقاب الوحيد أيضاً، بل إن العفو والانتقام كلمتان لجوهر واحد هو النسيان.
يرى الكاتب أننا نستطيع إدراك الزمن فقط من خلال ملكَتي العقل، وهما الذاكرة والنسيان، فهما كفيلتان بتنشيط الخيال والإبداع. نحن أيضاً مخلوقات متقطعة، متناثرة في الزمن، ومعنى وجودنا شيء لا يمكننا إلا أن نتخيله.
إنهما عمليتان متوازيتان، تعملان مثل غربال يصفّي ما يزعجنا في ماضينا، ليس بمحوه بل بجعله بارزاً، أي بتذكّر مضمونه، وبعدها نتجاوز التراكمات، وننظر نحو المستقبل.
يشرح ذلك عبر مقاربة جديدة، اختار فيها شكل التداعي الحرّ للأفكار قائلاً: “قررت بناء كتابي هذا على قصاصات جمعتها بدلاً من استغلال محتواها، من أجل الحصول على وصفة سردية تقليدية”.
وظّف الكاتب مقتطفات من الأساطير الغربية والشرقية، والمقالات والحِكم والنوادر والتأملات والنصوص، في أربع مفكرات تتداخل مع تجارب شخصية وسياسة، أبرزها مخلفات الحرب الأهلية الأميركية، وإصابة والدته بداء الزهايمر، بأسلوب يذكّرنا بكتب العرب القدامى مثل الجاحظ والأصبهاني، اللذان كانا يدرسان موضوعاً ما عبر تجميع ذكي لكل ما قيل أو كُتب عنه.
حساء النسيان
تحت عنوان الأسطورة وانحلال الزمن، يتعقّب لويس هايد تجليات النسيان العديدة، بعد أن يحدده لغوياً. فالنسيان باللغة الإنجليزية، يعني ترك الأشياء تغادر وعينا. وفي اللغة اليونانية تعني المحو أو التستّر أو الإخفاء. وما بين الترك والإخفاء، تحل لحظات التذكر عبر لغة الكلام، الذي ينتج أدباً تراكمياً مع مرور الزمن.
يدلّ الكاتب على ذلك من خلال أسطورة صينية، تقول إن عجوزاً اسمها “منغ” تجلس عند باب الخروج من العالم السفلي، لتقدم حساء النسيان لكل الأرواح التي سوف تُبعث من جديد في طريق عودتها إلى الحياة، بعد أن تكون نسيت عالم الأرواح والأجساد السابقة التي عاشت فيها، ونسيت الكلام أيضاً.
إلا أن الأسطورة لا تغفل أن تشير إلى أمر مهم، وهو ولادة طفل إعجازي من حين إلى آخر، يستطيع أن يتحدّث لأنه لم يشرب حساء النسيان.
هذا الحساء يتحوّل إلى ماء في حكاية يونانية، يشربه في العالم السفلي من يودّ معرفة مستقبله، لكي يمحي ماضيه بالكامل أولاً، قبل أن يشرب ثانية من بِركة الذاكرة، التي يكون ملأها بكل ما شاهده من وقائع جديدة. ذلك أن “كل فعل من أفعال التذكر هو فعل من أفعال النسيان أيضاً”، بحسب الكاتب.
يفسر هايد العلاقة بين الأساطير والصور والأحلام قائلاً: “إن الذات تولد من جديد مع كل نفَس نأخذه، وإنها تغادر الوجود، ثم تعود إليه باستمرار مع تبدل الظروف. يجذبنا شعورنا البشري بالعطش نحو مياه النسيان ومياه الذاكرة”.
ذاكرة الندوب
ومن وسائل مراوحة الذات بين النسيان والتذكر، يورد الكاتب ما يسميه بالندبات القبلية، وهي الجروح المادية أو المعنوية التي نتعرض لها، إرادياً أو بالصدفة، والتي تطبعنا بكل تاريخها وأحداثها وعاداتها وأخلاقها.
تقدم لنا الذكريات المؤلمة العميقة برأيه، أمثلة نموذجية وواضحة حول فوائد النسيان. ويذكر في هذا السياق قصّة جندي أميركي من أصول أفريقية، درّبه الجيش على استخدام الأسلحة، وعلّمه كيف يصبح قاتلاً، لكن طيف أخيه الذي لم يكفّ عن مطارته في الكوابيس، جعله رجلاً جاهزاً للتخطيط لقتل الرجال البيض، ومنهم أفراد جماعة “الكوكلوكس كلان” العنصرية، الذين نكّلوا بأخيه، وقتلوه ثم أفلتوا من العقاب.
لم ينتقم لأخيه بقتلهم، لكنه في المقابل رفض النسيان، وراح ينبش في ذاكرة كلّ من كان متصلاً بالحادث حتى انكشفت الحقيقة.
شخص ما يتذكر
يوسّع لويس هايد من نطاق العلاقة الدامية ما بين النسيان والذاكرة، من خلال جريمة أخرى شهدتها أميركا، وتتعلق بمجزرة بشعة لمخيم الهنود الحمر في القرن التاسع عشر.
ولأنه يوجد شخص ما يتذكر دائماً، تمّت المصالحة مع الذاكرة، وإقامة نصب تذكاري سنة 1950، وتمّ دفن القتلى رمزياً سنة 1978. حدث ذلك بعد معركة طويلة، غلبت فيها سردية البيض الذين كانوا ينفون المجزرة، ويقولون إنها مجرد معركة عسكرية خاضها الجنود ببسالة ضد الإرهاب.
نسيان الأمم
لكن بعد ظهور العديد من الحقائق، فُرض نسيان الأمر بشكل رسمي، في سبيل دمج كل مكوّنات المجتمع الأميركي في سردية واحدة جامعة تحت عنوان التثاقف.
هذه السرديات تكرّرت كثيراً في إسبانيا الديكتاتورية بعد وفاة الجنرال فرانكو، وتمّ اعتماد ميثاق النسيان. كذلك في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية عبر النسيان الجماعي. وبعد المجازر ضد المسلمين والكرواتيين في يوغوسلافيا السابقة. وفي أكثر من مكان تبعاً لما يسمى بالعفو العام، الذي يعني النسيان القضائي، ذلك أن “عدم النسيان يدمّر الأمم” كما يقول هايد.
ثم هناك أخيراً النسيان الفردي، وهو ما حصل للكاتب إمري كويتس الحاصل على جائزة نوبل، والناجي من المحرقة النازية. إذ كتب: “إذا لم أكن قد نسيت ما حصل بمعنى الكلمة، فقد تبخّر كل شيء بمجرد أن حوّلته إلى كلمات ورقد بداخلي”.
متحف النسيان
على غرار الكاتب إمري كويتس، تعقّب لويس هايد آثار النسيان وآليات التذكر في الإبداع، وذكر في هذا الصدد الكاتب الفرنسي مارسيل بروست، صاحب الرواية الضخمة، البحث عن الزمن المفقود، كأحد أبرز الكُتّاب الذين نقلوا بواسطة الكتابة عمل الذاكرة التي تستعيد حياة الكاتب ذاته، تأسيساً على “ممارسة التنقيح بالنسيان”، من خلال الانتقاء الذي تقوم به “الذاكرة غير الإرادية”.
هذا يفسّر الفقرة الأولى المدهشة من الرواية، حين مكّنت رائحة الحلوى في كوب الشاي داخل منزل الجدّة، من نقل الراوي/ الكاتب إلى سنوات خلت، فتداعت أحداثها تباعاً، معيدة تركيب زمن آخر تمّ تدبيجه في آلاف الصفحات.
هذه الأحداث مستمدّة من متحف النسيان، الذي يشمل جميع الأشياء التي تحيط بنا، والتي يوظّفها المبدعون كلّ في مجاله، فالمعارك التي نخسرها بحسب الكاتب، وليس المعارك التي نكسبها، هي التي تتشبث بالذاكرة، وتصبح الأمور التي لم تجد خاتمة ملائمة لها، فصلاً افتتاحياً لقصة لا يمكن نسيانها. وهكذا هي ذاكرة الأفراد وذاكرة الأمم.
طائر في الهواء
في الصفحات الأخيرة من الكتاب، يلفت الكاتب انتباهنا إلى أننا سنعيش تجربة النسيان مع كتابه هذا. سنتذكر مقتطفاً هنا أو هناك، وننسى ما عداهما. وبالفعل هذا ما يحدث، لأنه عمل أدبي ممتع ورائع يجعلنا نعرف حقائق جميلة عن الإنسان.
وآخر هذه الحقائق تتعلق بالطيور التي يفترض أن لا تترك أثراً في السماء حين تهاجر كل عام من مكان إلى آخر قائلاً: “لكل طائر القدرة على تقفّي الأثر الخفي الذي تركه أجداده. تعرف الطيور أي طريق سوف تسلكه كل موسم”.
لذا ليس غريباً أن نقرأ للكاتب البرتغالي الشهير فرناندو بيسوا هذا القول الجميل: حلّق أيها الطائر، حلّق بعيداً، علمني كيف أختفي.