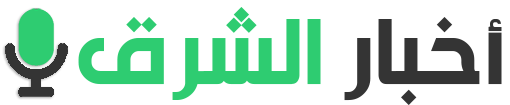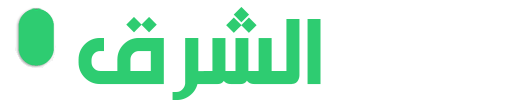“ذاكرة الحرب لا تصدأ” في أعمال الفنان العراقي قيس السندي

في معرض الفنان العراقي قيس السندي، “ندوب على وجه الأرض.. دمار الحروب”، الذي يقام في كاليفورنيا، تتجلى الآلة العسكرية وحيدة منفصلة عن الإنسان الذي يحركها، وكأنها كائن مسلوب الإرادة، ينتظر من يشحنه بالحياة، أو يتركه في سبات أبدي.
في صالة “سان دييغو آرت أدفايزوري”، تتوزّع أعمال الفنان ضمن مشروع متعدد الوسائط، يتضمن اللوحة، والفن التركيبي، والفن الصوتي، ويدعو المشاهد إلى مواجهة الحرب، عبر تأمل مآسيها التي لا تُمحى، وتبعاتها التي تمتدّ إلى ما بعد آخر رصاصة.
لا يظهر القاتل في أعمال السندي، بل تبقى الأداة مجرّدة من فعلها الأصلي. الآلة، في غياب الإنسان تبدو مسالمة، لا تحمل أي نية عدائية، غير أنها تستعيد وظيفتها القاتلة بمجرد أن تقع في قبضته.
“الشرق” تفتح حواراً مع الفنان المولود في بغداد، والمقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، حول مشروعه وأثر الحرب في أعماله.
قمت بتحويل رموز الحرب كالدبابة المهجورة إلى شهادات بصرية تتخطى حدود الحدث، كيف نشأ هذا التحول في رؤيتك الفنية؟
أنا ابن حروب متلاحقة، اختبرت أولها وأنا لم أتجاوز 13 سنة من عمري، ومنذ ذلك الحين، تشكّلت في داخلي خريطة من الصور المتشظية: دبابات محترقة، جثامين هامدة، مدن تهوي، وعيون لا تزال تنظر رغم الموت.
هذا التحوّل لا يُصنع بلحظة إلهام عابرة، بل هو حصيلة تراكم طويل لذاكرة مجروحة، تختزن في أعماقها مشاهد مؤلمة تعذّرت على النسيان.
كانت هذه الصور بمثابة عبء ثقيل على روحي، لا يمكن الهروب منه. وجدت نفسي مدفوعاً، لا باختياري تحويل هذه الذاكرة إلى فعل بصري، ولا بوصفها توثيقاً للدمار، بل كحوار صامت مع المعنى. في غياب الإنسان، تتحوّل الدبابة من أداة قتل إلى كيان في حالة سكون، كأنها تتأمل دورها، أو تندم عليه.
لكن هذا التحوّل غيّر أيضاً من دلالات الآلة الحربية؟
حين كنت أعدّ رسالة الماجستير في كلية الفنون بجامعة بغداد، وكانت بعنوان “الرسوم الدينية في كنائس العراق وأديرته”، كان يتحتم عليّ زيارة الأماكن المسيحية الدينية، لذا وجدت نفسي أتنقّل بسيارتي بين محافظات العراق كافة، من شماله إلى جنوبه.
كان ذلك بين عامي 2003–2004، في أعقاب الاحتلال الأميركي. في تلك الرحلات، وعلى امتداد الطرق المدمّرة، كانت عيناي تلتقطان بقايا الآليات المحترقة، منتشرة على جانبي الطريق، كأنها مخلوقات متروكة، كنت أتأملها وكأنها كانت تدعوني كي أصغي إليها.
من هنا بدأ تحوّلي البصري. لم أعد أراها رموزاً للقوّة، بل أجساداً صدئة مثقلة بتاريخها، منهكة، تتجرّد من وظيفتها العسكرية. هذا الانزياح من سطوة الحديد إلى خفوت الذاكرة، من العنف إلى السكون، هو ما يحرّك دلالاتها الفكرية في أعمالي.
هل ترى أن تحويل رموز الحرب إلى أعمال فنية يُعدّ شكلاً من أشكال مقاومة العنف أم أنه تأمل فلسفي؟
قبل أيام كنت في حوار مع صديق وسألني: كيف يمكن للمتلقي أن يفرّق بين أعمالك التي تجسّد رموز الحرب، وبين لوحات أخرى لفنان يرسم الحياة الجامدة- رموز حرب – حسب الطلب، بمعنى آخر، أين تكمن الروح، وأين يتجلى العمق في خضم تشابه السطح البصري أحياناً؟
أجبته إن العاطفة التي تشحن لوحاتي لا يمكن إخفاؤها. فهي تنبض في ضربات الفرشاة، في الأسى المرتجف بين طبقات اللون، وفي صمت التفاصيل الذي يصرخ أكثر من الكلمات. ليست اللوحة مجرد موضوع مرسوم، بل هي ذاكرة مشبعة بالتجربة، مشحونة بالمواجع، تنقل الحقيقة دون صراخ عالٍ.
أنا أؤمن أن العمل الفني يعمل كمِرآة. ما يهبه الفنان للوحة، تهبه اللوحة بدورها للمتلقي. ولذلك، فإن ما أقدّمه ليس مجرد تأمل فلسفي، بل هو فعل مقاومة للصمت والعنف والنسيان.
كل دبابة مرسومة وحيدة، كل أرض متصدّعة على سطح اللوحة، ليست فقط رمزاً لما كان، بل نداء لما يجب أن يكون. إنها دعوة للتأمل، لكن أيضاً تذكير صارخ بحتمية السلام الذي لا يزال مفقوداً.
هل يفضل أن يتناول الفنان الحرب بأسلوب تجريدي يُعبّر عن أثرها النفسي والعاطفي، أم أن التوثيق البصري لفظائعها هو الأقرب إلى الحقيقة الفنية والإنسانية؟
لكل فنان أسلوبه الخاص به، وكذلك عدّته وأدواته التي يستحضر بها تجربته. البعض يختار التوثيق المباشر كصرخة، والبعض الآخر ينزاح نحو التجريد، كأنما يلوذ بالفن ليفهم عمق الجرح لا سطحه. أما أنا، فحتى في أعمالي التي قد تبدو للوهلة الأولى توثيقاً بصرياً لأحداث أو رموز حربية، فإنها في تفاصيلها تتحوّل إلى أعمال تعبيرية، بل وأحياناً تجريدية، تسكن فيها المشاعر أكثر من الوقائع.
أنا لم أنتهِ بعد من عصر تلك “الإسفنجة” التي امتصّت وجعي وذاكرتي. لا يزال لدي الكثير لأقوله في هذا السياق، وربما تأخذ الأشكال التي أرسمها ضمن هذه السلسلة مسارات جديدة، تميل نحو التجريد، أو تتقاطع مع أساليب ما بعد الحداثة، حيث الشكل لا ينفصل عن الفكرة، واللون يصبح حاملاً للصوت الداخلي.
في غياب الوجوه كيف تتحدث اللوحة عن المعاناة والذكرى، وهل يمكن للفراغ أو الآثار المتروكة أن تكون أكثر تعبيراً من البشر؟
فعلياً، لا أرسم الإنسان كجسد أو ملامح، بل أرسم ما خلّفه وراءه: ما اقترفته يداه، وما تركه من صدأ، عطب، وبقايا دخان. لست بحاجة إلى وجه حزين أو جسد مرتجف كي أتحدث عن المعاناة. فالنتائج، في نظري أبلغ من الشكل.
الطائرة المقاتلة المحروقة، الجدار المثقوب، الأرض المتشققة كلها شواهد أكثر صدقاً من أي تعبير وجهي. الفراغ في اللوحة ليس غياباً، بل حضور مكثّف للغياب نفسه. هو الذكرى التي بقيت حين غادر الجسد.
إلى أي مدى يمكن للفن التشكيلي أن يسهم في تشكيل ذاكرة جماعية حول الحروب بعيداً عن السرديات السياسية أو العسكرية؟
في زمن اجتياح الصورة، وسط زحام “الريلز”، والمنشورات السريعة التي تصنعها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يجد الفن التشكيلي نفسه كمن يعيش في صومعة، يحاول أن يُسمع صوته في خضم هذا الضجيج البصري الهائل.
ومع ذلك، يظل للفن التشكيلي قدرة فريدة على تشكيل ذاكرة جماعية، متى ما أصرّ الفنان على أداء دوره الحقيقي، بعيداً عن السرديات الجاهزة التي يكتبها المنتصرون عادة. الفن إذاً لا يلاحق التاريخ، بل يعيد تشكيله من الداخل، لا عبر السرد، بل عبر الأثر.