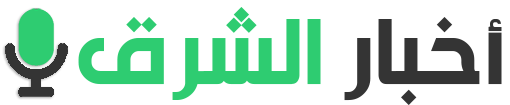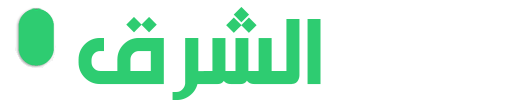خالد الخميسي: “أجنحة المتاهة”رواية تفرض شخصيتها على الكاتب

حينما قدّم كتابه الأول “تاكسي.. حواديت المشاوير” عام 2007، استطاع الكاتب المصري خالد الخميسي، رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة الكبرى، أن يفتح نافذة جديدة أمام القارئ، تعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الهموم الشخصية للناس، من خلال عمل أدبي صار علامة فارقة في الأدب العربي، بلغته البسيطة وأسلوبه القريب من الناس.
ومع مرور أكثر من خمس سنوات على صدور روايته “الشمندر”، ترك “الخميسي” خلفه حالة من الترقّب والفضول، انتظاراً لعمل جديد، وحينما ظهر في الجلسة الافتتاحية لملتقى القاهرة الأدبي، أعلن أنه بصدد الانتهاء من كتابة رواية جديدة.
“الشرق” التقت الخميسي، الذي تُرجمت أعماله إلى لغات عدّة من بينها الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والألمانية، وحاورته حول روايته الجديدة ومشروعه.
نبدأ بالسؤال الذي يطرحه الكثيرون، أين أنت ولماذا هذا التوقف عن الإنتاج الأدبي؟
أعمل منذ سنوات على رواية شارفت على الانتهاء منها عنوانها: “أجنحة المتاهة”، تجري أحداثها في زمان ومكان غير محددين، وتشكّل المتاهة الرمز المركزي في الرواية، وهي هنا ليست مكاناً غامضاً. كما ترمز الأجنحة إلى وسيلة الخلاص، والقدرة على التحليق فوق المعوقات.
كل عمل أدبي يأخذ من الزمن ما يشاء، فالعمل يفرض شخصيته على الكاتب. هناك أعمال طيبة تتعامل مع الكاتب برفق، تلك التي لا تأخذ منه وقتاً طويلاً، وهناك أعمال مطالبها من الحياة أكثر، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والبحث والتفكير. و”أجنحة المتاهة” من تلك الأعمال المجهدة. أتمنى أن تنال إعجاب القارئ.
هل أنت ممن يكتبون يومياً، فالكتابة كما يقال “فعل مقصود” ويجب على الكاتب ممارستها بانتظام؟
هناك مقولة قديمة تشير إلى أهمية الكتابة اليومية، وهي “nulla dies sine linea” وترجمتها من اللاتينية “لا يوم من دون سطر”، تُنسب إلى الرسام اليوناني القديم أبيلس، وهي تحثّ على المثابرة والالتزام بالعمل اليومي في أي مجال إبداعي.
ومعروف أن الكاتب الفرنسي إميل زولا، كان يرى تلك الجملة كل صباح عندما يدخل مكتبه للعمل؛ فقد أمر بحفرها على رف مدفأته، وكان يجلس إلى طاولته “مثل تاجر إلى منضدته”، ويكتب نحو ثلاث صفحات بعد أن يكون قد أعدّ ملفات تحضيرية. كانت الكتابة بالنسبة لزولا فعل مؤلم كولادة طفل.
الكتابة بالنسبة لي فعل مبهج. أجلس إلى طاولتي أشعر بالفرح وكأني سأقابل أعز الأحباب. لا أكتب كل يوم، ولا أكتب ملاحظات. تتم الكتابة داخل رأسي أولاً. وتظل الفكرة تترسخ مع الوقت.
في بعض الأحيان أحتاج إلى سنوات كي أشعر أن الفكرة قد نضجت كفاية، لكني أعترف أني تمنيت دائماً أن أكتب كل يوم. وما زلت أمني النفس أن ألتزم بالفعل بالجلوس كل يوم وكتابة سطر على الأقل.
هل يعكس الأدب الواقع والظرف التاريخي على المستويين المحلي والعالمي؟
يبدأ السرد من الواقع كمادة خام؛ فالحياة اليومية والشخصيات والأمكنة، وحتى الصراعات الوجودية، تُستلهم من وقائع ملموسة أو رؤى ذاتية، تستند إلى تجربة الكاتب.
لكن الواقع في النص الأدبي ليس نسخة طبق الأصل، بل هو واقع معالج جمالياً، تُسحب منه التفاصيل التافهة، وتبرز الرموز الدالة لتشريح الواقع.
أما عن الخيال، فهو المساحة التي يحرّر فيها اللاوعي الجمعي، كفضاء للتمرد واختراق الممنوع، حيث يصارع المكبوت، ويصير أداة لفك تشفير الواقع عبر المبالغة والغرائبية أحياناً. السرد الروائي ليس صراعاً بين الواقع والخيال، بل هو تجاوز لهما معا.
الرواية الناجحة تعيد تعريف “الواقع” نفسه. إنها تحفر فيما وراء الظاهر، وتصنع عالماً موازياً تُختبر فيه الحقائق البشرية بلا قيود. أو كما قال بورخيس “الواقع ليس سوى أحد احتمالات الخيال”.
هل يمكن أن يكون الأدب- وتحديداً الرواية- هي المسار الأكثر أماناً وصدقاً للكتابة عن الواقع في فترات الضغط؟
هل هناك واقع موضوعي واحد، أم أن “الواقع” مجرد بناء ذهني مشترك نتفق على تسميته كذلك؟ نحن أمام منطقة ضبابية بين الوجود والإدراك؛ فلو شهد خمسة أشخاص حادث سير واحد، لأنتج كل منهم رواية مختلفة بناء على زاوية النظر لها، وطبيعة الذاكرة الانتقائية، والتأويل الثقافي لكل منهم.
عبّر العديد من الأدباء عن تعددية الحقيقة. يمكنني أن أذكر على سبيل المثال رواية “راشومون” للكاتب أكوتاغاوا ريونوسوكي (تحوّل إلى فيلم للمخرج “أكيرا كوروساوا)، جريمة قتل واحدة تُروى بأربع روايات متناقضة، كل منها يبرر ذاته ويكشف هشاشة “الحقيقة”.
هناك أيضا “الصخب والعنف” للكاتب ويليام فوكنر، الأحداث نفسها يتم سردها عبر وعي أربع شخصيات، كأنما فوكنر يقول: “الحقيقة وليدة الزاوية التي تنظر منها”. صحيح أنه يمكننا أن نتصور أن هناك “واقع” موضوعي خارج الذات وخارج اللغة، ولكن يظل هذا الأمر في الإطار النظري البحت. ولكن واقعنا نحن يقع داخل حدود الذات وداخل حدود اللغة، وبالتالي داخل حدود التأويل.
هل صحيح أننا في زمن الرواية التاريخية وكتب إعادة قراءة الأرشيف؟
الانزياح نحو التاريخ ليس هروباً، بل تمرّداً على سردية الحاضر المهيمنة. الأرشيف أداة لاستعادة الوكالة الفردية والجماعية في عصر تُحاك فيه الحقائق أمام أعيننا. قد يكون اللجوء إلى التاريخ هروباً إذا كان الهدف هو تجنّب التعامل مع تعقيدات الحاضر، مثلاً كتابة روايات تمجّد الماضي من دون طرح أسئلة نقدية.
نعم هناك روايات تاريخية من هذا النوع، لكني لا أعتبرها كتابة جادة. وإنما العمل على تفكيك الروايات الرسمية، والكشف عن تشوهات سرديات الماضي، عن طريق مواجهة نقدية، هو كتابة تستحق القراءة.
كشفت “تاكسي.. حواديت المشاوير” عن مشكلات كثيرة، بعد نحو 20 عاماً هل تجد أن فئة سائقي التاكسي لا تزال تعبّر عن حقيقة المجتمع؟
كما كتب د. عبد الوهاب المسيري عن كتاب “تاكسي”، فالسيارة هي مسرح صغير تدور فيه أحداث الحياة اليومية. يصوّر الكتاب المدينة كمكان معقّد ومتنوّع، يعج بالتناقضات والصراعات الاجتماعية. يكشف عن التغيّرات التي طرأت على المجتمع الحضري، مثل التوسّع العمراني، وظهور الأحياء العشوائية، وتغيّر أنماط الحياة.
يظهر كيف يتأثر الأفراد بهذه التغيّرات، وكيف يتفاعلون معها. يكشف عن التحديات التي تواجه الأفراد في الحفاظ على هوياتهم الثقافية في ظل العولمة وتأثير الثقافات الأخرى. وكيف يحاولون إيجاد مكان لهم في المجتمع.
يتضمن الكتاب انتقادات للسلطة السياسية، ويتحدث عن الفساد والاستبداد الذي نعاني منه. وكيف يتأثر الأفراد بالقرارات السياسية، وكيف يتفاعلون معها. أتمنى أن يكون الكتاب خارج إطار زمني بعينه، وبالتالي لو كتبت هذا الكتاب اليوم، فلن أغير فيه حرفاً.
تكتب بالعامية والفصحى الممتزجة بالعامية. كيف يقرر الكاتب اختيار اللغة التي سيعبّر بها عن الفكرة؟
يرتبط اختيار الكاتب للمستوى اللغوي بالعالم التخيلي للعمل الأدبي، ونوعية الشخصيات وبيئتها؛ فمثلاً كان من الصعب أن أكتب الحوار الذي يدور بين الراوي وسائق التاكسي بلغة غير مصرية. فطبيعة النص في كتاب “تاكسي”، تحتم على الكاتب أن يكتب بالمستوى اللغوي الخاص بشخصية سائق التاكسي القاهري.
في رواية “سفينة نوح” اختلف المستوى اللغوي حسب كل شخصية. فلغة الأستاذ الجامعي مرتضى البارودي تختلف تماماً عن لغة المراكبي حسونة صبري مثلاً، وفي “الشمندر” كانت اللغة عربية فصيحة لأن طبيعة الرواية فرضت هذا المستوى اللغوي. قد يستخدم الكاتب لغة معقّدة ومجازية للتعبير عن موضوع فلسفي أو وجودي، ولغة شعرية في عمل آخر.
أطلقت منذ سنوات مؤسسة “دوم” المعنية بنشر الثقافة، هل تجد أن تجذير الثقافة في الشخصية أحد أدوار الدولة خاصة خارج العاصمة؟
الثقافة ليست زينة للتنمية، بل هي قلبها النابض. نتحدث كثيراً عن أهمية التعليم كركيزة أساسية للنمو، وللأسف حديث بلا جدوى؛ فالمؤسسة التعليمية في مصر في حالة سيئة جداً. لكننا لا نولي الثقافة الأهمية اللازمة. وأساس الثقافة هو التفكير النقدي، وإعادة التفكير في كل المسلمات، وهدم ما يجب هدمه من أفكار سامة تحيطنا.
قامت مؤسسة “دوم” على دعم التفكير النقدي في المجتمع. فلا توجد ثوابت في مجال الثقافة، وإنما محيط من المعرفة نسعى لتفكيكه وفهمه ونقده، ثم البحث عن مكامن النقص فيه، ثم تطويره. فلنأخذ مثلا بسيطا تتكرر مسابقات حفظ القرآن في أماكن كثيرة، ولكنني لم أشاهد مسابقات على فهم وتحليل النص القرآني. وربط معانيه بنصوص أخرى في تاريخ الإنسانية. فثقافة النقل لن تنفعنا في شيء. بينما اكتساب أبجديات التحليل والنقد والإبداع وإعمال الخيال فهذا ما نحتاجه، ولن يتأتى إلا بتغيير الثقافة القائمة.
حصلت على وسام فارس للفنون والآداب من الحكومة الفرنسية عام 2021، كيف تنظر للجوائز؟
لا أظن أن المبدع، أو الكاتب، أو الفنان يجب أن ينتظر تكريماً من أي جهة. المفروض أن يكتفي برضاه الشخصي عما ينتجه من فن أو كتابة أو غيرها.
يجب أن يكون الكاتب حراً. تلك الحرية الحقيقية هي أجنحته إلى الخيال. أما التكريمات فتأتي دائماً من حكومات، أو جهات لها سياسات بعينها. وكل جائزة لا تخلو في الحقيقة من الانحيازات. ولكن لا مانع من أن يحصل كاتب على جائزة. قد ينتج ذلك عن سعادة من حوله في محيطه الاجتماعي.