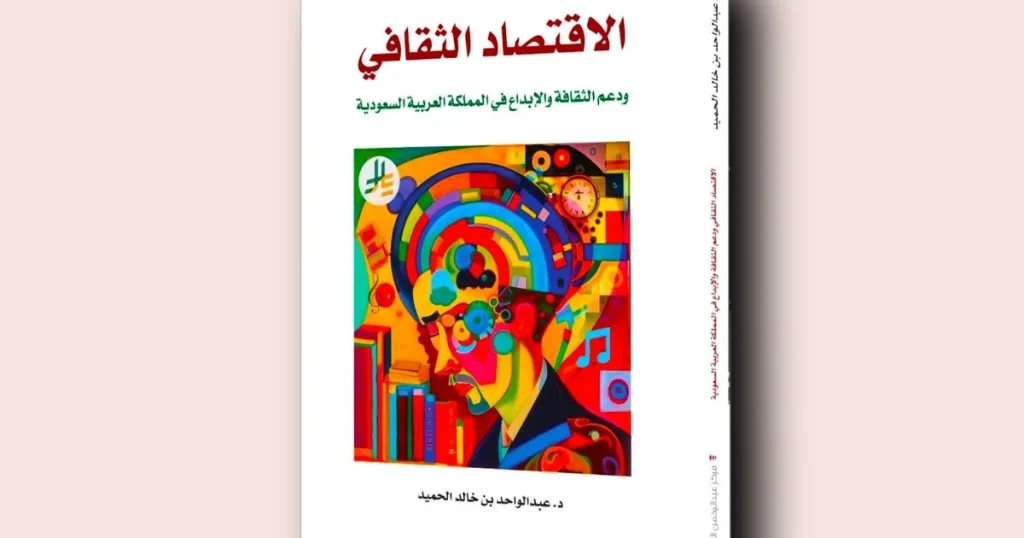في السنوات الأخيرة، استحوذ الاقتصاد الثقافي على نقاش عالمي، مع تحوّل الثقافة من قيمة جمالية إلى قطاع اقتصادي مؤثر في الناتج المحلي للدول.
ومع انطلاق رؤية 2030 وتأسيس وزارة الثقافة، برزت الحاجة إلى فهم أعمق لطبيعة هذا الاقتصاد، والوقوف على مفاهيمه وقيمته وتحدياته.
التقت “الشرق” الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الواحد الحميد، وهو صاحب تجربة ثقافية واقتصادية. أصدر مؤخراً كتاب “الاقتصاد الثقافي”، وتناول إشكالية “لغز القيمة” في الثقافة، وحدود تسليع المنتج الثقافي، وصولاً إلى أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الثقافي السعودي اليوم.
يتناول كتابك الأخير العلاقة بين الاقتصاد والثقافة، الذي جعلك تتجه للكتابة في هذا الشأن؟
هناك دوافع ذاتية وأخرى موضوعية وراء تأليفه. دخلت عالم الصحافة مبكراً، لكن عند التخصص العلمي، اخترت الاقتصاد بعد أن استهواني من خلال تقارير ومقالات اقتصادية في الصحف والمجلات العربية. وهكذا اجتمع لدي شغف الثقافة كهواية والاقتصاد كتخصص.
أما الدوافع الموضوعية، فهي أن الاقتصاد الثقافي أصبح اليوم ذا أهمية عالمية. ورغم أن هذا القطاع قادر على الإسهام في الاقتصاد الوطني من حيث القيمة المضافة، الناتج المحلي، وسوق العمل، إلا أنه كان قطاعاً منسياً لفترات طويلة، ومتناثراً داخل قطاعات أخرى.
كما أنني عضو في الجمعية الدولية للاقتصاد الثقافي في أستراليا منذ عام 2000، وهي تصدر مجلة علمية محكمة، وتنظّم مؤتمرات سنوية. كل ذلك عزز اهتمامي الفكري بهذا المجال الذي يجمع بين فلسفة الاقتصاد ومحتوى الثقافة الفني والجمالي. من هنا بدأت أكتب وأحتفظ بالدراسات حتى حانت اللحظة لتأليف هذا الكتاب”.
منذ 25 عاماً أنت عضو في الجمعية الدولية للاقتصاد الثقافي، ولم تكتب عنه سوى الآن؟
قبل إصدار الكتاب كانت لدي مشاركات في ندوات خارجية واهتمام شخصي بالقراءة في هذا المجال. كنت أجمع قصاصات، لأن الحديث عن الاقتصاد الثقافي كان نادراً.
أما عن نضج الفكرة، فبدأ الاقتصاد الثقافي عالمياَ يأخذ مساحة أكبر خاصة مع ارتباطه بالاقتصاد المعرفي، كنت أكتب وأحتفظ بملاحظات ومواد نظرية منذ سنوات، لكن لم يكن هناك دافع قوي للطباعة، حتى حدث التحوّل الكبير في المملكة مع رؤية 2030، وإنشاء وزارة الثقافة عام 2018. بعدها صدرت الاستراتيجية الوطنية للثقافة عام 2019.
هذه الخطوة وفّرت إطاراً منهجياً واضحاً بخطط وأهداف ومؤشرات قياس، إضافة إلى تقارير سنوية وتقرير الحالة الثقافية. هذا الأمر أتاح مصادر موثوقة للمرة الأولى، عندها عدت لأوراقي وأكملت الكتاب.
هناك عدة تسميات أو مصطلحات عديدة للاقتصاد الثقافي، ترى ما الفروق الجوهرية بينها؟
مصطلح الاقتصاد الثقافي هو الأقدم، ويركز على الفنون والأنشطة التقليدية، وقد ظهر في الستينيات مع دراسات مثل كتاب “المعضلة الاقتصادية للفنون الأدائية”.
أما الاقتصاد الإبداعي أوسع، ويضم الاقتصاد الثقافي إضافة إلى الصناعات الرقمية والبرمجيات والألعاب الإلكترونية، وهو ما تسميه بعض الجهات الاقتصاد البرتقالي لرمزيته للإبداع والطاقة.
أما الاقتصاد الرابع، فهو الإطار الأوسع الذي يركز على المعرفة والإبداع كأصول اقتصادية رئيسة. نستطيع القول بأن الاقتصاد الثقافي جزء من الاقتصاد الإبداعي، والاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد البرتقالي، وكلاهما يقع ضمن الاقتصاد الرابع.
ما المقصود بـ “لغز القيمة” وكيف يمكن قياس القيمة الثقافية وهي غالباً ما تكون غير ملموسة؟
يعرف لغز القيمة بوجود نوعين من القيم لأي منتج، سواء كان مادياً أو ثقافياً، وهي القيمة التبادلية أي السعر في السوق. أما القيمة الاستعمالية وهي مدى أهميته وفائدته بالنسبة للفرد والمجتمع.
لنأخذ الماء مثالاً. فهو رخيص في القيمة السوقية، لكن قيمته الاستعمالية عالية جداً. بينما الذهب غالي في القيمة السوقية، لكن قيمته الاستعمالية منخفضة، لأنه ليس ضرورياً للحياة.
ينطبق هذا المفهوم على الثقافة أيضاً. فهي تحمل قيمتين أساسيتين، القيمة الاقتصادية (التبادلية) التي تقاس بالمبيعات والعائدات وسوق العمل، والقيمة الجمالية أو الرمزية المتمثلة في الإشباع الروحي والجمالي الذي يحصل عليه القارئ أو المستهلك. وقد تكون القيمة الجمالية مرتفعة، لكنها لا تحقق مبيعات، والعكس صحيح.
هل يمكن اعتبار الثقافة سلعة تخضع للعرض والطلب، ويمكن تسعيرها بالشكل التقليدي؟
في الاقتصادات المفتوحة، تحدد آليات السوق من خلال العرض والطلب. لكن في المنتج الثقافي، فإن آليات السوق كثيراً ما تفشل في تحقيق الإنتاج المثالي. تُعرف هذه الحالة تعرف في الاقتصاد بـ “فشل الأسواق”.
يكمن السبب في أن بعض المنتجات الثقافية تعتبر سلعاً عامة، مثل تعزيز الهوية والمعرفة. هذا الأمر يجعل تسعيرها وفق السوق، يؤدي إلى إنتاج أقل من الكمية المثالية، وقد تختفي بعض المنتجات الثقافية بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج، مثل اللوحات العالمية أو الكتب المخطوطة.
ولتجاوز فشل الأسواق الثقافية، لا بد من التدخل الحكومي. ولا أعني بالتدخل الدعم المالي فقط، بل من خلال سن القوانين والتشريعات، ومنح التسهيلات. بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والبنى التحتية، من قبل القطاع الخاص.
هل هناك حدود أخلاقية لتسويق أو تسليع المنتج الثقافي؟
لا توجد معايير موحّدة عالمياً، بل تختلف تبعاً للقيم والأيديولوجيات السائدة في كل مجتمع. هناك مجتمعات قد تسمح بتسويق منتجات ثقافية مثيرة للجدل طالما هناك طلب عليها، بينما ترفضها مجتمعات أخرى استناداً إلى قيمها الدينية والأخلاقية. ويرى المثقفون أن الترويج لمنتجات ثقافية رديئة فنياً يفسد الذائقة العامة، حتى لو جذبت جمهوراً جديداً.
ومن الأمثلة الناجحة في هذا السياق، كوريا الجنوبية وكندا وإيطاليا. حيث استطاعت تحقيق توازن بين التسويق والحفاظ على الهوية الثقافية، من خلال سياسات مدروسة، مثل دعم الإنتاج المحلي، وتقنين استيراد المحتوى الأجنبي، وحماية اللغة والثقافة الوطنية.
ما أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الثقافي السعودي برأيك؟
التحدي الأبرز بالنسبة لي هو غياب الأرقام الدقيقة، سواء الأرقام السنوية أو ما نسميه السلاسل الزمنية. لا أريد رقماً لسنة معينة فقط؛ بل بيانات زمنية ممتدة أو ما يسمى (time series data) تمكنني من معرفة الاتجاهات والقفزات والتغيّرات.
كما نحتاج إلى إحصاءات مقطعية تشمل القطاعات المتشابكة، لتتضح حركة الدخول والخروج بين القطاعات المختلفة، ومدى التأثير والتأثّر هو تحدٍ كبير.
نحتاج أيضاً إلى إحصاءات دقيقة عن عدد العاملين في القطاعات الثقافية. صحيح أن هناك أرقاماً معلنة، لكن التحدي في التعريف بأولئك العاملين، هل هم موظفو وزارة الثقافة، أم هم العاملون في القطاعات الثقافية عموماً، أم هم أصحاب المنشآت، أم من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي كالحرفيين.
لهذا يصعب القياس بدقة، ومع ذلك، يجب أن نقرّ بأننا في السابق لم يكن لدينا شيء تقريباً مقارنة بما يحدث اليوم.
الحقيقة أنا متفائل جداً بمستقبل الاقتصاد الثقافي السعودي. الاقتصاد الثقافي في كل أنحاء العالم يأخذ حيزاً كبيراً في العالم، ونحن على هذا الطريق ماضون.