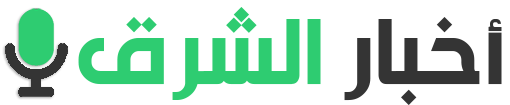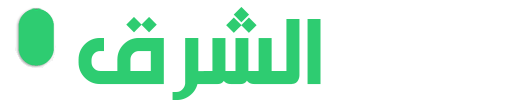المعادن النادرة.. عجز واشنطن الاستراتيجي في مرمى الصين

رغم الهدنة التي وُصفت بأنها فرصة لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن بكين لم تُفرج بعد عن أحد أكثر أوراقها نفوذًا: “السيطرة على صادرات العناصر الأرضية النادرة”.
ففي أعقاب اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي في جنيف، وافقت الصين على تعليق عدد من التدابير الانتقامية، غير الجمركية، التي فرضتها منذ مطلع أبريل، في مقابل تراجع واشنطن مؤقتًا عن بعض الرسوم. لكن الغموض يكتنف ما إذا كانت هذه التنازلات تشمل القيود التي فرضتها الصين مؤخرًا على تصدير سبعة عناصر نادرة تُعد حيوية لصناعات التكنولوجيا والدفاع.
هذه العناصر، التي تُستخدم في إنتاج كل شيء من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى الطائرات الحربية F-35 وأنظمة التوجيه الصاروخي، تقع عملياً تحت هيمنة الصين الكاملة. وقد أثار استمرار الرقابة الصينية على تصديرها قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والعسكرية الأميركية.
اتفاق جنيف.. تكتيك مؤقت
في محاولة لطمأنة السوق، صرّح الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير عقب عودته من جنيف بأن بكين “وافقت على إزالة تلك الإجراءات”، محذراً في الوقت ذاته من أن عدم تنفيذ التعهدات سيعيد الطرفين إلى المربع الأول.
لكن تصريحات جرير، وإن كانت حاسمة، تصطدم بواقع مختلف على الأرض، إذ تشير تقارير إلى أن السلطات الصينية لم تُظهر بعد أي خطوات عملية لإلغاء القيود، بل إنها تُعزز الرقابة، وتُكثف الإشراف على هذا القطاع الحساس.
في المقابل، تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعداد أمر تنفيذي جديد يهدف إلى إنشاء مخزون استراتيجي من معادن أعماق البحار.
وبحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصادر مطلعة، فإن المخزون سيُحتفظ به بكميات كبيرة داخل الأراضي الأميركية ليصبح جاهزاً للاستخدام حال حدوث صراع مع بكين قد يؤدي إلى تقييد واردات هذه المعادن.
واشنطن في قبضة بكين المعدنية
لم تعد المعادن الحيوية تقتصر على المواد التقليدية مثل القصدير والنيكل والكوبالت، التي لطالما اعتُبرت ضرورية للصناعات العسكرية. ففي السنوات الأخيرة، توسّع هذا المفهوم ليشمل مجموعة أوسع من المعادن التي أصبحت أساساً لا غنى عنه في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية، مرورًا بأشباه الموصلات، وصولاً إلى الطاقة المتجددة.
الاتحاد الأوروبي صنّف أكثر من 30 معدناً على أنها “حيوية” بسبب أهميتها الاقتصادية ومحدودية توفرها. أما إدارة ترمب، فتدرج حوالي 50 معدناً ضمن هذه القائمة، من بينها الليثيوم والزنك، نظراً لدورهما الحيوي في الصناعات الحديثة.
ومن بين هذه المعادن، تبرز “عناصر الأرض النادرة”، وهي 17 عنصراً كيميائياً مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، تُستخدم بكثافة في الصناعات الدقيقة. ورغم أن اسمها يوحي بالندرة، إلّا أنها متوفرة في الطبيعة، لكنها غالباً ما تكون مخلوطة ببعضها البعض داخل الصخور، مما يجعل فصلها واستخلاصها عملية معقدة ومكلفة.
ومع كل هذه الأهمية، فإن إنتاج هذه المعادن – وخاصة معالجتها – يتركز خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في الصين. وكما ورد في مراجعة لسلسلة التوريد أجراها البيت الأبيض، فإن واشنطن تعتمد بشكل متزايد على مصادر أجنبية للمعادن الحيوية المعالجة.
بينما تسيطر الصين على الحصة الأكبر من السوق العالمية لتكرير الليثيوم والكوبالت والعناصر النادرة ومعادن رئيسية أخرى. وحتى عندما تُستخرج الخامات من دول أخرى، غالباً ما تُرسل إلى الصين لمعالجتها.
وتشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بنسبة 100% على الاستيراد فيما لا يقل عن 15 معدناً حيوياً، وتعتمد على الاستيراد في أكثر من نصف استهلاكها من معادن أخرى كثيرة. ويُعد اعتماد أميركا على بكين في استيراد نحو 70% من عناصر الأرض النادرة – التي تُستخدم في الصواريخ والطائرات المقاتلة والإلكترونيات – مثالاً واضحاً على هذا الاختلال.
ولم يكن هذا الاعتماد وليد اللحظة، بل هو نتيجة عقود من التخطيط الاستراتيجي الصيني وتراجع القدرات الأميركية المحلية. فقد تراجعت قدرات التعدين والتكرير في الولايات المتحدة نتيجة انتقال الصناعات إلى الخارج وصرامة القوانين البيئية التي جعلت الاستخراج المحلي أكثر تكلفة.
في المقابل، بنت الصين هيمنة شبه احتكارية في مجال المعالجة، بدعم حكومي أحياناً، وتحملت التلوث وهوامش الربح المنخفضة.
من الحرب العالمية للحرب التجارية.. كيف بدأت القصة؟
ومسألة المعادن الحيوية ليست جديدة على صناع القرار الأميركيين، فبعد الحرب العالمية الثانية، وكذا مع بداية الحرب الباردة، حذر الاستراتيجيون الأميركيون من احتمال انقطاع إمدادات معادن حيوية مثل الكوبالت والنحاس والمنجنيز والتنجستن واليورانيوم.
وفي ذروة الاستعداد الأميركي للحرب العالمية الثانية، واجه الرئيس فرانكلين روزفلت أزمة خطيرة تمثلت في النقص الحاد للمعادن الحيوية اللازمة لتشغيل الاقتصاد الحربي، ما اضطره إلى التحرك العاجل ونقل إدارة المخزون الاستراتيجي إلى هيئة مدنية جديدة تُدعى “شركة احتياطي المعادن”، يقودها صناعيون كُلفت بالبحث عن هذه الموارد في أي مكان بالعالم، وبأي تكلفة.
وعلى الصعيد الداخلي، سارعت الحكومة الأميركية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى توسيع عمليات التعدين والتكرير، وابتكار بدائل صناعية، وتمويل أبحاث لتحسين إنتاجية المناجم.
ورغم أن الولايات المتحدة نجحت في النهاية في حسم الحرب لصالحها، فإن غياب الجاهزية المبكرة كلفها إنفاقاً طارئاً ضخماً وتأخيرات خطيرة في إنتاج الدبابات والطائرات والذخائر، واضطرت للاعتماد على مصادر خارجية محفوفة بالمخاطر، وشحن الإمدادات عبر طرق بحرية معرضة للهجوم.
وخلال الحرب الكورية، أرسل الرئيس هاري ترومان مهندسين أميركيين لتطوير منجم التنجستن في سانجدونج بكوريا الجنوبية، وتعهد بشراء إنتاجه بالكامل لتخزينه ضمن احتياطي استراتيجي.
وفي خمسينيات القرن الماضي، وسعت واشنطن مخزونها الدفاعي من المعادن الحيوية، كما موّلت مشاريع تعدين في إفريقيا وأميركا الجنوبية. وبحلول عام 1960، كان لدى الولايات المتحدة كميات ضخمة مخزنة، بل إن إدارات لاحقة بدأت تبيع الفائض لتحقيق أرباح.
لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تلاشى الإحساس الأميركي بضرورة تلك المخزونات، وسمح الكونجرس ببيعها تدريجياً، حتى انخفضت قيمتها من 42 مليار دولار (بقيمة اليوم) عام 1952 إلى 888 مليون دولار فقط العام الماضي.
اعتقد صناع القرار حينها أن الأسواق المفتوحة وسلاسل التوريد التجارية قادرة على تلبية احتياجات الصناعات الأميركية دون الحاجة إلى المخزون الحكومي المكلف. لكن صعود الصين كمورد مهيمن نسف تلك الافتراضات.
متى بنت الصين إمبراطوريتها المعدنية؟
لم تأتِ هيمنة الصين على سوق العناصر النادرة صدفة، بل كانت ثمرة رؤية استراتيجية وتحوّلات تاريخية مدروسة. ففي عام 1987، أطلق الزعيم الصيني دنج شياو بينج عبارة شهيرة تختصر طموح بكين طويل الأمد: “الشرق الأوسط يملك النفط، والصين تملك العناصر النادرة”، في إشارة مبكرة إلى أن هذه المعادن قد تكون كنز الصين الاستراتيجي الموازي للنفط في النفوذ العالمي.
ومنذ ذلك الحين، تتحرك الصين بخطى محسوبة، جذبت شركات غربية لنقل تقنيات المعالجة إلى أراضيها، وقدّمت بيئة منخفضة التكاليف، وتنظيماً بيئياً متساهلاً، ودعماً حكومياً سخياً. ومع مرور الوقت، لم تكتف بكين باللحاق بركب المنافسة، بل سحقته، لتبني قاعدة صناعية تُمكّنها اليوم من التحكم في شرايين صناعات التكنولوجيا والدفاع حول العالم.
ويروي بيني ألثاوس، الرئيس التنفيذي لشركة “USA Rare Earth”أن واشنطن سمحت عملياً للصين بالاستحواذ الكامل على هذا القطاع لأن “التعدين والتكرير يُعتبران عملاً صعباً وملوثاً، فجرى تركه للصين لتوفره بثمن بخس”.
مثال ذلك منجم “ماونتن باس” في كاليفورنيا، الذي كان أكبر منجم للعناصر النادرة في العالم، وأغلق عام 2002 بسبب عدم قدرته على منافسة الإنتاج الصيني الأرخص وتكاليف التنظيف البيئي. وحين حاولت مجموعة خاصة إحيائه في 2010، انهارت في مواجهة الهيمنة الصينية، وعادت خاماته لتُرسل إلى الصين للمعالجة.
لكن الصين لم تكتف بالعناصر النادرة، فقد توسعت شركاتها المدعومة حكومياً خلال العقدين الماضيين لتأمين الكوبالت والليثيوم والنحاس والنيكل من إفريقيا وأميركا الجنوبية. ومن خلال مبادرة “الحزام والطريق”، استثمرت في مناجم الكونغو (للكوبالت)، وتشيلي والأرجنتين (لليثيوم).
تحالف البيئة والقبائل الأصلية.. عقبة أميركية
وتعزو البروفيسور جوني تيوفل دراير، أستاذة العلوم السياسية بجامعة ميامي وعضو معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، الاعتماد الأميركي المتنامي على الصين في مجال المعادن النادرة على مدى العقود الماضية إلى عاملين: انخفاض التكاليف في الصين، والقيود البيئية الصارمة داخل الولايات المتحدة”.
وأشارت إلى أن شركات صينية مثل Shenghe تمكنت من إنتاج هذه المعادن بتكلفة أقل بكثير من نظيراتها الأميركية، بينما تتطلب عمليات التعدين والتكرير في الولايات المتحدة تقنيات عالية التكلفة بسبب آثارها البيئية الكبيرة.
وتضيف في حديثها لـ”الشرق” أن “الكثير من رواسب المعادن الأرضية النادرة تقع على أراضٍ تابعة للقبائل الأصلية، والتي تعتبر بعضها أراضي مقدسة، وقد شكلت هذه القبائل تحالفاً قوياً مع مجموعات بيئية يمنع محاولات الاستثمار في تلك الأراضي، سواء في مرحلة الشراء أو مرحلة المعالجة”.
سلاح البنتاجون يمر عبر الصين
وأثارت التداعيات الأمنية لهذا الاعتماد المتزايد قلقاً متصاعداً لدى المسؤولين الأميركيين والخبراء في مجال الأمن القومي. فعلى عكس الحرب الباردة الأصلية – حيث كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يحتفظان بقاعدتين صناعيتين منفصلتين إلى حد كبير – تجد واشنطن اليوم نفسها متشابكة مع منافسها الجيوسياسي الأول فيما يتعلق بالإمدادات الحيوية.
وتعتمد أنظمة الأسلحة المتقدمة والاتصالات التابعة للبنتاجون على مجموعة من العناصر النادرة التي تسيطر عليها الصين. فعلى سبيل المثال، تُعد مغناطيسات النيوديميوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة أساسية لمحركات الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وأنظمة التوجيه في الصواريخ الموجهة بدقة، بينما يُستخدم زرنيخ الجاليوم في أجهزة الرادار المتطورة وأنظمة الحرب الإلكترونية. أما الأنتيمون، وهو معدن أقل شهرة، فيُعد ضرورياً في تصنيع ذخائر معينة وقذائف خارقة للدروع.
وبحسب تحليل دفاعي حديث، فإن أكثر من 80.000 قطعة مختلفة تُستخدم في حوالي 1900 نظام أسلحة أميركي – أي نحو 78% من جميع المنصات التابعة لوزارة الدفاع – تحتوي على عنصر واحد على الأقل من خمسة معادن حيوية (الأنتيمون، الجاليوم، الجرمانيوم، التنجستن، التيلوريوم)، أصبحت إمداداتها في الغالب تحت السيطرة الصينية.
وخلص التقرير إلى أن “عنق الزجاجة لا يكمن في التعدين، بل في التكرير”، مشيراً إلى أن 88% من سلاسل توريد المعادن الحيوية للبنتاجون معرضة بشكل أو بآخر للتأثير الصيني.
فعلى سبيل المثال، تمر جميع كميات الأنتيمون المستخدمة في الذخائر الأميركية تقريباً عبر الصين في مرحلة ما من مراحل المعالجة، ولا يمكن الوصول إلا إلى حوالي 19% من إمدادات الولايات المتحدة من هذا المعدن من دون وسطاء صينيين.
وفي تحليلها المنشور مؤخراً في مجلة Foreign Affairs، أشارت هايدي كريبو-ريديكر، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى أن المخزون، واعتباراً من أوائل عام 2023، لم يكن يحتوي سوى على 1.3 مليار دولار من الأصول، منها 912 مليون دولار فقط على شكل معادن مخزنة- وهي كمية لا تكفي لتغطية نصف احتياجات وزارة الدفاع، ولا تمثل سوى عُشر ما هو مطلوب لضمان أمن البنية التحتية الحيوية المدنية.
احتياجات الدفاع الأميركي.. عجز استراتيجي
وأوضحت كريبو-ريديكر والتي تعمل كبيرة الباحثين في مركز جرينبرج للدراسات الجيو-اقتصادية بمجلس العلاقات الخارجية أن العجز الإجمالي في التمويل يبلغ 13.5 مليار دولار، داعية الكونجرس إلى تخصيص هذا المبلغ بالكامل بشكل عاجل لسد الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات الدفاع والقطاعات الصناعية المدنية، مع إعطاء الأولوية لتخزين المعادن الأكثر عرضة لأن تستخدمها الصين كسلاح اقتصادي.
ويُشكل هذا الاعتماد الأميركي على بكين خطراً استراتيجياً -بحسب تقارير أميركية- ففي حال نشوب أزمة أو صراع – كاحتمال مواجهة حول تايوان- يمكن للسلطات الصينية أن تفرض قيوداً أو حظراً على تصدير المعادن الحيوية، مما يُعطّل الإنتاج الدفاعي الأميركي.
وأظهرت بكين بالفعل استعدادها لاستخدام قوتها في سوق المعادن كسلاح جيوسياسي، ففي عام 2010، قطعت الصين فجأة صادرات العناصر النادرة إلى اليابان خلال نزاع إقليمي، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وذعر في سلاسل التوريد، قبل أن تعيد فتح الصادرات تحت ضغط دولي.
وفي ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بدأت بكين في استهداف أميركا وحلفائها من خلال قيود انتقائية على المعادن.
ففي منتصف عام 2023، فرضت الصين قيوداً على تصدير الجرمانيوم والجاليوم – وهما عنصران أساسيان في رقائق أشباه الموصلات – فيما بدا أنه رد على العقوبات الأميركية ضد قطاع الرقائق.
طلقة تحذيرية
وفي أواخر عام 2024، فرضت الصين متطلبات ترخيص أوسع لتصدير العناصر النادرة والمعادن ذات الصلة، وهو ما رأى المحللون أنه بمثابة “طلقة تحذير” تُظهر أن الصين قادرة على تشديد سلاسل التوريد في أي وقت.
ونقل موقع Defense one الأميركي المتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي عن المحلل الدفاعي دان دارلينج، أن “الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين ليست حظراً مباشراً، لكن متطلبات الترخيص هذه ستُدخل حالة من عدم اليقين بلا شك، وتُقيد التدفق المنتظم للمكونات الحيوية”، مشبّهاً ذلك بخنق الصين لصادرات العناصر النادرة في 2010، ما “سلّط الضوء على إمكانية تحويل موارد سلاسل التوريد إلى أدوات سياسية”.
وإلى جانب التهديد المباشر للأمن القومي، هناك أيضاً ثغرة اقتصادية وتكنولوجية. فالمعادن الحيوية ضرورية لقطاعات النمو السريع مثل السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات. وإذا قررت الصين إعطاء الأولوية لصناعاتها المحلية – كأن تحتكر الليثيوم لصانعي البطاريات المحليين أو العناصر النادرة لمصانع السيارات الكهربائية الصينية – فقد تُواجه الشركات الأميركية نقصاً حاداً أو صدمة في الأسعار.
جهود أميركية لمواجهة الهيمنة الصينية
في مواجهة هذه التهديدات، بدأ قادة الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة باتخاذ خطوات لإعادة بناء مرونة سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الحيوية. واعتبرت كل من إدارتي ترمب وبايدن هذه القضية أولوية وطنية، وإن كان ذلك بنهج ووتيرة مختلفين.
إدراكاً منه لضعف واشنطن أمام الصين، وقّع ترمب خلال ولايته الأولى سلسلة من الأوامر التنفيذية لضمان مرونة أكبر في استكشاف التعدين واستخراجه وتكريره وإنتاجه وإعادة تدويره. فيما أطلق الرئيس السابق جو بايدن لاحقاً تقييماً حكومياً شاملاً لمرونة سلسلة التوريد خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، واستثمر المزيد من التمويل الحكومي في سلسلة توريد المعادن الحيوية مع توفر أموال جديدة.
واستخدم معظم هذا الاستثمار برامج المنح أو القروض التابعة لوزارة الطاقة وقانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950. يسمح هذا القانون للرئيس بمنح الشركات المحلية والكندية، ومؤخراً الأسترالية، منحاً وقروضاً وضمانات قروض، والتزامات شراء لإعادة فتح المناجم القديمة أو تطوير مناجم جديدة، وبناء مرافق تكرير وإعادة تدوير جديدة، ودعم إنتاج البطاريات.
وعن جهود الولايات المتحدة لمواجهة استخدام الصين لهذه المعادن كسلاح جيوسياسي، قال البروفيسور جوني تيوفل دراير، إن “العمل على ذلك بدأ منذ أكثر من عقد، لا سيما خلال ولاية ترمب الأولى، عندما خصصت الحكومة تمويلاً لدعم مشاريع الاستكشاف محلياً”. وأشارت إلى أن إدارة بايدن استمرت على النهج ذاته، مع توسع الدعم ليشمل شراكات دولية.
ومن أبرز الخطوات التي ذكرتها، دعم الحكومة الأميركية لشركة Lynas الأسترالية – والتي تُعالج حالياً المعادن الأسترالية في ماليزيا – لإنشاء منشأة تكرير في ولاية تكساس الأميركية، رغم بعض الصعوبات التشغيلية التي يواجهها المشروع.
كما لفتت إلى أن الحكومة مولت أبحاثاً في جامعة بولاية فيرجينيا الغربية لاستخلاص المعادن الأرضية النادرة من مخلفات الفحم، والتي تتوفر بكميات كبيرة في الولاية. ورغم أن النتائج واعدة من الناحية التقنية، إلّا أن ارتفاع التكلفة يجعل هذه المشاريع غير مجدية اقتصادياً حتى الآن، وهو التحدي ذاته الذي واجهته اليابان في محاولاتها لاستخراج المعادن من قاع البحر قرب جزيرة مينامي-توريشيما.
الاستقلال المعدني… حلم أميركي
وبالتزامن، بدأ البنتاجون في دعم مشاريع واعدة، مثل مقترحات لبناء مصانع فصل للعناصر النادرة الثقيلة، لتقليل الاعتماد على المصافي الصينية. وفي عامه الأخير من ولايته الأولى، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية في سلسلة توريد المعادن، ووجّه الوكالات الحكومية لتشجيع التعدين المحلي. كما سمح لوزارة الطاقة باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتمويل مشاريع المعادن، ودرس فرض رسوم جمركية (بموجب المادة 232) على الواردات المعدنية لحماية الصناعة الأميركية.
وقال ترمب آنذاك: “سننهي اعتماد أميركا على قوى أجنبية معادية في تأمين المعادن الحيوية”، وهي سياسة انعكست في عدة توجيهات لتسريع الموافقات التعدينية على الأراضي الفيدرالية. وبنهاية 2020، كان قد تم تمهيد الطريق لإطلاق مشاريع أميركية جديدة، رغم أن معظمها لم يكن قد خفف بعد من الاعتماد على الصين.
في ولايته الثانية، وقّع الرئيس دونالد ترمب عدة أوامر تنفيذية تهدف إلى إنشاء استراتيجية أكثر مركزية للمعادن الحيوية، تحت إشراف المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة. وتشمل هذه الأوامر تسريع إصدار التصاريح لمشاريع التعدين والتكرير الجديدة، وفتح الأراضي الفيدرالية أمام أنشطة التعدين، وتوسيع أدوات الاستثمار في السياسات الصناعية.
وقد أقرّ أول هذه الأوامر صراحةً بأن “الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة أصبحا الآن مهددين بشدة” بسبب “الاعتماد على إنتاج المعادن لدى قوى أجنبية معادية”. كما سعى ترمب أيضًا إلى تأمين رواسب خارجية من المعادن الحيوية، مستهدفًا دولًا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجرينلاند وأوكرانيا.
ورغم قناعتها بأن تحركات الإدارة الأميركية لمجابهة الصين في قطاع المعادن النادرة لا يزال بطيئاً، إلا أن البروفيسور جوني تيوفل دراير ترى تقدما حقيقيا. وتضيف “البعض يرى أن اعتماد الولايات المتحدة على الصين بدأ بالتراجع، لكنه لن يختفي بالكامل في المستقبل القريب”. وأشارت إلى أن البحث عن بدائل للمعادن الأرضية النادرة بات جزءًا من الاستراتيجية الأميركية لتقليل التبعية.
واختتمت بالقول “التحرك الأميركي قائم، لكن إنشاء سلسلة إمداد مستقلة بالكامل عن الصين لا يزال هدفًا بعيد المدى يتطلب استثمارات مستدامة ورؤية صناعية طويلة الأجل”.