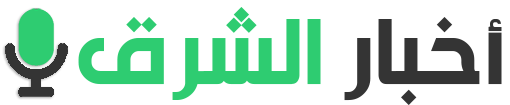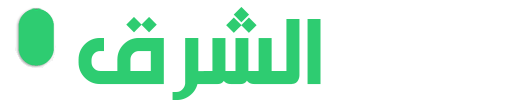الزمن الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي من خلال الوثائقيات

حين ظهرت السينما أواخر القرن التاسع عشر، كان الاحتلال الفرنسي قد أحكم قبضته تماماً على الفضاء الجزائري، وفرض عليه لغته وسياسته وقوانينه، التي كانت تصنّف الجزائريين مواطنين من الدرجة الثانية.
وحتى يظهر الأثر الفرنسي على المكان الجزائري إيجابياً، وقائماً على التنوير والتعمير، لا الطمس والتدمير، فقد سخّرت الإدارة الفرنسية الفن الوليد، في شقه الوثائقي، لإبراز هذا الأثر وتسويقه.
ولم تجد لهذا الدور أفضل من الأخوين أوغست ولويس لوميير، اللذين دخلا مدينة الجزائر، بعد سبعة عقود من الاحتلال، وأنجزا أفلاماً وثائقية قصيرة، ركزت على الملامح المعمارية للمدينة التي بدأت تكتمل.
كان الهدف من ذلك نسفاً صفتي التوحش والتخريب اللتين ارتبطتا بالوجود الفرنسي في الجزائر، والتركيز على مظاهر التعايش بين الجزائريين والفرنسيين، لدحض الأخبار عن وجود مقاومات شعبية، وخصوصاً بعد نفي “عرّاب المقاومة”، الأمير عبد القادر إلى دمشق، وموته هناك عام 1882.
وتكريساً لهذا المسعى، كلّف الأخوان لوميير مصوّراً لهما من يهود تونس، هو فيليكس مسغيش، بتصوير مزيد من الأفلام الوثائقية في المناطق الجزائرية، فكانت أفلامه صامتة، لأنه ترك للصورة مهمة إبراز التفاوت الحضاري بين الفرنسي والجزائري، وكذلك فعل آخرون، مع عناوين ساخرة، من قبيل “المسلم المضحك”، و”علي يشرب الزيت”.
ثورة الصورة
اندلعت ثورة التحرير في نوفمبر عام 1954، وتحرّكت الآلة الإعلامية والسينمائية الفرنسية لتشويهها والتشويش عليها، وإدراجها كحركة إرهابية، فكان على “جبهة التحرير الوطني”، أن تباشر مسعى مضاداً، فكلّفت نخبة من السينمائيين الشباب، منهم محمد الأخضر حمينة الذي سيحصل لاحقاً، على السعفة الذهبية في مهرجان “كان”، وعلى الجائزة الكبرى في مهرجان موسكو، عن فيلمه “وقائع سنين الجمر”.
استدعت هذه النخبة الجزائرية الشبابية الثورية، مخرجاً فرنسياً كان قد أخرج بالموازاة مع انطلاق ثورة التحرير فيلماً وثائقياً سماه “الجزائر أمة”، نسف من خلاله السردية الفرنسية التي تقول إن الكينونة الجزائرية بدأت مع الدخول الفرنسي عام 1830، بما عرّضه للسجن والمطاردة، فالتحق بصفوف الثوّار الجزائريين عن طريق تونس.
سخّر رينييه فوتييه (1928) كاميرته لتوثيق يوميات الثوّار في الجبال، بما فيها بعض المعارك المسلّحة، وضمّنها عام 1958 لفيلمه “الجزائر تحترق”، من إنتاج ألماني، تفادياً للموانع الفرنسية، فكان نافذة أطلّ من خلالها العالم، على مجازر الفرنسيين في الجزائر، في مقابل تضحيات أبنائها من أجل الحرية والاستقلال.
لاحقاً سيوثّق رائد ما يعرف بالتدخل الاجتماعي للسينما، تجربته الإنسانية والثورية تلك، عام 1972، أي بعد عشر سنوات من الاستقلال الوطني، في فيلم “أن تكون في العشرين في جبال الأوراس”، وتوّج بجائزة النقّاد العالمية، في مهرجان كان شهوراً بعد عرضه الأوّل، وعرضت نسخته المرمّمة عام 2012، ضمن “كلاسيكيات البندقية”.
كاميرا مسخّرة
كانت الحكومات التي جاءت بعد الاستقلال الوطني، إلى غاية نهاية سبعينيات القرن العشرين، خاصة خلال فترة الرئيس هوّاري بومدين، تسمي نفسها حكومات البناء والتشييد، وتستمد شرعيتها من الخطاب الثوري والتحرّري المضاد للإمبريالية الغربية، فكان على الأفلام الوثائقية أن تضع نفسها في خدمة ذلك الخطاب، وهو ما يبرّر طغيان نبرة الدعاية والتوجيه والإرشاد عليها، على حساب القيم الجمالية.
كان معظم المخرجين في تلك الفترة مشاركين في ثورة التحرير، ويحملون صفة “مجاهد”، فلم يكن لديهم تحفّظ على تماهي السينما مع السياسة. نذكر منهم أحمد راشدي (1938)، وسليم رياض (1933)، وغوثي بن ددوش (1936)، وناصر الدين قنيفي (1943)، وسيد علي مازيف (1943).
انفراج سياسي
غير أن تلك النبرة سرعان ما انزاحت لصالح رصد نبض الحياة الشعبية، في تطلعاتها لفن العيش، بعيداً عن الشعارات السياسية التي كان يهيمن عليها الحزب الواحد، بالنظر إلى رحيل الرئيس هواري بومدين ذي الميولات اليسارية، ومجيئ الرئيس الشاذلي بن جديد ذي الميولات اللبيرالية.
أصبح من المسموح أيضاً تناول شخصيات تاريخية، خارج السياق التاريخي الرسمي، وخصوصاً الأمازيغية منها، مثل الملكين يوبا وماسينيسا، مثلما فعل المخرج رابح لعراجي (1943).
بل إن الجزائريين باتوا يشاهدون في التلفزيون الحكومي، أفلاماً وثائقية علمية وبيئية، لا تمارس الوصاية السياسية عليهم، مثلما نجد في الأفلام الأخيرة للمخرج مفتي الطيب (1943).
ورطة التمويل
وبقدر ما أدى تغلغل خطاب اقتصاد السوق، إلى أن تنفّس الجزائريون هواءً غير مؤدلج في الحياة العامة، بقدر ما كان ذلك مقدّمة لتخلي الحكومة عن تمويل الأفلام الوثائقية، لأنها لم تعد محتاجة إليها، بصفتها أداة لتمرير خطابها من خلالها، فأضحت حريتها مرفوقة بالإكراه المالي، في بيئة لم تكتسب بعد ثقافة الرعاية المالية، من طرف الخواص.
تجاوز بعض المخرجين الوثائقيين الجزائريين، هذه الورطة المالية، باستغلال رغبة المنابر التلفزيونية الأوربية، في اكتشاف النسيج الجزائري، في تمظهراته المختلفة، خاصة في الشق المتعلق بالتابوهات الاجتماعية، فأنجزوا لصالحها أفلاماً رصدت بنى جديدة أفرزتها التحوّلات السياسية والاقتصادية، وانتشار ظاهرة التعليم وشروع المرأة للخروج إلى العمل.
فكانت جرعة الحرية التي أنجزت بها تلك الأفلام، أكبر من جرعة الحرية الممنوحة للأفلام الوثائقية التي أنجزت لصالح التلفزيون الحكومي.
“الجزائر.. ذاكرة الراي”
في الوقت الذي كان هذا الأخير يمنع تمرير أغنية “الراي” الشبابية، لأنها أغنية مضادة للقيم الأبوية الاجتماعية والسياسية، كانت القنوات الفرنسبة والبلجيكية تبثّ أفلاماً وثائقية تحتفي بها، وتبرز مفرداتها الجمالية المتحرّرة، بما ساهم في تسويقها عالمياً، ليأتي لاحقاً مخرج مغترب هو جمال خلفاوي، فأحاط بسياقات تشكّلها وانتشارها في فيلمه “الجزائر.. ذاكرة الراي” الذي نال الجائزة الأولى، في مهرجان “مناظر أفريقية” الكندي.
يقول الناقد السبنمائي عبد الكريم قادري لـ “الشرق”: إن تلك الأفلام الوثائقية الراصدة لتعابير الحياة في الجزائر، لم تكن تسعى إلى المساهمة في تعزيز خطاب الانفتاح والتحرر بمفهومه الفكري والفني والاجتماعي فقط، بل كانت أيضاً تسهم في مقاومة خطاب الموت الذي كانت تنشره الجماعات الإرهابية المسلحة، في تسعينات القرن العشرين”.
أضاف: “وبذلك استعاد الفيلم الوثائقي الجزائري روح المقاومة التي خرج من رحمها، في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، حيث رافق الثورة ضد المحتل الفرنسي”.
يلخّص قادري فكرته بالقول: “انتقلت السينما الوثائقية الجزائرية، من مهمة التحرير إلى مهمة التنوير، ما ألزمها أكثر، بالانتصار للجماليات الفنية، والابتعاد عن الخطابات الأيديولوجية المعلّبة، حتى تكون قادرة على استقطاب الجيل الجديد”.
هكذا بقيت السينما الوثائقية في الجزائر، تفتقر إلى إطار تنظيمي يُظهر إنجازاتها وجمالياتها وتراكماتها، ما عدا تظاهرات محتشمة أكثرها كان بلا تأثير.
من هنا، أطلقت “جمعية الزيتونة الثقافية” في محافظة غليزان، التي تبعد 400 كيلومتر من الجزائر العاصمة، عام 2019، بمرافقة وزارة الثقافة والفنون، مهرجاناً دولياً حمل اسم شخصية تاريخية من القرن السادس عشر هو سيدي امحمد بن عودة.
حمل المهرجان على عاتقه منذ بداياته، بالرغم من إكراهات جائحة كورونا، مهمة الاحتفاء بالأفلام الوثائقية التي تتناول موضوعات، تُبرز تنوع الثقافات وتناقش التحديات العالمية، مما يُسهم في تعزيز الحوار الثقافي عبر شاشة السينما. ويعكس ثراءات وبهاءات الهوية الثقافية الجزائرية، ويعزّز قيمة التبادل الثقافي والفني، من خلال الأفلام الوثائقية.
يقول محافظ المهرجان عبد الرؤوف بن أحمد، “إن المهرجان يوفّر منصة للتفاعل بين صناع الأفلام والجمهور، ما يُسهم في بناء مجتمع فني وثقافي واعٍ، من خلال جمع صناع أفلام عالميين مع جمهور شغوف، في فضاء يتيح التبادل الثقافي والإبداعي”.
ويختم بأن “السينما الوثائقية في الجزائر انبثقت من ثنائية النضال والجمال؛ بالتالي فهي مرآتنا التي يمكن أن نرى فيها الزمن الجزائري بأبعاده الثلاثة”.