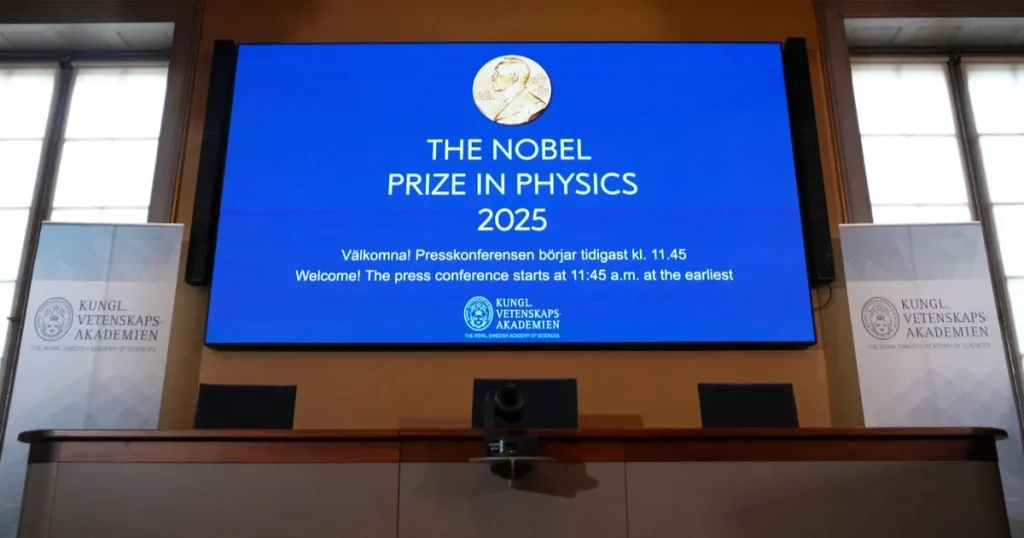توّجت جائزة نوبل للفيزياء 2025، مساراً علمياً بارزاً لكل من الأميركي جون مارتينيس، والبريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل ديفوري، تقديراً اكتشافهم ظاهرة “النفق الكمي الماكروسكوبي وتكميم الطاقة في الدوائر الكهربائية” قبل 4 عقود، وهي ظاهرة فتحت الطريق أمام تطوير الحوسبة الكمية الحديثة، التي تعتبر الثورة المقبلة في عالم التكنولوجيا.
استطاع العلماء الثلاثة، من خلال سلسلة تجارب دقيقة، أن يبرهنوا أن “ميكانيكا الكم”، التي طالما ظلّت حبيسة عالم الذرات والجسيمات الدقيقة، يمكن أن تتجسد بوضوح في أنظمة أكبر وتُظهر سلوكاً كمياً على نطاق مرئي للإنسان.
وميكانيكا الكم، التي وُلدت في بدايات القرن العشرين على أيدي ماكس بلانك، وألبرت أينشتاين، وفيرنر هايزنبرج، وإرفين شرودنجر، تصف سلوك الجسيمات على المستويات الدقيقة (الإلكترونات والفوتونات والذرات)، وهي مرحلة تصبح فيها الطاقة والزمان والمكان أنفسهم محكومين بالاحتمالات لا باليقين.
وأحد أغرب هذه الظواهر هو “النفق الكمي”، حيث يتمكن جسيم من عبور حاجز طاقة يبدو من المستحيل تجاوزه وفق القوانين الكلاسيكية. ويشبه الأمر كرة ترتطم بحائط صلب، لكنها بدلاً من أن ترتد، تختفي من جهة وتظهر في الجهة الأخرى. هذه الصورة الرمزية لطالما كانت حكراً على الجسيمات المفردة، ولا يُمكن رؤيتها في الأجسام الكبيرة.
“النفق الكمي”
كان الفيزيائي الروسي الأصل، جورج جاموف، أول من استخدم ظاهرة “النفق الكمي” في عام 1928، لتفسير اضمحلال بعض الأنوية الذرية الثقيلة.
وافترض جاموف، أن الجسيمات داخل النواة، يمكنها بين الحين والآخر أن “تتسرب” عبر الحاجز النووي وتخرج منه، مفسراً بذلك نوعاً من التحلل الإشعاعي يُعرف بـ”التحلل ألفا”، والذي يحدث في أنوية الذرات الثقيلة غير المستقرة.
كانت تلك لحظة تاريخية فتحت الباب أمام فهم جديد للعمليات النووية والاحتمالات في الطبيعة. لكن مع ذلك، بقيت ظاهرة النفق محصورة في العالم المجهري، عالم لا يمكن رؤيته ولا لمسه.
لكن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تحدى العلماء الثلاثة كلارك وديفوريت ومارتينيس، هذا التصور تماماً، وفي مختبراتهم بجامعة بيركلي-كاليفورنيا، بنوا نظاماً كهربائياً بالغ الحساسية يتكون من موصلين فائقين تفصل بينهما طبقة عازلة رقيقة جداً.
هذا التركيب يُعرف باسم “وصلة جوزيفسون”، وهي مكون أساسي في فيزياء التوصيل الفائق، وسُميت على اسم الفيزيائي البريطاني، بريان جوزيفسون، الحاصل على نوبل في الفيزياء في عام 1973.
و”وصلة جوزيفون” أو “تأثير جوزيفون”، هي دائرة كهربائية تتكون من مادتين فائقتي التوصيل يفصل بينهما حاجز رقيق من مادة عازلة، يسمح بمرور تيار كمّي عبر ظاهرة “النفاق الكمّي”، والتي تجعل التيار الكهربائي يمر دون أي مقاومة.
وعندما يتشكل هذا النوع من الوصلات، يتصرف التيار داخلها على نحو جماعي مدهش. ففي المواد فائقة التوصيل، لا تتحرك الإلكترونات كجسيمات منفردة، بل تتزاوج لتكوّن “أزواج كوبر”، التي يرتبط فيها إلكترونان ببعضهما، رغم أن الإلكترونات تتنافر عادة لأنها تحمل الشحنة نفسها (سالبة).
ولكن هذه الأزواج تفقد فرديتها وتبدأ في التحرك بانسجام تام كما لو كانت جسيماً واحداً.
هذا الانسجام هو الذي يجعل الظواهر الكمومية قابلة للظهور على مستوى أكبر من الجسيمات الفردية.
“العبور” عبر الحاجز الطاقي
في النظام الذي بناه كلارك وديفوري ومارتينيس، تصرّفت “أزواج كوبر” ككيان واحد، جسيم عملاق واحد، يمكنه أن يختبر ظواهر كمومية مثل “النفق الكمي” و”تكميم الطاقة”، أي انقسام الطاقة إلى مستويات منفصلة محددة لا يمكن تجاوزها.
وفي بداية التجربة، كان الجهد الكهربائي عبر الوصلة صفراً، أي أن التيار يجري في حالة مستقرة بلا مقاومة. لكن فجأة، ظهر جهد صغير، وكأن النظام “قفز” من حالة إلى أخرى، كما لو أن مفتاح السيارة انتقل من وضع الإيقاف إلى التشغيل رغم وجود حاجز يمنع ذلك.
هذا الانتقال لم يكن نتيجة قوة خارجية، بل كان بفعل “النفق الكمي” نفسه، حيث تمكن النظام من “العبور” عبر الحاجز الطاقي بفضل احتمالات الكم.
ما فعله العلماء الثلاثة هو أنهم جعلوا هذا السلوك الغريب يحدث في نظام يحتوي على عدد لا يُحصى من الإلكترونات، لا في إلكترون واحد أو ذرة واحدة، وبهذه الطريقة أثبتوا أن قوانين ميكانيكا الكم لا تقتصر على العوالم الميكروسكوبية، بل يمكن أن تنطبق على أنظمة مرئية بالعين المجردة تقريباً.
ولتحقيق ذلك، احتاجوا إلى دقة متناهية في العزل عن أي تداخل خارجي، إذ يمكن لأدنى اضطراب حراري أو إشعاعي أن يفسد التجربة. كانوا بحاجة إلى التحكم الكامل في كل ذرة وكل إلكترون في النظام.
واستخدم الفريق أدوات وتقنيات استغرق تطويرها عقوداً، فمنذ اكتشاف التوصيل الفائق في بدايات القرن العشرين، ظل الفيزيائيون يسعون لفهم خصائص هذه الحالة الغريبة من المادة، التي يمكن فيها للتيار أن يجري بلا مقاومة.
وبعد اكتشاف “وصلة جوزفسون”، أصبح بالإمكان استغلال هذه الخاصية لقياس الظواهر الدقيقة بدقة لا مثيل لها، من الثوابت الفيزيائية الأساسية إلى الحقول المغناطيسية الضعيفة للغاية. لكن ما فعله فريق بركلي تجاوز القياسات إلى اختبار أساسيات الطبيعة نفسها.
وعليه تمكن العلماء الثلاثة من بناء دائرة كهربائية فائقة الحساسية، معزولة تماماً عن أي تداخل أو ضجيج خارجي. ولأن ميكانيكا الكم تتعامل مع احتمالات، فإن التجربة كانت تحتاج إلى تكرار دقيق مرات عديدة.
وضخ الباحثون تياراً ضعيفاً في الوصلة مراراً وتكراراً، ثم راقبوا الجهد الناتج بدقة. في البداية لم يُسجَّل أي جهد، لكن بعد فترة زمنية محددة، ظهر فجأة جهد صغير. ولأن هذه القفزات تحدث عشوائياً وفقاً للاحتمالات الكمومية، فقد جمعوا مئات القياسات ورسموا منها منحنيات تُظهر المدة الزمنية التي يبقى فيها النظام في حالته الصفرية، قبل أن ينفذ منها إلى الحالة الأخرى.
نتائج مدهشة
بهذه الطريقة، أثبت الباحثون الحائزون على جائزة نوبل 2025، أن ما يحدث يشبه تماماً ما يحدث في تحلل الأنوية الذرية، ولكن على نطاق أكبر بكثير.
كانت النتيجة مدهشة، ظاهرة كانت تُعد حكراً على الجسيمات المفردة، يمكن أن تُرى الآن في نظام مصنوع بشرياً يمكن وضعه على طاولة المختبر.
وتمكن كلارك وديفوري ومارتينيس، في أبحاثهم، من مد جسور بين العالمين المجهري والمرئي، وأظهروا أن الطبيعة بكل غرابتها، لا تفرّق بين صغير وكبير حين يتعلق الأمر بقوانينها الأساسية.
وانتقل الباحثون من التجربة التي أظهرت النفق الكمي في النظام الكبير، إلى اختبار آخر ضروري لإثبات أصالة الظاهرة وهي “تكميم الطاقة في النظام”.
ففي ميكانيكا الكم، لا يمكن لأي نظام أن يمتص أو يصدر أي مقدار من الطاقة عشوائياً، بل فقط في حالات محددة مسبقاً. لذلك أدخلوا داخل النظام إشعاعات ميكروويف بموجات مختلفة، ولاحظوا أن أي منها يُمتص في الحالة الصفرية، فيرفع الطاقة إلى المستوى التالي.
فإذا أُعطي النظام طاقة أكثر، فإن الوقت الذي يظل فيه في الحالة بدون جهد يقل، وهو أمر متوقع من نظرية الكم نفسها. وهكذا رصدوا أن النظام ليس مجرد جهاز عادي، بل يتمتع بخاصية كمومية واضحة، يمتص أو يصدر طاقة في مقادير محددة فقط، لا أكثر ولا أقل.
مفاهيم جديدة
وتمكن كلارك وديفوري ومارتينيس، من برهنة أن النظام يتصرف كما لو أنه “ذرة صناعية”، كيان كبير متماسك، لكنه يملك طيفاً خاصاً من الطاقة، ويتجاهل الفروقات بين الجسيمات المكونة له، ويعمل كوحدة موحدة.
في تلك اللحظة يتضاءل الفارق بين العوالم المجهريّة والمرئيّة، ويظهر أننا نستطيع أن نُجسّد نظريات الكم في أشياء نلمسها ونراها.
من الناحية النظرية، كانت هذه النتيجة مدهشة على أكثر من مستوى، أولاً، لأنها تجاوزت الخط الفاصل التقليدي بين “الميكروسكوب” و”الماكروسكوب”، فالعالم الكمي كان يُفهم على أنه مجال الجسيمات الدقيقة يُخفى أمام التجربة اليومية بسبب التداخلات البيئية والتأثيرات الكلاسيكية التي تلغي الخصائص الكمومية كلما زاد الحجم.
لكن هنا، في هذه التجربة، أراد العلماء أن يُبقوا الظروف مثالية قدر الإمكان، مثل العزل الحراري، وتقليل التشويش الكهربائي، والتحكم في كل التأثيرات المضادة حتى لا تُمحى ظواهر الكم من الجهاز.
ولأن عدد “أزواج كوبر” في الجهاز هو عدد ضخم جداً، فإن التجربة تجمع بين الطابع الجماعي والتصرف الكمومي الموحد، ما يثبت أن الميكانيكا الكمومية ليست محصورة بالجسيمات الفردية فقط، بل يمكن أن تُطبَّق على أنظمة كبيرة بأنسجام تام.
أما الأمر الثاني فهو أن هذه النتيجة فتحت الباب أمام مفاهيم جديدة في الفيزياء التطبيقية، إذ أصبح من الممكن تصور دوائر كمومية قوية ومستقرة تعمل كوحدات معالجة (qubit) في “الحوسبة الكمومية”، أو أجهزة استشعار فائقة الحساسية تتجاوز قدرات الأجهزة التقليدية.
المبدأ الذي أثبتوه، أن النظام يمكنه “القفز” بين مستويات طاقية محددة، ومن ثم الانبعاث أو الامتصاص، وهو نفس المبدأ الذي تُبنى عليه البتّات الكمومية (bits) في المعالجات المستقبلية.