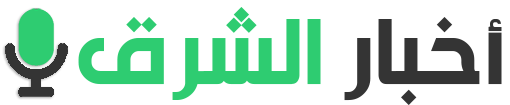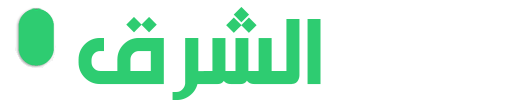“بيوت القاهرة”.. طبقات من التاريخ وحكايات الحجر

من أجل كتابة التاريخ، يختار البعض سِير الحكّام والسلاطين، ويذهب البعض لروايته بألسن الناس، وآخرون يستنطقون الحجر، ويجدون العمارة دليلاً صادقاً على الرواية.
في كتاب “بيوت القاهرة ترحال في حكايا الحجر”، الصادر عن دار المعارف بالتعاون مع مبادرة “سيرة القاهرة”، ترصد الباحثة ياسمين عبدالله تاريخ العاصمة المصرية، من خلال بيوتها التاريخية المنتشرة في الحواري والأزقّة القديمة.
تقف القاهرة فوق طبقات تاريخية متعددة، لذلك قدّم الكتاب توضيحاً لبداية ظهور العاصمة التي أنشأها القائد جوهر الصقلي، لتكون مركزاً لحكم الفاطميين، ومقراً لإقامة الحاكم المعز لدين الله الفاطمي.
فمع بداية الفتح الإسلامي، انتقلت عاصمة مصر من الإسكندرية إلى الفسطاط، المكان الأول الذي نزل فيه القائد عمرو بن العاص. وبمرور الوقت، نشأت مدينة العسكر، وبعدها القطائع العاصمة التي أنشأها أحمد بن طولون، على غرار سامراء العراقية.
حريق الفسطاط
كانت بيوت الفسطاط قريبة للبيوت الشامية والبغدادية، يصل علوّها إلى خمسة أدوار، لكن معالمها اندثرت بعد الحريق الذي اندلع فيها، وأدى إلى اتجاه سكانها لبناء بيوتهم خارج أسوار القاهرة، عاصمة الفاطميين، الذين جعلوها مدينة مغلقة خاصة بعلية القوم، يفصلهم عما حولهم أسوار عددها تسعة.
يذكر الكتاب أن جوهر الصقلي خطّط المدينة بحيث تقع قصور الخلافة في مركزها، فبنى قصر الخلافة الشرقي الكبير، ليسكن فيه الخليفة الفاطمي المُعز لدين الله، ثم القصر الغربي؛ وبهذا يكون القصران داراً للخلافة، وبينهما العديد من السراديب والممرات السرية، التي يُقال إنها واسعة لدرجة أن الخليفة كان يمشي فيها بفرسه، من دون أن يضطر للظهور علناً، وقد تحوّلت تلك السراديب لاحقاً إلى ممرّات للصرف الصحي.
يضمّ القصر الكبير 12 قصراً أهمها قصر الذهب، وفيه سرير المُلك، وهو العرش الذي يجلس عليه الخليفة، لكن هذه القصور تعرّضت للدمار، ولم يتبق منها غير بعض الآثار في متحف الفن الإسلامي.
أسوار القاهرة
لم يسمح الفاطميون للعامة بالحياة داخل أسوار القاهرة، التي كانت مدينة الصفوة، لكن بانتهاء حكمهم ودخول الأيوبيين مصر، تم السماح لهم بالبناء داخل أسوار القاهرة.
وتشير الباحثة ياسمين عبدالله، إلى أن الأيوبيين لم يقدّموا إرثاً عمرانياً في القاهرة، كالذي تركه الفاطميون، بسبب انشغالهم بالحروب الصليبية، وكل ما تبقى من العمارة الأيوبية، هي القلعة وبعض المدارس والقباب الضريحية، لكن قرارهم السماح بالبناء داخل أسوار القاهرة غيّر معالمها؛ إذ جرى هدم الكثير من القصور، وتحوّل بعضها لبيوت فخمة، لكن أصغر حجماً، وتشعّبت من شوارعها الأزقّة والحارات، وأشهرها حتى اليوم حارة برجوان.
المماليك.. شغف بالفن والعمارة
يتتبع الكتاب الطبقات التاريخية التي مرّت على القاهرة، ويرى مؤلفها المدينة مثل البيت الكبير الذي يزداد اتساعاً كل يوم، ليضم أطيافاً مختلفة من كل بقاع الأرض؛ فبعد الأيوبيين، حكم مصر المماليك الذين عُرفوا بعشقهم للجمال والفن والعمارة، بقدر حبهم للحروب والمؤامرات.
وحتى اليوم بقيت آثارهم خاصة في منطقة القاهرة الفاطمية، أو ما نُطلق عليه الآن شارع المعز، الذي يضم المدارس والجوامع والحمامات والقباب الضريحية، فضلاً عن بيوت الأمراء وتجارة الذهب والنحاس والخيامية.
ويتضح من خلال ذلك، أن القاهرة لم تعد مدينة الصفوة الحاكمة فحسب، لكنها أصبحت تضم التجار والمتعلمين، والحرفيين والصنّاع، والفقراء ومن لا يملكون قوت اليوم، الذين تمتعوا برعاية سلاطين المماليك، مثل بيبرس البندقداري، الذي أمر بجمع أصحاب العاهات، والمتسوّلين ووضعهم بخان السبيل، قبل أن يأمر بنقلهم إلى الفيوم، وأوقف بلدة كاملة لإعالتهم.
داخل هذه المدينة بدأت تظهر الطبقات الاجتماعية واختلاف سكن كل منها؛ فالبيوت يسكنها التجار والأغنياء والمتعلمين المقربين من السلطان، أما الناس العاديين، فسكنت الأرباع (مفردها ربع)، وهو بناء مستطيل يُشبه العمارات السكنية في عصرنا، ويحتوي على غرف سكنية ضيّقة ومدخل واحد للجميع، وكانت تسكنه الأسر والأفراد، لكن قبل ذلك كان الربع مخصصاً لسكن أصحاب الحِرف، وأحياناً العابرين بالقاهرة كالتجار.
أحد الأشكال المعمارية التي عاش فيها سكان مصر أيضاً، كانت الأحواش، وغالباً ما كانت تقع على أطراف المدن، ويسكنها الفقراء، وهي عبارة عن مساحة مفتوحة حولها صفوف من الحجرات.
التكية للمتصوفين
كذلك ظهرت التكية، وهي المكان الذي ينقطع فيه المتصوّف للعبادة، ولها تخطيط خاص قريب الشبه بتخطيط المدارس والمساجد المملوكية، والوكالات وهي الفنادق قديماً، وكان أغلبها يضم محلات على واجهتها الخارجية، يعرض فيها التجار بضاعتهم التي جاءوا بها من الخارج.
البيوت المملوكية
سكن سلاطين المماليك قلعة صلاح الدين، وبنى أمراؤهم بيوتاً أصبح ما بقي منها نموذجاً للإبداع المعماري، وأشار الكتاب إلى عدد من هذه البيوت التي لا تزال موجودة حتى اليوم، ومنها قصر الأمير بشتاك.
كان بشتاك قبل قدومه إلى مصر بائعاً للخمر، لكنه كان شديد الشبه بأبي سعيد، خان مغول فارس، وكانت المفارقة أن السلطان الناصر كان قد طلب من تاجر الرقيق السلطاني، مجد السلامي، أن يشتري له مملوكاً يُشبه أبا سعيداً، وهكذا جاء مصر، وأعتقه السلطان الناصر، وعندما أراد أن يبني قصراً اشترى المنازل المجاورة للمساحة المخصصة له، وهدم 11 مسجداً و4 معابد، وشيّد قصراً عظيماً، لكن المفارقة أنه شعر بكرهه، وكان صدره ينقبض كلما نزل به.
يقول المؤرخ المقريزي كما ورد في الكتاب: “لم يُبارك له في القصر، ولا تمتع به”. وكان القصر مؤلفاً من 3 طوابق، تتوزع في الطابق الأرضي إسطبلات الخيل ومخازن الغلال وغرف الخدم، وفي الطابق الثاني قاعة احتفالات، أما الثالث فهو طابق الحريم.
قصر الأمير طاز
تبعاً لكتاب “بيوت القاهرة”، فهو القصر الوحيد الباقي وشبه الكامل من قصور أمراء المماليك، وهو قصر مهيب في شارع السيوفية، تمتد جدرانه الحجرية، وتقطعه بعض الدكاكين التي أضيفت إليه لاحقاً، وتقود بوابته الرئيسية إلى فناء مربع ثم رئيسي، يضم مقعد الأمير بسقفه الخشبي، ويلفّه شريط مكتوب عليه الآيات الخمس الأولى من سورة الفتح، كما يضم الفناء إسطبلات الخيل ونافورة دائرية كبيرة، تحوّلت الآن إلى مساحة مزروعة بالنخيل.
بيت الرزاز
عام 1480 قرّر السلطان قايتباي إنشاء دار في المسافة الفاصلة بين القلعة وباب زويلة، ولا تزال جدران الدار تحمل اسم السلطان في شريط يُزين مدخل القاعة المُطلة على الفناء.
عام 1778م، جدّد الأمير أحمد كتخدا الرزاز الدار، وحمل البيت اسمه حتى اليوم. وتجد الكاتبة ياسمين عبدالله أن حكاية بيت الرزاز مثيرة للأمل؛ فالأمير أحمد كان حفيداً لأمير تركي يدعى خليل أغا، استطاع إقناع مُلاك مزارع الأرز، بتخصيص جزء من المحصول كضريبة، وكان السلطان يأخذ نصيباً منها، والجزء الآخر يذهب إلى خليل آغا، الذي سطع نجمه، وأصبح من المُقرّبين، ومُنح مع الأموال دار قايتباي ليؤسس فيها عائلته.
ومع التجديدات التي قام بها الحفيد، أصبح البيت ضخماً يضم فناءين ونحو 195 غرفة، ما بين سلاملك وحرملك وغرف للخدم والخدمات، وإسطبل، وحمامات.
بيت الكريتلية
عام 1540، بنى المعلم عبد القادر الحداد بيتاً على الطراز المملوكي، يتألف من ثلاثة طوابق، بجانب مسجد أحمد بن طولون الشهير، وبمرور الوقت، انتقلت ملكيته لتصل إلى السيدة آمنة بنت سالم.
عام 1631، تمّ بناء بيت آخر بجانبه على الطراز نفسه، على يد الحاجة محمد بن سالم جلمار الجزار، وانتقلت بعدها ملكيته لسيدة من جزيرة جريت تدعى زنوبة، بعدها كان البيتان سيتعرضان للهدم، لولا جهود لجنة الآثار العربية، التي أوقفت الهدم ونزعت ملكيتهما.
عام 1930، عرض ضابط إنجليزي يسمى مراد جاير أندرسون على لجنة الآثار العربية، استئجار البيتين ليسكن بهما، ويضع مقتنياته التي جمعها خلال أسفاره المتعددة، على أن يترك المنزل بالمقتنيات هدية لمصر بعد وفاته.
وبالفعل صدر قرار بتحويل البيتين إلى متحف يحمل اسم جاير أندرسون، أو بيت الكريتلية حتى اليوم.
يؤكد الكتاب أن تفرّد البيوت القاهرية، لا يعود للعناصر المعمارية التي تجعله من الخارج والداخل أشبه بقلعة متناغمة الجمال، وإنما بقدرته على رعاية خصوصية سكانه أيضاً، بداية من المدخل المنكسر الذي يحفظ حرمة الدار، وثقافة المقعد الذي يجلس فيه أهل الدار، والسلاملك لاستقبال الضيوف الرجال، وحتى المساحات المزروعة والحمامات الخاصة.