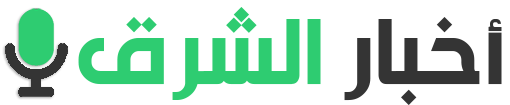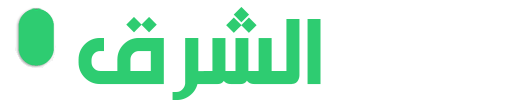“خلف صيدنايا”.. الشعرة بين الإعلام وقصص الرعب!

تحول سجن صيدنايا في سوريا الأسد إلى ما يشبه سجن الباستيل في الثورة الفرنسية: رمزاً للقمع والاستبداد في أسوأ وأبشع صوره.
كما تحول اقتحامه وتحرير سجناءه رمزاً لسقوط النظام المستبد.
تحول الباستيل إلى مادة لكتب التاريخ والحكايات الشعبية والروايات، يتداخل فيها الواقع بالخيال، والتاريخ بالأسطورة، ويبدو أن سجن صيدنايا سيلحق به، ويتجاوزه قريباً.
كبسولة تاريخية
في 57 دقيقة يحيلنا تقرير/فيلم “خلف صيدنايا”، الذي أنتجته وتعرضه قناة “الشرق الوثائقية”، إلى غابة من الأفكار والأسئلة المتشابكة.
من ناحية محتوى ومضمون ما يعرضه الفيلم: كيف يتم اختزال وتكثيف ممارسات نظام مستبد وحشي استمرت على مدار عقدين وأسدين (الأب والابن) في بقعة صغيرة لا تتعدى مئات الأمتار اسمها سجن صيدنايا؟.
ماذا عن السجون الأخرى؟ وعن الجرائم والمذابح التي ارتكبت في أماكن أخرى أو في عرض الطريق تحت وضح السماء؟
لا يستطيع وثائقي واحد، أو حتى مئة، أن يلموا بكل شئ، وعمل الفن أن يختزل موضوعاً، أو عالماً، بأسره، في كبسولة.. بالتأكيد. ولكن إعلامياً، وتاريخياً، من حق أي حدث أن يسجل، ومن حق أي ضحية أن يذكر، ومن الواجب التحقيق في كل جريمة ارتكبت ومحاسبة كل مجرم عن جريمته.. ليس عن طريق الانتقام العشوائي الذي أعقب سقوط الباستيل/ صيدنايا، ولكن من خلال عمليات التوثيق والمحاكمات الدقيقة التي قد تستغرق سنوات وعقود، هذه إحدى الضمانات الأساسية لمنع رأس الاستبداد من الإطلال مجدداً.
مثل قصص الرعب: التاريخ الذي يدفن دون معرفته وفحصه بعناية هو أشبه بالمسخ الذي يدفن دون أن يٌقتل جيداً، سيعود مرة أخرى ليثير الفزع مجدداً.
فوق وتحت الأرض
في بعض مشاهد وثائقي “خلف صيدنايا” يتجمع أهالي الضحايا وفرق الإنقاذ يحملون المعاول وآلات الحفر، وينقبون الأرض الصخرية الصلبة بحثا عن سراديب سرية تحت الأرض يختبئ داخلها سجناء آخرون.
المشهد مؤسٍ على المستوى الإنساني ومؤسف على المستوى السياسي، مؤسٍ قدر البؤس الذي يعاني منه أهالي المفقودين وتشبثهم بأي أمل حتى لو كان بين الصخور، ومؤسف تلك الفوضى التي تؤدي لا محالة إلى طمس وضياع الحقائق وسط ستار الشائعات والأساطير.
ترك الناس نهباً للخيال أمر خطير من قبل المسئولين، واستخدام الخرافة، بشكل لا داع له لإن الواقع أكثر قسوة وعبثية، هو أمر خطير أيضاً، لإنه يقلل من متانة وقيمة الواقع.
كل حكاية تهم
يحتوي “خلف صيدنايا” على عدد من الشخصيات والحكايات، وراء كل شخصية وحكاية مادة تصلح فيلماً: الناشط الشهيد مازن الحمادة، الذي تتجسد في حياته ومقتله كل وحشية نظام الأسد، الناشط أنور البني، الذي كان موظفاً في الدولة لكن لم يفقد إنسانيته واستطاع أن يهرب وأن يناضل على مدار سنوات ضد ما يجرى داخل صيدنايا وخارجه.
السجين الناجي محمد خليل، الشاهد على الحياة اليومية داخل سلخانة صيدنايا. الأهالي القادمون للبحث عن ذويهم المفقودين، بين الحزن المطبق وبصيص الأمل في العثور ولو حتى على جثث ذويهم.
حكايات ينبغي أن توثق وتحقق وتبقى، قبل أن تطوى صفحة الماضية، مخلفة صفحة أخرى أسوأ.
أسطورة السراديب
من بين كل هذه القصص التي يعرضها التقرير الوثائقي على عجل، تبقى حكاية السراديب السرية ذات معان ومغازٍ (جمع مغزى) أكثر من غيرها.
لا شك أن نظام الأسد كان واحداً من أكثر الأنظمة وحشية، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لاثبات وتوثيق هذه الوحشية. ولكن الغريب هو قصص الرعب المتخيلة والإصرار على أن تحت الأرض سراديب وزنازين سرية، رغم أن كل نتائج التنقيب والأدلة العلمية تشير إلى استحالة وجودها، وكأن ما فوق الأرض لا يكفي من دلائل حية على هذه الوحشية.
هذا الميل لما هو “خارق” و”غيبي” أمر خطير للغاية لإنه من ناحية يشير إلى عقلية تخلط بين الإفتراضي والواقعي، وهو أحد النتائج الوخيمة لعصر الصورة الذي قام بتحليله كل من المفكرين الفرنسيين جي ديبور وجان بودريلار خاصة في كتابيهما “مجتمع الفرجة” و”المصطنع والاصطناع”، وعصر ما بعد الصورة الافتراضي الذي نعيش فيه الآن.
ومن ناحية ثانية فإن هذا الاستغراق في الخيالي يتيح لجناة الواقع أن يتملصوا من جرائمهم، وأن يبرؤوا أنفسهم من خلال التشكيك في هذه المبالغات، وقد قرأت بعض “بوستات” أنصار النظام القديم التي تستغل هذه المبالغات بالفعل.
من هنا يأتي دور الإعلام الحقيقي الذي ينبغي عليه أن يكون حائط صد ضد الخلط بين الواقعي والغيبي، والحقيقي والمصطنع. ومن هنا يجب أن يبعد ويميز الإعلامي نفسه عن رواد “السوشيال ميديا” الذين يتغذون على، وينتجون، الخرافات المخلوطة بالواقع.
تصلح قصص السراديب لانجاز أفلام أو قصص رعب، ولكن ليس تقارير إعلامية. ومن الجيد في “خلف صيدنايا” أنه يشير إلى عدم العثور على أية أدلة حول هذه السراديب، وإن كان من ناحية ثانية، يستغل القصة دعائيا لجذب المشاهدين.
بين التقرير والفيلم
هناك إشكالية مماثلة تتعلق بالأرقام: تذكر المؤسسات الحقوقية الدولية أرقاماً عن أعداد ضحايا صيدنايا تقدر ببضع عشرات الآلاف، وهي أرقام كبيرة ومرعبة في حد ذاتها، ولكن أحد ضيوف الفيلم يشير إلى مئات الآلاف، دون دليل. وعلى الإعلامي أن يدقق قبل أن يعتمد هذه الأرقام كحقائق.. ليس تشكيكاً في الوحشية، ولكن إثباتاً لها.
“خلف صيدنايا” مهم وثري بالمادة الإعلامية، وهو يراوح بين الفيلم الوثائقي والتقريرالإخباري، ورغم أن هذا جذاب جماهيرياً، لكنه قد يهدد بفقدان التقرير لقيمته الإعلامية، وبفقدان الفيلم لطاقته الشعرية الفنية. وهذا الهجين بات ملحوظا في محطات إخبارية وقنوات وثائقية عدة. ربما يحتاج إلى إعادة نظر.
الملاحظ أن التقرير الوثائقي لا يحمل أسماء صانعيه، بما يعني أن المحطة تتعامل معه كتقرير خبري لا فيلم، ولكنه كما ذكرت يحتوي على عناصر ولمحات “فيلمية”، وهذه العناصر جذابة للمشاهد وتزيد التقرير “عاطفية” وتأثيراً.. ولكنها مادة للعقل المتشكك ليسأل” هل نحن بإزاء فيلم له صانع ووجهة نظر، أم تقرير إعلامي محايد؟.
التقرير مهم وثري، ويحمل إمكانات هائلة لعمل عشرات التقارير الإعلامية والأفلام الوثائقية اللاحقة، التي نتمنى أن تتواصل، فما حدث على مدار عقود من الظلم، يحتاج إلى سنوات من الكشف والمناقشة والمداواة.
* ناقد فني