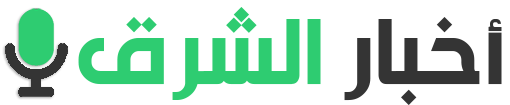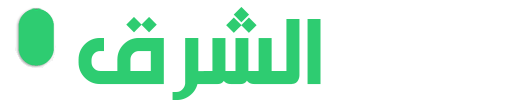"دار خولة" والبيوت المتنافرة بفعل السياسة والحداثة

في أحدث أعمالها بعنوان “دار خولة”، وهي رواية قصيرة صادرة عن منشورات تكوين، تأخذنا الكاتبة الكويتية بثينة العيسى إلى عالم الأمومة، لتقدّم جرعة مكثّفة من تناقضات الحياة، وتنبش في قضايا الهوية والتبعية وأحكام المجتمع، وقدرة وسائل التواصل على إفساد العلاقات، حتى أكثرها قوّة.
تنتمي “دار خولة” إلى رواية “اليوم الواحد”، فالأحداث تدور ليلة حفل العشاء الذي تعدّه الدكتورة خولة سليمان، أستاذة الفلكور، لأبنائها الثلاثة، وهو”العشاء” الذي كانت تعتبره محاولة للم شمل الأسرة، وإعادة العلاقة بين الأخوات، وعلاقتها بهم كأم.
خدعتها حالة الهدوء السائدة للحظات حول مائدة الطعام، التي تتسع لستة أشخاص، رغم أن الجالسين ثلاثة فحسب، فأرادت أن تستغل الفرصة وترمّم كل الشروخ في أسرتها، لكنها بمجرد أن ألقت حجراً، حرّكت كل المياه الراكدة ليشتعل الموقف ويتحوّل إلى كارثة.
تربط بثينة العيسى القرّاء في روايتها القصيرة “دار خولة”، بالشخصيات من الصفحات الأولى، تترك لهم مساحة الحديث واستخدام الأصوات المتعددة، حتى تمنح كل منهم فرصته في سرد حكايته ووجهة نظره، وتترك الحكم في النهاية للقارئ.
خولة السيدة التي تبلغ 55 عاماً، تربط بين الشيخوخة وأميركا، وتعترف بأنها لا تحب الاثنين، تكره علامات التقدّم في السن، ورغم ذلك لا تبذل مجهوداً لمحاولة إخفائها، بل تتركها تضع بصماتها على ملامحها وروحها، وتقنع نفسها بأنها “تشيخ بكرامة”، رغم أن “الشيخوخة في جوهرها إذلال وئيد”.
في استعدادها لحفل العشاء، تعود بالذاكرة إلى أكثر من ثلاثين عاماً مضت، إلى اللحظة التي تغيّرت فيها الأفكار والقناعات، عام 1991 بعد حرب التحرير، حينما خرجت وزوجها أستاذ اللغة العربية للاحتفاء بقوات التحالف الأجنبية التي حرّرت الكويت.
تتذكر حينها رؤية الكمال في النموذج الأميركي، ورغبتها في أن يكون أطفالها جزءاً من هذا العالم، بكل ما يحمله من اكتمال في الشكل والمضمون، كما كانت تراه وقتها، لكنها لم تدرك خطأ هذه الفكرة إلا بعد وفاة زوجها.
في مرحلة المراجعة، تتحوّل خولة إلى شخص عنيد متشدد تجاه العولمة والغرب، حيث أدانت “انحطاط النخب والمثقفين” و”حكم الغوغاء” في لقاء تلفزيوني، أغضب الحكومة والإسلاميين وحتى الليبراليين، والأهم أنه كسر ما تبقّى من علاقتها بأبنائها، الذين تباعدت شخصياتهم، ليمثّل كل منهم اتجاهاً أيدلوجياً، ورمزاً لجيل يتشدّد هو الآخر في فكره، ويرى أنه الأصح والأفضل.

تجد الأم نفسها محاصرة بين ناصر “المتأمرك”، ويوسف “فارض الوصاية الحكيم”، وحمد “المتذبذب”، الذي يحاول إرضاء أمه بطريقة جيل “زي”، بكل مفرداته الجديدة في الحياة.
لم تكن الهوية وتبعية المجتمعات العربية للنموذج الغربي، الأزمة الوحيدة في حياة خولة وأبنائها، ولم تكن علاقتها بهم يحكمها ظهورها في برنامج تلفزيوني، تحدثت فيه عن الأدب والتاريخ، بمفردات وجدتها عادية في قاموسها، لكنها تحوّلت إلى “ميم” و”تريند” على مواقع التواصل، التي نشرت كلامها مجتزئاً عن سياقه، ليسخر منها الجيل الجديد، ومن كل ما يربطه بالماضي أو بالثقافة، هذه المواقع التي لا يعرف روّادها عن الحياة سوى ما تقدّمه لهم.
منحت بثينة العيسى شخصياتها فرصة “البوح”، فانقسمت فصول الحكاية بين أصوات الشخصيات الأربع، والراوي العليم، ما منح القارئ فرصة رؤية الإشكالية بعين الأبطال وبمفرداتهم، وكشفت عن أفكار الأبناء تجاه أهلهم، وتجاه كل ما يمثلونه من ارتباط بثقافتهم العربية، فكانت شخصيات “دار خولة” كلها متطرفة في اتجاهاتها، تتمسك بما تعتقده فحسب، وترفض النقاش، وتجد أي ملاحظة نقداً مباشراً لها ولما تمثله، من دون أن تمنح نفسها أو الآخرين محاولة تقريب المسافات والحوار.
في “دار خولة” كان البيت رمزاً للوطن وتفاصيله في كل البلاد العربية؛ المنزل الذي تضيئه الأنوار وتظلله الأشجار، ولا يدري أحد بما يدور داخله من صراعات، تحاول خولة ملأه بالتفاصيل الحميمة، من وسادات، وأكواب قهوة وشكولاتة، وحتى ألعاب الأطفال الصغيرة، والطعام الساخن الذي قد تستميل به قلوب الأبناء.
لكن وسط هذه التفاصيل الدافئة، يشتبك الأبناء باتجاهاتهم المختلفة، ويكسرون كل التفاصيل، بينما ترقد خولة بجانب حوض السمك الذي أقنعها البائع أن الأسماك داخله متآلفة، لكنها كانت تستيقظ كل يوم لتجد أنهم التهموا بعضهم، وحتى عندما لم يكن في الحوض سوى سمكة واحدة، تموت هي الأخرى وكأن المشكلة في دار خولة، التي لم تكن تمثّل منزلاً في الكويت فحسب، لكنها نموذج لبيوت كثيرة في الدول العربية، تحوّل سكانها للحياة في جزر منعزلة، لا يسمعون ولا يفهمون بعضهم ويرفضون الوصول إلى نقاط اتفاق.