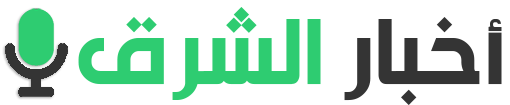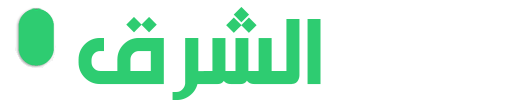عزت القمحاوي لـ”الشرق”: كل كتاب هو تعويض خسارة ما في الأدب

يكتب بمزاج الهواية، وينظر إلى الكاتب بوصفه طاهياً يعدّ وجبة تتطلب توابل حارة، ومزيج من النكهات، والكثير من ملاعق الحب، ودقّة المفردات وبساطتها.
عزت القمحاوي، صاحب مشروع سردي متفرّد، تأثّر بجيل الستينيات في مصر، وإن كان لا ينتمي إليهم. لا يغيب عن سطوره ذلك الحنين إلى قرية الطفولة، والارتياب في المدن القاسية على الغرباء.
وانطلاقاً من أحدث رواياته “بخلاف ما سبق”، كان هذا الحوار معه:
ربطت أحدث رواياتك “بخلاف ما سبق” برواية سابقة لك هي “ما رآه سامي يعقوب” لماذا؟
أعتقد أن الكاتب مثل “قافز الزانة”، يبدأ عمله بمستوى من الطموح، وعندما يشعر أنه لم يحققه يحاول مرّة أخرى، وقد لا نستشعر ذلك لأنه يعيد التجربة في عمل يبدو من سطح حكايته أنه مختلف عن السابق، فإذا دققنا نجد أن السؤال الفكري في الحالتين واحد.
شخصيّاً أشعر أني أكتب كل كتاب جديد لتعويض خسارة ما في الكتاب السابق. ولكن في العودة إلى “سامي يعقوب”، هناك شيء مختلف. هي الرغبة في العودة إلى صحبة ذلك الشاب الذي يقف على الحدود بين الذكاء وافتقاد التجربة، بين القدرة على رؤية المستقبل التي جعلته ينظر إلى الحياة كعرض متكرر والماضي الثقيل للعائلة الذي يجرّه خلفه.
كتبت نوفيلا “ما رآه سامي يعقوب” في 17 يوماً، كالحمى، لكنها نُشرت بعد أكثر من عام من المراجعة والعيش الكثيف مع بطلها. وعندما تركت العمل من يدي أحسست بفراغ مخيف، كنت كمن يغادر عزيزاً من لحم ودم.
هذا كان سبب العودة الأساسي، وقد حيّرني شكل العودة الذي لم أره من قبل في الروايات متعدّدة الأجزاء، ومع ذلك لم أرهق نفسي بالتنظير ولا بالخوف.
في العادة تتشابه استراتيجيات السرد، وتتقارب الأحجام بين جزء والتالي له في عمل متصل، لكن “ما رآه سامي يعقوب” كان نوفيلا، بكل ما تعنيه من حضور للشخصية الرئيسية.
كما أن زمنها يسير في دوائر، إذ يجري الحدث الرئيسي في نصف ساعة، ويلتف السرد إلى أكثر من مستوى من مستويات الماضي القريب والبعيد، بينما جاءت “بخلاف ما سبق” في ثلاثة أمثال حجم النوفيلا، وبعمارة روائية ضخمة، تحتل فيها الشخصيات الأخرى مساحات كبيرة، وزمنها أقرب إلى بناء الزمن الخطي الكلاسيكي.
كل ما همني أنني كنت مشتاقاً إلى سامي يعقوب شخصياً، وأردت له أن يجرّب حياة مختلفة عن حياة العزلة؛ فدفعت به إلى العيش في بستان ليتسع احتكاكه ببشر مختلفين، وبالحيوانات التي يعشقها، والتي تمتّعت بحضور إنساني في الرواية.
على ذكر النوفيلا وبالنظر إلى مشروعك الروائي، يبدو أنك تميل إلى التكثيف والإيجاز؟
إن كنا نتحدث عما أحب، فهو صحيح على صعيد الحياة والكتابة. أحب على سبيل المثال حقيبة السفر الصغيرة، والمائدة المتقشّفة، وأقل ما يمكن من التكنولوجيا الحديثة، ملحقات التلفون مثلاً جربت أن أقتنيها، لكن سرعان ما تضيع مني.
أحب أن أتحدث قليلاً، ومؤخراً كنت في مهرجان أدبي، وكان من المفترض أن أتحدث 25 دقيقة عن حياتي وحياة نصوصي بين الصحافة والأدب، تحدثت عن الصحافة وفجأة وجدت نفسي أتوقف عن الكلام قائلاً: “هذا كل ما لدي وسأكمل المدة إن سألتموني”، لم أكن قلت شيئاً عن الأدب.
في الكتابة أحب الكثافة حقاً، وأميل إلى النوفيلا لا الرواية، وبعض كتبي تسكت فجأة، لكن من جهة أخرى أدرك وظيفة اللغة في بناء الرواية، وهي يجب أن تكون مساوية للتجربة لا أكثر ولا أقل.
تتناغم مع عناصر البناء الأخرى كالشخصية والحدث والمكان، لهذا تتطلب بعض التجارب أن تكون الرواية أكبر، كما في “بيت الديب”، وحديثاً “بخلاف ما سبق”، التي لا أريد أن أقول كم كانت عدد كلماتها قبل النشر، لكني وضعت الاختصار هدفاً حتى وصلت إلى الحجم الذي احتفظت به، وهو كبير.
ربما “بيت الديب” هي عملك الأكثر ضخامة واستعادة فن الرواية بوصفه “ملحمة البورجوازية” كما قال هيغل؟
من حيث بنائها الزمني نعم، لها زمن ملحمي، من حيث الحجم فاقتها “بخلاف ما سبق”. عندما كتبتها كنت أحاول أن أقدم ريفاً عشت فيه، ووجدت أنه يختلف عن صورة الريف الذي قرأته في روايات عدّة قدّمت ريفاً ساكناً، وكأن فقره سرمدي، وجهله قدر، وعزلته شبه محكمة.
بينما قدّمت ريفاً خبِرته، صعدت فيه عائلة الديب إلى شكل من البرجوازية الريفية، وكانت القرية جزءاً من حركة التاريخ المصري والعربي، بعض أفراد العائلة نزحوا إلى فلسطين والعراق، عاشوا نكبة فلسطين وغزو الكويت، ثم احتلال بغداد، وكان على أحفادهم أن يعودوا إلى “العش”، وهذا هو اسم القرية بعد أن ضاقت بهم الجغرافيا العربية.
إذا عدنا إلى “مدينة اللذة” وهي من أعمالك الأولى، كان ثمّة ميل إلى التجريب والغموض والكتابة الشذرية، فهل تراجع هذا الطموح لصالح الحكاية؟
في “مدينة اللذة” نزوع إلى قصيدة النثر، ولو كتبتها اليوم سأكتبها بالطريقة ذاتها، فهذه اللغة هي الأنسب لروح الأسطورة والميثولوجيا التي تسكنها. أما عن صغر الحجم، فقد تكرر بعد ذلك.
عدت إلى تلك الكثافة والغموض في “البحر خلف الستائر” والكثافة، من دون الغموض في “ما رآه سامي يعقوب”. كل تجربة تولد معها لغتها الخاصة.
يبدو كأنك تسير بمحاذاة الأجيال في مصر، لا تجتر العالم المحفوظي، ولا تعيد إنتاج جيل الستينيات، فأين تضع نفسك؟
حقيقة لا أعرف أين أضع نفسي، لكني حريص حتى على عدم إعادة إنتاج نفسي، قد يتكرر الهم، وينتقل من عمل إلى عمل، لكن إعادة إنتاج التجربة كلها مستحيل، وتتناقض حتى مع الواقع. القرية التي كتبتها في “بيت الديب” لم تعد موجودة في الواقع ذاته، بعد خمسة عشر عاماً.
لا يمكن قراءة مشروعك السردي أيضاً من دون ملاحظة هذا التداخل بين الحس الصحفي الاستقصائي وخفة السرد وبراعته، كأنك تميل إلى النص المفتوح؟
أصابني طموح الكتابة عندما كنت مراهقاً، فتوجهت إلى دراسة الصحافة، وعندما مارستها أدركت أنها الأخطر على الأدب، وأن كلمتها واسعة الانتشار سريعة التلف.
عملت في صحافة مليونية التوزيع، لكن الصحيفة تتقادم في ساعة، وفي الصباح التالي تتحوّل الكلمات إلى ممسحة للزجاج، ولأوراق الصحف سمعة حسنة في تنظيف الشبابيك.
لذلك حاولت استدراج السرد إلى مقالي الصحفي، كي تمنحه الحكاية عمراً أطول، وتوصلت بهذه الحيلة إلى النوع العابر للأجناس الأدبية في كتابتي من “الأيك” إلى “الطاهي يقتل الكاتب ينتحر”. وكما أخذت السرد إلى الصحافة أخذت ما أعجبني في الصحافة، مثل الاختصار والوضوح إلى نصّي الروائي.
إذن كيف تعثر على الخيط الفاصل بين “المقال” و”القصّة”؟
ما أحاوله هو العثور على الخط الرابط، وهذا ما يطمئنني أثناء الكتابة، أنني أسير في الطريق السليم؛ طريق اللعب والاستمتاع بما أكتب، قبل أن يخرج إلى القارئ في شكل قصّة أو مقال.
من “اللذة” إلى “الغواية”.. هل المسألة رد اعتبار للحواس بديلاً لشعارات الستينيات الرنانة؟
كل الأيديولوجيا المباشرة لم تترك أثراً. الحقبة السوفيتية بكاملها لم يبق منها سوى ما كتبه المنشقون، أي الذين رأوا الخراب في التجربة، ووقفوا على النقيض منها.
لديّ موقف ليس من أيديولوجيا الستينيات فحسب، بل من الكثير من الهراء الذي كُتب في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”.
كانت كتابات تثير الزوابع، ولا تحقّق سوى خفض سقف التعبير وعزل المثقف عن الشارع؛ فالخطاب المتطرّف المناوئ، كان مسيطراً على الشارع، ويصوّر للناس أن من يرفضونه كفّار. الحفاوة بالحواس بالنسبة لي ميل جمالي وفكري في الوقت ذاته، تنبه الإنسان إلى أهمية حياته، وأن وجوده في هذه الحياة لحظة يجب أن تُغتنم.
“السفر” وليس “الغربة” يبدو مفهوماً ملهماً لك كما في “غرفة المسافرين”؟
أحب السفر جداً، الانتقال والعودة، لأن الأهمية تأتي من الحركة، وليس الانتقال والركون إلى المكان الجديد. السفر يشبه الموت والعودة بعث جديد. وكلما تكرر ذلك تعددت حيواتنا.
والسفر يشبه رحلة الكتابة التي يتشاركها الكاتب والقارئ، كل نص رحلة، وهو روح الكتابة في الوقت ذاته، هو روح العجائبي تحديداً، فالغريب والخارق يأتي من بعيد، لهذا يمكننا أن نعتبر “ألف ليلة وليلة” كتاباً في السفر.
لو كنتَ على سفر من تأخذ معك من الكُتّاب والكتب؟
في السفر تكون أولوياتي هي العيش العميق في المكان وقراءته، كنت أحمل كتاباً أو كتابين صغيري الحجم لحالات الأرق، والآن صارت القراءة اللوحية مكتبة ترافقني أعود إليها قليلاً. لكن إجمالاً أحب صحبة كتب صغيرة، قد تكون لأصدقائي القدامى، مثل كاواباتا أو توماس مان، وقد تكون أعمالاً جديدة.
استلهاماً من كتابك “الطاهي يقتل والكاتب ينتحر”، ما الذي يجمع بين الطبخ والكتابة؟
على مدار الكتاب أتأمل هذه المشتركات، وهي كثيرة جداً، من لحظة استعداد الطاهي أمام موقده والكاتب أمام شاشته، إلى المقدّمات التي تعني بأي العناصر نبدأ، وما الذي نضيف بعده من المكوّنات الأساسية والبهارات، وما التوقيت المناسب لإضافة كل عنصر، وكيف نستشعر لحظة النضج، حتى في المخبوزات تتأثر النتيجة بترتيب الإضافات ووقت التخمير وكمية العجن التي تجعل خبزاً يختلف عن آخر، وحلوى تختلف عن حلوى رغم تطابق المكوّنات.
هذا ينقلنا لطقوسك أنت كطاهٍ أو كاتب.. كيف تتبع فكرتك حتى النشر، وهل أصابك ندم ما؟
في الكتب العابرة للنوع، تظل الأفكار تتكاثف، ربما لعشرة أو عشرين سنة، ثم تأتي لحظة شغف مواتية للكتابة. في الرواية تنطلق الشرارة من لحظة، من جملة قالها أحدهم، من حلم، أو ربما من إهانة.
ثم يأتي البناء على رأس الكتابة ينمو مع التقدم، كما يفعل البناؤون الفطريون قبل معرفة المخططات الهندسية للمباني. لم أشعر أبداً بالندم، لأني لا أدفع بنص إلى النشر إلا بعد استنفاد قدرتي على التجويد. لكن دائماً ما أشعر بالأسف والألم عقب كل نهاية.