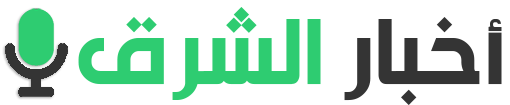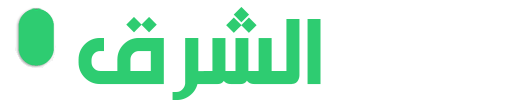فيلم “أناشيد آدم”.. سردية البراءة المفقودة والزمن المعطوب

في فيلمه المتفرد “أناشيد آدم”، الذي يمزج بين الواقعية السحرية والتأمل الفلسفي، يقدم المخرج العراقي عدي رشيد رؤية عميقة لتأثير الزمن على الإنسان والمجتمع.
الفيلم الذي حصل على جائزة اليسر لأفضل سيناريو في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونال استحساناً نقدياً حينها، عرض في مؤخرا في مهرجان أفلام سعودية ونال جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل
يقدّم رشيد تأمّلاً سينمائياً نادراً في مفهوم الزمن، الطفولة، والثبات أمام التآكل الجماعي، بعيداً عن السرد الكلاسيكي المباشر، يبني رشيد عالمه ببطء وتأمل، مطلقاً مشروعاً سينمائياً يحفر عميقاً في ذاكرة الإنسان العراقي، ويمتد ليطال الأسئلة الكبرى حول المصير الإنساني كله.
تبدأ القصة بمشهد بالغ الرمزية: في عام 1946 يظهر طفلان، آدم وشقيقه علي، يشهدان غسل جثة جدهما، يمثل هذا الطقس أول تماس حقيقي مع فكرة الموت، يترك أثراً غير مرئي على وعي آدم.
هناك، في تلك اللحظة، يتخذ قراراً غريزياً غير منطقي في الظاهر: أن يرفض النمو، في عالم حيث الكبر يعني الانخراط في دوائر الفقد والتآكل، يختار آدم الطفولة كملجأ، كثورة صامتة، فما هو الثمن الذي دفعه بهذا القرار؟ .
زمن داخلي وزمن اجتماعي
يبني رشيد أطروحة فلسفية حول الزمن الداخلي مقابل الزمن الاجتماعي.أثر الأزمات العراقية التي تتوالى عبر سنوات مفصلية (1946-1952-1964-1981-2014).
يعيش آدم خلال هذه السنوات خارج معادلة الزمن الاجتماعي، ففي الوقت الذي يكبر فيه الآخرون يتزوجون، يشيخون، يموتون يظل آدم ثابتاً، مجمّداً داخل لحظة براءة أولى، وذلك بعد صدمته الأولى لماهية الموت ممثلاً في جثة، بينما “إيمان” ابنة عمه وشقيقه “عليط و”إنكي” الراعي وصديق “آدم” المقرب، يريان في “آدم” نعمة و هدية إلهية في هذه القرية القاسية وعواصف الغبار التي تسيطر عليها، وهو غير راغب بالتخلي عنها.
يذكرنا هذا التشبث بالطفولة بمفهوم الزمن الداخلي عند هنري برجسون، الذي يرى أن الزمن الحقيقي هو ذلك الذي يُعاش لا الذي يُقاس بالساعات والأيام والسنوات.
العلاقات التي يرسمها الفيلم بين “آدم” وأخيه “علي”، بينه وبين ابنة عمه “إيمان” تكشف مفارقة الزمن المتباين علي يكبر وينخرط في الدورات الاجتماعية التقليدية، “إيمان” تحاول أن تمد جسرًا بين الطفولة والعالم، لكنها تدرك تدريجياً أن المسافة شاسعة، كل محاولة للتواصل تصطدم بجدار الزمن المتجمد حول “آدم”.
بهذا، تمثل الشخصيات رغم محيطها الخارجي تجسيداً لصراع الزمن مع الإنسان، والرغبة في النضج مقابل الرغبة في الحفاظ على البراءة، الاستسلام للواقع أو مقاومته عبر الصمت.
وفي استمرار نمو “علي” وابنه يصبح الزمن الاجتماعي خيانة للروح، النمو ليس تقدّماً بل انحدار نحو الموت، لهذا، اختيار “آدم” ألا يكبر لا يبدو قراراً طفولياً بل موقفاً فلسفياً عميقاً: رفض الانصهار في دورة الحياة التي لا تقود إلا إلى الفناء.
البنية البصرية والتكوين الصوتي
في أحد المشاهد يُجبر “آدم” على مغادرة القرية، حيث يناديه والده بحزم ويأخذه بعيداً، ينما تنوح والدته من بعيد، تصرخ باسمه وتحاول اللحاق به، لكن والده يزجرها ويهددها بعدم الاقتراب، يُقاد “آدم” إلى مخبأ طيني، يدفع إلى غرفة بباب خشبي، ويغلق عليه الباب بأمر من والده، ويهدد بعدم فك أسره ظناً منه أنه ملعون، ولعنته تحل على القرية وأهلها.
قدم هذا المشهد دون مواجهة أو تبرير، بل في لغة جسد تبرز الصراع بين البراءة والسلطة، و المعاقبة على رفض التكوين الطبيعي والانخراط في عالم الكبار، تعكس السينوغرافيا هذا الصراع من خلال الألوان الترابية والضوء النافذ في الغرفة الطينية المعتمة، الصمت الذي يلف هذا المشهد يعبر عن القمع الذي يتعرض له “آدم” وعدم قدرته على الاحتجاج.
اختار رشيد أن يتماهى مع فلسفة الثبات هذه من خلال لغة بصرية وصوتية بطيئة ومتوترة، المشاهد طويلة، الكاميرا ساكنة، الألوان يغلب عليها البني والترابي، كأن كل شيء مغطى بطبقة خفيفة من الغبار .
الصمت يلعب دوراً جوهرياً؛ حين يتكلم الفيلم، يتكلم بالرياح، بصدى الخطوات البعيدة، والأنين المتقطع للأبواب، لا شيء هنا يعبر عن الاستمرارية، بل عن شعور دائم في العدم.
عدي رشيد ليس غريباً عن كيفية تنفيذ أعماله وطرح الأسئلة الكبرى من خلالها، منذ تجربته السابقة “تحت أنقاض بغداد”، كان واضحاً أن مشروعه الإخراجي يتجاوز مجرد توثيق الكارثة السياسية إلى استبطان الوجع الداخلي للإنسان العراقي.
في “أناشيد آدم”، يخطو خطوة أبعد، مبتعداً عن المباشرة والخطابية، ومتجهاً إلى سينما الفكرة، حيث الصورة نفسها تصبح معادلاً شعورياً للزمن، وحيث تتكلم التفاصيل البسيطة بما يفوق الكلمات.
عاش “آدم” عبر هذه السنوات استعارة مكسورة لطفل عراقي، وربما لطفل بشري مطلق، رافضاً الامتثال لعنف التاريخ.
لماذا “أناشيد آدم”؟
يوحي اختيار العنوان بتمائم مبثوثة من صمت طويل، لا تُغنى بقدر ما تُشعر، لن نرى “آدم” في الفيلم بطلاً مغامراً، لكننا نرى بدلاً من ذلك النغمة الحزينة المتكررة، صوت داخلي يهمس بأناشيده ضد صخب العالم الخارجي.
وهو بصفته رمزاً للإنسان الأول، هو بداية الخليقة، واستخدام “أناشيد” بصيغة الجمع يوحي بتعدد الحكايات الصغيرة التي يحفظها الزمن المجمد داخله: أناشيد الحنين، أناشيد الرفض، وأناشيد الحزن العميق.
هكذا يصبح العنوان مدخلاً لفهم أن الفيلم نفسه نشيد طويل مكسور عن الفقد، لا ينتهي ولا يكتمل.
رمزية للعراق
من خلال شخصية “آدم”، يرمز الفيلم إلى العراق ككيان لم يُسمح له أن يكبر بشكل طبيعي، بلد ظل معلقاً بين ماضٍ منسي ومستقبل مسدود، كما يمكن قراءة “آدم” بوصفه إنسان يحاول التمسك بلحظة البراءة الأصلية، رافضاً الانجرار نحو عالم التآكل.
وبعكس مفهوم الانسحاب، رفض النمو في الفيلم يجسد المقاومة، يصبح الثبات نفسه شكلاً من أشكال الصمود، حتى لو بدا صامتاً، معزولاً، عن الهشاشة المتمردة، عن محاولة التشبث بما لا يمكن استعادته فهو فعل عناد ورعونة ضد تاريخ يُراد له أن يُمحى.
في بلد مثل العراق تلتهمه الحروب والمآسي، تأتي “أناشيد آدم” لتذكرنا أن أشد أشكال المقاومة قد تكون في أبسط الأفعال رغم لا واقعيتها: في قرار طفل ألا يكبر، وألا يخون لحظة وجوده الأولى.
في النهاية، لا يحسم الفيلم موقفه.. هل انتصر “آدم”؟ أم خسر معركته ضد الزمن؟ يتركنا رشيد في مساحة رمادية من التفكير، مساحة يلتقي فيها الحنين بالمأساة، والبراءة بالحزن العميق لكنه يؤكد أن الزمن عدو داخلي.
بهذه الطريقة، يقدم “أناشيد آدم” تجربة سينمائية تُعاش، عمل يهمس ببطء في أذن الذاكرة، داعياً إيانا للتوقف، للتأمل، وربما، للحظة واحدة، للتمرد الصامت على الزمن الذي لا يرحم.