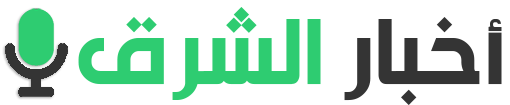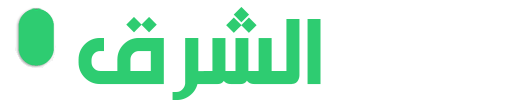نيتشه والموسيقى الجديدة: قوة تشحن العالم

تحتل الموسيقى موقعاً مركزياً في المشروع الفلسفي لدى نيتشه، فهي لا تعدّ فناً جمالياً ثانوياً، بل صدى للوجود نفسه، ووسيط ميتافيزيقي يتجاوز حدود اللغة والعقل، ليكشف عن إيقاع الحقيقة وعمقها الخفي.
يستعرض الناقد والصحفي الفرنسي بيار لاسير في كتابه “أفكار نيتشه حول الموسيقى”، الصادر حديثاً عن دار الرافدين في بغداد، ترجمة علي شمس الدين، العلاقة العميقة والمعقّدة التي ربطت نيتشه بالموسيقى، منذ طفولته وحتى أيامه الأخيرة.
يأتي الكتاب بلغة تتطلب تمعّناً وإعادة قراءة، لفهم ترابط الأفكار وتسلسلها. ففي مواضع عدّة، يشعر القارئ بشيء من التشتّت أو الغموض، ربما بسبب طبيعة الترجمة، أو نتيجة الأسلوب الذي اختاره الكاتب الأصلي لعرض مادته.
ليست مجرد فن ترفيهي
الموسيقى عند نيتشه ليست مجرّد فن ترفيهي يخاطب الذوق والمشاعر، بل تجربة وجودية تلامس الأصل، وتكشف التوتر العميق بين النظام والفوضى، بين الحلم والانفعال.
الفن عند نيتشه، يمرّ عبر البوابة الإغريقية، حيث يتصارع الإلهان “أبولو” و”ديونيسوس”، لا كرمزين دينيين فحسب، بل كمبدأين جماليين يتجاذبان كل تجربة فنية. إذ يمثّل أبولو مبدأ النظام، والعقل والوضوح والشكل والشعر الملحمي، أي كل ما هو متّزن ومنضبط.
أما ديونيسوس، فيرمز إلى الفوضى، والغريزة والسُكر والنشوة. التوتر الخلّاق بين هذين المبدأين، لا يقوم على الانفصال، بل على الانسجام الجدلي، ومن هذا التوتر وُلد الفن الإغريقي الأصيل، المتوازن بين الشكل والعاطفة.
تأثّر نيتشه بعمق بهذا التوتر، انجذب إلى صوت الناي الديونيزوسي، لأنه رأى فيه تلك القوة الغامضة التي تسبق كل عقل وكل شكل. فهي محرك للوعي، وصوت يعبّر عن الكينونة قبل أن تتشكّل في قوالب الثقافة. ورأى في الفن الإغريقي مثالاً أعلى للجمال، لا يولد من الانسجام السطحي بل من الصراع.
الموسيقى قوّة
منذ كتابه المبكر “ولادة التراجيديا”، بدأ نيتشه برسم ملامح هذا التصوّر؛ حيث قدّم الموسيقى كقوة خلّاقة تعيد شحن العالم بالحياة والرهبة. لم تكن بالنسبة إليه، سعياً نحو الانسجام، بل خرقاً له، لحظة شعورية تتقدّم كل تشكّل ثقافي.
من هنا، رسم صورة الفنان بوصفه الإله الأخير: لا يسنّ القوانين بل يخلقها، لا يهيمن بل يعاني ويبدع.
في خلفية هذا التصوّر، يظل شوبنهاور حاضراً بقوّة. فقد تأثّر نيتشه بكتابه “العالم كإرادة وتمثّل”، وتبنّى منه تصوّراً ميتافيزيقياً للموسيقى، باعتبارها الفن الوحيد الذي لا يُحاكي، بل يُجسّد الإرادة مباشرة.
إن كل نغمة، عند شوبنهاور، ليست تمثيلاً بل حضوراً، ومن هنا رآها نيتشه فناً روحياً بامتياز، قادراً على تجاوز الدين لا تمثيله، لأنه يواجه الألم والحياة من دون أوهام.
فاغنر والموسيقى
في هذا السياق، كان لفاغنر أثر محوري في خيال نيتشه وتفكيره. رآه، في بداياته، مخلّصاً للفن الألماني، ولعالم ثقافي مأزوم، إذ لمس في موسيقاه الأولى عودة إلى الروح الديونيزوسية، إلى ذلك الصوت العميق الذي يخترق الفرد ليوقظ فيه الحلم الجمعي ويحرّك الغرائز.
لم يكن إعجاب نيتشه بفاغنر فنياً فقط، بل اتخذ طابعاً مقدساً، إذ رآه نبياً لفن جديد يعيد إلى الموسيقى قداستها الميتافيزيقية.
جاء اللقاء الأول بين نيتشه وفاغنر كمفصل حاسم، إذ رأى في الأخير تجسيداً حيّاً لأفكار شوبنهاور في الموسيقى. ففي أوبرا “تريستان وإيزولده”، شعر نيتشه أن الإرادة تتكلم بلغة الموسيقى، وأن الغريزة والموت والنشوة تنصهر في سيمفونية لا تُفسّر بل تُعاش.
غير أن هذا الحلم لم يدم؛ فمع مرور الزمن تحوّل إلى كابوس، حين رأى نيتشه أن فاغنر لم يعد صوت الحياة، بل صوت الانحطاط. لقد صارت الموسيقى عند فاغنر، بحسب نيتشه، وسيلة دعائية تخدّر وتهيمن، في خدمة قومية مسيحية شمولية.
لم يعد فاغنر، في نظره، ذلك الفنان الحر، بل أصبح أداة لسطوة أخلاقية وثقافية، لا تعبّر إلا عن الرداءة والانحلال. هكذا انهار مشروع الخلاص الجمالي.
ساحةً للصراع الفلسفي
عند هذه النقطة، انتقلت الموسيقى في تجربة نيتشه من كونها تجربة جمالية إلى ساحة للصراع الفلسفي. لم يكن يعارض الانفعال، بل الانفعال الفارغ؛ ولم يرفض التأثير، بل التأثير الذي لا يُحرّك الوعي بل يُخدّره.
فالموسيقى العظيمة ليست ما يُسمع، بل ما يُعاش، ما يخترق وعي المتلقي، لا ما يُبهره بسطحية. لذلك، ظهرت عنده مفاهيم مثل “الانحطاط” و”النشاز”، لا كمفاهيم تقنية، بل كتشخيصات لحالة حضارية تنحدر، وتجعل من الموسيقى مرثية لعالم محتضر، بدل أن تكون نشيده.
حتى بيتهوفن، الذي ألهم نيتشه في بداياته، لم يسلم من التقييم القاسي. فقد رآه لاحقاً موسيقياً جنائزياً، ينشد على أطلال أوروبا المنهارة، بدل أن يعيد إحياءها. فتحول الفن في نظره، من بوابة إلى المطلق، إلى صدى لحضارات لم يبقَ لها سوى ظلالها الباهتة في الذاكرة الجمعية.
ومع ذلك، لم ينسحب نيتشه من عالم الموسيقى، بل صار أكثر قرباً منه، مشدداً على الحاجة إلى فن جديد: موسيقى تُفكر، لا تُفتن، تُحرر، لا تُخدّر، تخاطب الأعماق، لا تُسلّي.
اللافت في معالجة نيتشه للموسيقى، ليس فقط جرأته في نقد الأسماء الكبرى، بل شجاعته في إعادة تعريف الجمال ذاته. فقد كان سبّاقاً في مهاجمة فن المتعة السهلة، وهنا يبدو نيتشه أقرب إلى الفنان منه إلى الفيلسوف؛ إذ لا ينظر إلى الجمال كمفهوم نظري بل كألم ناضج، كتجربة تحفر في الذات قبل أن تبهجها.
من هذا المنظور، لم يكن نيتشه ناقداً للموسيقى، بقدر ما كان مناضلاً يطالبها الوفاء بوعدها: أن تكون صدى للوجود، وصوت الإرادة نفسها.
الدعوة إلى موسيقى جديدة
غير أن الموسيقى الرومانتيكية الحديثة، وخصوصاً الألمانية منها، لم ترقَ إلى هذا المثال. فقد رآها نيتشه غريبة عن الروح الإغريقية، مخدّرة، تغري المشاعر السطحية، وتفتقر إلى البنية الصارمة.
كانت، في نظره، أقرب إلى إدمان الحنين منها إلى نداء الوعي، وهاجمها بوصفها تجسيداً لانهيار الذوق، لأنها تهرب من الوضوح إلى التشويش، وتروّج لمتعة مائعة لا توقظ بل تُخدّر.
من هنا، جاءت دعوته إلى الحذر من هذا الذوق، بل إلى تحريمه على النفس الطامحة إلى صفاء الفكر. لقد دعا إلى موسيقى جديدة، قويّة، نابعة من الجنوب، تتمتع بصحة فنية وروحية، وتثأر من الانهيار الرومانتيكي.
ورغم هذا النقد العنيف، لم يعمد نيتشه إلى التخلي عن حلمه الشخصي بأن يكون مؤلفاً موسيقياً. فكتب مقطوعات موسيقية تجسّد رؤيته، مثل “صدى ليلة من ليالي سيلفستر”، التي طوّرها لاحقاً إلى “تأملات في المانفريدي”، ساعياً إلى تحويل ألمه الشخصي، إلى شكل فني يتجاوز السمع نحو نداء داخلي عميق.
وعلى الرغم من التحوّلات، ظل نيتشه وفياً لفكرة جوهرية، مفادها أن الفن والموسيقى في صميمه، ليسا للزينة بل للحقيقة. كانت رؤيته للموسيقى ثورة على الذوق الكسول، وحلماً بموسيقى تنقذ الإنسان من الرداءة، لا تلهيه عنها.