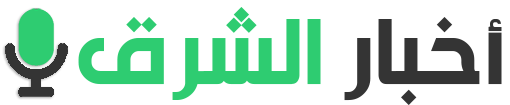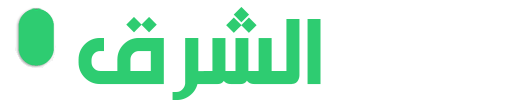6 أيام: تجربة مصرية في أفلام السير والمحادثة

في عام 2011 قدمت المخرجة الدنماركية الأصل لون شرفيج – صاحبة التجربة المميزة An Education (2009)، فيلمها الرومانتيكي الرقيق One Day، عن رواية للكاتب ديفيد نيكلوس والتي كتب لها السيناريو بنفسه، وقام ببطولته آن هيثاوي وجيم ستوجيس عن حكاية شاب وفتاة، عبر التركيز على يوم واحد فقط في السنة لمدة 18 عاماً متوالية، منذ أن التقيا فيه لأول مرة، وحتى انتهت حياة الفتاة بعد زواجهما بسنوات قليلة.
وفي عام 2025 يقدم الكاتب وائل حمدي تجربته السينمائية الرابعة – بعد “ميكانو” و”هيبتا” و”أنف وثلاث عيون”- تحمل توقيع المخرج الشاب كريم شعبان لأول مرة بعنوان “6 أيام”، يحكي فيه قصة “يوسف” و”عالية” اللذان يلتقيان خلال 18 سنة – من 2006 وحتى 2024 – في يوم واحد مكرر، هو 19 ديسمبر، وعبر الأيام الست فقط نتعرف على حكايتهما المعقدة وحيواتهما المشتبكة مع سياقات تحول اجتماعي وإنساني لعالم قديم ينهار، وعالم جديد فاقد للحس والخيال ينهض على أطلاله.
لا يمكن تجاهل أن الفيلم المصري يحمل اقتباساً واضحاً، دون الإشارة للمصدر من الفيلم الإنجليزي السابق عليه، ليس فقط على مستوى البناء؛ أي اعتماد السردية على وحدة زمنية مكررة هي يوم معين عبر سنوات طويلة، لكن أيضاً على مستوى الفكرة الأساسية؛ التي تجمع ما بين الحكاية الرومانتيكية المتصاعدة وبين القراءة الاجتماعية الناقدة أو الراصدة للتحولات الحاصلة في مجتمع ما بين عصرين – من 88 حتى 2006- حيث نهاية عصر البث التليفزيوني التقليدي، والخطابات المكتوبة والمطاعم الكلاسيكية الراقية، وبداية عصر التليفون المحمول والإنترنت و(الفرانشايز)، وهو ما يمكن أن نلمحه أيضاً في الزاوية الاجتماعية لفيلم 6 أيام، والذي يبدأ عام 2006 -وهو نفس العام الذي يبدأ به الفيلم الإنجليزي! والذي ترحل فيه بطلته أيضاً! وكأن الفيلم المصري يعيد إنتاج الحكاية مرة أخرى في بلد آخر يمر بتحولات مشابهة عبر قصة ولد وبنت آخرين.
بالمناسبة يوجد فيلم مصري بعنوان “ولد وبنت” إنتاج 2010 للمخرج كريم العدل، ويحمل جينات مشابهة لقصة شاب وفتاة عبر عدة سنوات يجمعهما الحب وتفرقهما الشفرات الطبقية الحادة، في مجتمع منكوب بالإزدواجية والحماقة الاجتماعية المدمرة.
وكما انشغل One Day بالتحولات الاجتماعية المبطنة في سياق الحكاية الرومانسية، ينشغل الفيلم المصري أيضاً بفكرة العالم القديم، الذي ينهار مخلفاً أنقاضاً روحية ونفسية، ملوثة للذكريات الفاتنة، التي يحملها وجدان “يوسف” و”عالية” منذ أن كانا طالبين في الثانوي عام 2006 يتسربان من المدرسة لمشاهدة فيلم “دنيا” من إخراج جوسلين صعب وبطولة حنان ترك ومحمد منير، مفضلين إياه على “في محطة مصر”، قبل أن تتعرض علاقتهما للبتر بشكل قسري في عصر ما قبل الـ”سوشيال ميديا” وانتشار التليفون المحمول في يد الجميع.
السير والمحادثات الطويلة
جاءت المعالجة المصرية للأصل السينمائي الإنجليزي معتمدة على إدخال عنصر شكلي مميز، لكنه يمثل تحدياً مستمراً لكل من يلجأ إليه، وهو ما يطلق عليه في أدبيات الأفلام Walk And Talk أي الأفلام التي تعتمد في بنائها الدرامي بالأساس على السير لمسافات طويلة والمحادثة المستمرة المتراشقة بين شخصيتين خلال وحدة زمنية قصيرة، عادة ما تكون يوم أو ليلة أو بضع ساعات، وهي بالمناسبة أيضا شكل يحمل كلاسيكية واضحة في البناء حيث يلتزم بوحدة الزمان – الليلة أو اليوم- والمكان – المدينة وشوارعها- والموضوع – علاقة الحب التي تنمو بين شخصين يجمعهما القدر في مصادفة سماوية، لتشتبك أرواحهما الشغوفة ببوحهما الطويل عن الحياة، ومشتقاتها الوجودية والأثيرية.
يكفي أن نضرب مثلاً بثلاثية Before Midnight, و Before Sunset، و Before Sunrise او بتجربة عباس كيروستامي الشهيرة Certified Copy.
ما فعله “حمدي” و”شعبان” في نسختهمh المصرية هو دمج عنصر الوحدة الزمنية المكررة –اليوم- المأخوذة من الفيلم الإنجليزي، مع شكل السير والمحادثة المعروف في التجارب الرومانتيكية المشار إليها سابقاً، وصياغة تجربة رومانسية اجتماعية بطلاها يعاندان قدرهما السهل – اجتماعهما السنوى المميز والمتكرر رغم الفوارق والمسافات، وحبهما العميق المتبادل- ويستسلمان لقدرهما الصعب – ظروفهما العائلية المشوهة وتخبطهما المهني المرتبط بفقدان بوصلة الهدف والسعي نحو الاكتمال بالنصف الروحي، والمطلوب لضمان استمرارية الحياة بشكل أكثر حنوا، وأقل حدة وقتامة.
والحقيقة أن المعالجة درامياً وبصرياً بهذا الشكل أفلحت إلى حد ما في تحقيق استغراق نسبي في الحكاية، لكنه تحدي كبير يستلزم حالة إيقاعية حيوية جداً، لضمان الحفاظ على مشاعر المتلقي وانتباهه الذهني طوال الوقت، خاصة مع الديالوجات الطويلة التي ترتبط باستعراض التاريخ القصير للشخصيات – ما بين الأيام التي يلتقون فيها كل بضعة أعوام- والوقوف على اللحظة الراهنة في حياة كل منهما، ومحاولة الإرهاص بما يمكن أن تشهده الفترة المقبلة من علاقتهما سواء بالأمل أو العتاب أو اليأس التام من أن يستمر اللقاء محافظاً على صحة العلاقة شعورياً ووجدانياً.
فهل نجح الفيلم في ضمان هذه الحيوية التي تعكس فهماً للتحدي المطلوب؟
يمكن القول أن ثمة تفاوت واضح في حيوية الإيقاع الخاص بكل يوم من أيام اللقاء، مع الأخذ في الاعتبار أننا أمام تركيز كامل معهما، دون استدعاء شخصيات أخرى- حتى من تلك التي يتحدثون عنها- إلى المشهد أو الحاضر المتدفق بينهما! وباستثناء شخصية الأم – أم عالية- أو خالها اللذان يظهران في اليوم الأول – يوم الفراق في مرحلة الصبا والمحبة البكر- لا يستحضر السيناريو أي من شخصيات الآباء – والدا “عالية” و”يوسف” اللذان يمثلان محور أزمتهما الأسرية على اختلاف نوعها- ولا زوج “عالية” الذي يكسر لها ذراعها ولا زوجة “يوسف”، أو طليقته فيما بعد، وكلها شخصيات تمثل مرتكزات أساسية في صياغة الأزمات الخاصة بالشخصيتين، بجانب أزمتهما الأكبر وهي عدم قدرتهما على اتخاذ قرار الارتباط بشكل واعي رغم ارتباطهما على مستوى الصدفة القدرية واللاوعي.
هذا التركيز على عالية ويوسف فقط حاول خلق صلة شعورية وطيدة بينهما وبين المتلقي – على عكس الفيلم الإنجليزي مثلاً الذي شاهدنا فيه تقريباً كل الشخصيات المرتبطة حياتياً وشعورياً بالشاب والفتاة- لكن مع تفاوت المساحة الزمنية لكل يوم – اليوم الأول مثلاً في مرحلة الصبا أقصر هذه الأيام- ومع تفاوت المراحل العمرية أو الاجتماعية لكل شخصية في كل يوم عن الآخر، بدت بعض الأيام ثقيلة الوطأة، مفعمة بالبطء وعدم التناغم، مثل اليوم الثالث الذي نرى فيه “عالية” وقد صارت مضيفة جوية بينما “يوسف” أقرب للمشردين – بالطبع هناك تماس واضح بين هيئة “يوسف” وهيئة بطل الفيلم الإنجليزي في مرحلة التشرد- وهو يوم قصير أيضاً ويعتبر تكئة درامية سوف يعود السيناريو ليستخدمها في اليوم الخامس، وهو يوم المواجهة المنتظر بينهما عندما تصارحه “عالية” بأنها سعت لأن تكون مضيفة من أجل أن تستحقه كطبيب أسنان بدلاً من أن تظل عاملة في مطعم – مثل بطلة الفيلم الإنجليزي أيضاً- لكن “يوسف” لم ينتبه إلى ذلك وظل ممعناً في تجاهل الرابط القدري بينهما.
اليوم الثالث هو أضعف الأيام الست، وأقلها كفاءة إيقاعياً، رغم أهميته، بحكم أنه فاصل بين مرحلتين أساستين، مرحلة ما قبل زواج “عالية” في اليوم الرابع، وزواج “يوسف” في اليوم الخامس، صحيح أنه لا يخرج عن نفس سياقات السير والمحادثة الطويلة، ولكنه لم يكن متشعباً بالقدر الكافي، ليس فقط بالمعلومات ولكن بالمشاعر وهي الأهم، لأن المعلومات في هذا النوع من البناء تحترق سريعاً، لكن ما يحافظ على التواصل بين الأيام المختلفة هو المشاعر المتدفقة بين الشخصيتين، حتى في لحظات انفصالهما الظاهري أو القسري.
في وداع العالم القديم
يمكن اعتبار اليوم الخامس هو أفضل الأيام الست من حيث البناء والإيقاع والتطور الدرامي والتطابق بين السردية الرومانتيكية والإشارة الاجتماعية المبطنة عن العالم المولي، ينتهي اليوم الرابع بتعرض “يوسف” للضرب على يد مجموعة من الشباب – في انعكاس للعلقة التي كان يجب أن يأخذها قبل سنوات في عام 2006 في اليوم الأول بسبب “عالية” الصغيرة التي اسكتت مجموعة من الشباب في السينما بشكل صارم، أو على حد الجملة الافتتاحية لليوم التي تكتب على الشاشة تحت رقم الأيام وتاريخ السنوات (لازم نحوش عن بعض)، بينما كان “يوسف” الصغير مضطرباً نتيجة شعوره بأنه على وشك التعرض للضرب أمامها.
في نهاية اليوم الرابع وبعد ما يقرب من الخمسة عشرة عاماً يتعرض “يوسف” للضرب الشديد نتيجة رغبته في الزود عن “عالية”، أو تنفسياً للغضب المحتقن بداخله جراء معرفته بمشكلتها مع زوجها المليونير، ثم يفتتح اليوم الخامس بصوان عزاء – وهو ما بدا مضحكاً لا يتناسب تماماً مع جدية الموقف، أو أهميته في تطوير اللحظة المفصلية بينهم، ومثل هذه التتابعات غير المدروسة كانت تحتاج إلى مزيد من الانتباه الإخراجي حتى لا تتطور إلى ضحكات من الجمهور في الصالة.
يبدأ اليوم الخامس بصوان عزاء والد “يوسف”، وقدوم “عالية” لتعزيته ثم تمشيتهما المعتادة – مثل كل تمشية في يوم 19 ديسمبر المميز- ولكن هذه المرة تجمعهما شوارع المنيل القديمة – أول موطئ لقدم محبتهما- وهناك تحدث المصارحة، يعدد “يوسف” لـ”عالية” كل ملامح التغيير الاجتماعي والإنساني الذي دهس عالمهما القديم، وحطم حلمهما المراوغ في أن يكونا سوياً أو حتى أن يحافظا على قدسية يومهما البكر الجميل.
يبوح “يوسف” بألمه تجاه شجرة الحي المقطوعة، وبائعة الجرائد المتوفاة، وغيرها من مظاهر التحولات الزمنية الحادة والمخجلة التي تفسد الواقع وتجعل التشبث بالذكرى نوع من العبث أو السذاجة، ولا تجد “عالية” ما ترد به عليه سوى أن تبوح له بكل ما تراكم في داخلها عبر سنوات من محاولات التقارب، والذي بدا مستحيلاً وممكناً في كل مرة!
هنا لا يجد “يوسف” سوى أن يحتضنها بشدة لينفصل الصوت كلية عن الشريط البصري، وكأن العالم خلا من البشر والحركة سواهم! وهي ذروة عاطفية رائعة، وتزداد روعتها مع تلقي “يوسف” اتصالاً من زوجته التي لا تدري عنها “عالية” أي شئ.
الهوي أيضاً سلطان
في اليوم السادس والأخير نشاهد “يوسف” وهو يقف وحيداً أمام النيل، المحبوس خلف قضبان حديدة مدببة استكمالاً لحالة التردي الواقعي، وفساد روح المدينة، وبطلان ما تبقى من سحرها، المدينة التي شاهدنا ملامحها في أكثر من موضع خلال الأيام الست، والتي شكلت جزءاً مهماً من تفاعل الشخصيات مع الواقع، واللذان لم يجتمعا أبدا في بيت أو مكان مغلق باستثناء سيارة، ومقهى، وقاعة السينما – سينما جالاكسي الشهيرة بالمنيل وهو نفس الحي الأول للصبيين ومشاعرهما الدافئة- ومع عودة “يوسف” للعمل كطبيب أسنان وعمل “عالية” كمنسقة افراح وتقدمهما النسبي في العمر دخولاً إلى سن الثلاثين، نشعر أن الفيلم يقدم لنا انعكاس نسبي لما سبق وإن قدمته المخرجة هبة يسري في فيلمها الرومانسي الاجتماعي “الهوى سلطان” قبل شهر واحد فقط، بل يستثمر صناع “6 أيام” تصويرهم للفيلم الذي انتهى مؤخراً في وجود “الهوى سلطان” بالفعل في دور العرض، ليصبح هو الفيلم الذي يجتمع على مشاهدته “يوسف” و”عالية” في صدفة قدرية جديدة!
وسواء كان هذه تحية إلى صانعة الفيلم، أو استغلالا لعنوانه المتسق جداً مع حالة “يوسف” و”عالية” – كما كانت حالة بطلا “الهوى سلطان” “علي” و”سارة” – فإن دمج الفيلمين بهذا الشكل الرقيق والمفعم بالمشاعر والميلودرما العاطفية المحببة، بدا ارتجالاً إبداعياً يحسب لصناع “6 أيام”، خاصة مع استدعاء مشهد البداية – جلوس “عالية” و”يوسف” في مقعدين متجاورين بنفس السينما يشاهدان فيلم “دنيا”، بعنوانه الذي حمل دلالات كثيرة متسقة مع نمو الصراعات الشعورية والحياتية التي شهدناها، وكأنه مهما فعلت بهما الـ”دنيا” فـ”الهوى سلطان” في النهاية.
ورغم أن الخاتمة تعيد تذكيرنا بالفيلم الإنجليزي –الذي يستدعي اليوم الأول من علاقة الشابين- إلا أن عنصر العود على بدء في الفيلم المصري لا يخلو أيضاً من وجاهة فنية متسقة مع سياق القصة ككل، فليس أجمل من التعبير عن اكتمال الشخص بنصفه الآخر من الارتداد إلى لحظة انطلاق الشرارة الأولى في زمن الصبا.
تبقى الإشارة إلى أن كريم شعبان في أولى تجاربه الطويلة انتهج منحى بصرياً وإخراجياً هادئأً، آيه سماحة على سبيل المثال في أحسن حالاتها توجيهاً وأداءاً مدركاً لطبيعة الشكل الذي حدده سيناريو السير والمحادثة، صحيح أن المعادلات البصرية للحوار قليلة، خصوصاً مع طول الديالوجات، ولكن يبدو الخيار الفني متناغماً مع الرغبة في التركيز على ما يدور بين “يوسف” و”عالية”، خصوصاً تدفق الجمل بينهما، والتي لا تحتاج كثيراً إلى معادل بصري يعبر عما وراءها؛ فهي مفهومة وواضحة وبسيطة في بنائها اللغوي والخيالي، كما لا يمكن إنكار ذوقه الصوتي الحساس في التعامل مع حضور الأغاني في خلفية اللقاءات بشكل عفوي وغير مقحم، وتدرج مستوى الحضور من الخلفية البعيدة كصدى سحري، وصولاً إلى تصدرها شريط الصوت بشكل يجعلها تدعم ذروة اللقاء في نهاية كل يوم. كما تجدر الإشارة إلى فهمه لطبيعة التوجه الواقعي والاجتماعي للنص، فلا ألوان براقة ولا مبالغات في القتامة او شح الضوء، بل مصادر إضاءة عادية وطبيعية تعكس حاضر معاش لا يختلف كثيراً بين داخل الشاشة وخارجها.
* ناقد فني