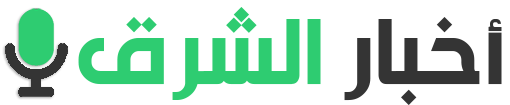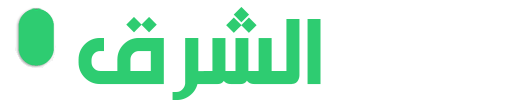جذور الإسلاموية.. الدولة العثمانية والوحدة الإسلامية

ياسين أقطاي يني شفق
لعلّ من الأجدر أن نُطلق على هذا البحث اسم “أركيولوجيا الإسلاموية”. إذ إن الدراسات التاريخية والاجتماعية التي تناولت الإسلاموية غالبًا ما أبدت شغفًا مفرطًا بتأريخها كحركة أيديولوجية نشأت في القرن التاسع عشر كردّ فعل على موجة التغريب. وهذا التوصيف يقدَّم الإسلاموية على أنها استجابة تابعة أو متأثرة بالغرب، وحركة تظل إلى حد ما ضمن حدوده ومجال نفوذه. وبهذا التصور، يصبح من السهل تجاهل جميع أطروحاتها ومقترحاتها وخطاباتها، بل والتعامل معها مجددًا بذات الأدوات الغربية. ولكن للإسلاموية بُعد آخر يتجاوز مجرد معارضة التغريب أو الاستعمار، فهي تتضمّن أبعاداً نقدية وتحمل إجابات عن إشكاليات داخلية في بنية الإسلام نفسه، إجاباتٍ ليست وليدة القرن التاسع عشر، بل هي خطابٌ متجذر في صميم الإسلام، يتجدّد عبر العصور.
فما هو أصل الإسلاموية؟ إذا كانت الإسلاموية قد نشأت بالفعل في القرن التاسع عشر، فهل يعني هذا أنها لا تمت بصلة إلى تراث الإسلام الممتد على مدى ألف وأربعمئة وخمسين عامًا؟ فمثلا ألا يمكن اعتبار فكرة الوحدة الإسلامية التي تميز الإسلاموية والتي يجمع عليها جميع الإسلاميين، أصلًا لها؟ وإذا صحّ ذلك، فهل يُعقل أن تكون ولادة هذا الأصل قد تأخرت إلى القرن التاسع عشر، أي بعد اثني عشر قرناً من بزوغ فجر الإسلام؟
ثمة رأي شائع مفاده أن فكرة الوحدة الإسلامية برزت بشكل خاص في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، عبر توظيف مؤسسة الخلافة كوسيلة لتعزيز التضامن في العالم الإسلامي. وهذا الرأي صحيح إلى حد ما، ولكن يبالغ فيه إلى حد الادعاء بأن فكرة الوحدة الإسلامية لم تكن مطروحة في العصور السابقة، وأنها كانت مجرد نتاج لهذا التوظيف البراغماتي.
والحقيقة أن فكرة “الأمة الإسلامية” كانت حاضرة منذ بزوغ فجر الإسلام. فمناسك الحج، وتوحيد القبلة لجميع المسلمين حول العالم، شكّلا دوافع موضوعية وحقيقية لتعزيز الوحدة بين المسلمين عبر التاريخ. كما أن منصب الخلافة وإن لم يُستخدم بفعالية دائمة أو لم يتمكن من بسط نفوذه دائما في جميع أنحاء العالم الإسلامي ظلّ يمثل جميع مسلمي العالم واعتُبر رأس الكيان السياسي للأمة الإسلامية. ولكن ضَعْفُ التأثير الفعلي للخلافة في بعض المراحل لا يعني غياب الشعور بهذا الكيان السياسي، بل يدل فقط على تراجع تأثيره فقط. أما الذين يبالغون في التأكيد على أن الخلافة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني لم تكن سوى أداة جيوسياسية لمعادلة القوى في مواجهة الإمبريالية الأوروبية، فإنهم بذلك يقلّلون على نحو غير منصف من أهمية وجودها أو ودورها في الفترات السابقة.
ولكن على غرار جميع مظاهر الوعي بالهوية الإسلامية، فإن العديد من المؤسسات الإسلامية لا تُستحضر وتُمنح أهمية أكبر إلا عند الشعور بتهديد أو تعرض لهجوم خارجي. ويُجسّد هذا الأمرُ بجلاء المعاني المجازية الكامنة في مفهوم “سياسة الجسد”. فالعضو الذي يعتلّ في الجسد هو ما يُستشعر به أكثر. والهجمات الخارجية تُطلق آليات الدفاع في الجسد، وتُفضي إلى وعي متجدد به، وتعزز من تماسك أعضائه. ومن ثمّ فإن استحضار الخلافة ـ التي تمثّل وحدة الجسد الإسلامي ـ في مواجهة التحديات الغربية، وما يصاحب ذلك من تشكُّل خط تضامن حولها، يُعدّ بمثابة استجابة طبيعية للغاية للجسد. وهناك قاعدة اجتماعية تؤكد أن الاعتداءات الخارجية تعزّز من التضامن الجماعي. فالعناصر المتباعدة أو المتنافرة أو المتخاصمة داخل المجموعة الواحدة، تميل بطبعها إلى التوحّد والتضامن، واتخاذ موقف مشترك، أو اكتشاف هوية جمعية مشتركة عند التعرّض لعدوان خارجي.
وهذا ما يفسر العديد من سمات الحركة التي ظهرت كـ “الإسلاموية” في أواخر الدولة العثمانية، والتي تميزت بهذا الإدراك والوعي وردود الفعل الدفاعية. فالحركة السياسية التي ظهرت حينها تحت هذا المسمّى ليست في جوهرها سوى امتداد للحركات التي عرفها التاريخ الإسلامي في كل عصر، والتي تمثلت في صور الإحياء، أو التجديد، أو الجهاد، وكانت في حقيقتها بمثابة استجابات حيوية للتهديدات الخارجية أو العدوى الداخلية. وقد أدرج أبو الأعلى المودودي، في كتابه حركات الإحياء في الإسلام، كلاً من الأئمة الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، والإمام الغزالي، وابن تيمية، بالإضافة إلى أحمد السرهندي المعروف بالإمام الرباني، والشاه ولي الله الدهلوي، بوصفهم حلقات مهمة في هذا التاريخ.
إن عدم ظهور أي حركة أو فكر إسلاموي مماثل لما ظهر في القرن التاسع عشر، من داخل الجسد السياسي العثماني، الذي مثّل على مدى قرون تجسيدًا فعليًّا لوحدة الإسلام، يُعزى غالبًا إلى كفاءة هذا الجسد، الذي ظلّ يؤدي وظائفه، بدرجات متفاوتة، دون أن يشهد اختلالًا جذريًّا. ورغم ذلك ظلّ هناك دائمًا تيار من العلماء داخل الدولة العثمانية يعبّر بصمت وفاعلية عن رفضه لانتشار المعتقدات الباطلة والخرافات التي تتنافى مع الفهم الصحيح للإسلام. وفي المراحل التي بلغت فيها العدوى إلى مستويات متقدمة، تَشَكّلت حركة “قاضي زاده”.
لقد شكّل القرن التاسع عشر منعطفاً تاريخياً، فقد هاجم كيان سياسي غربي العالم الإسلامي بكل عدّته وعدوانيّته، واحتل أراضيه، مكتسحاً تدريجيا موازين القوى العالمية. وأفرز هذا الاختلال العميق في ميزان القوة وضعًا مبهمًا، تطلّب من الوعي الإسلامي تفسيرًا ملحًّا: فكيف لأتباع الدين الحق أن يصبحوا بهذه الهشاشة أمام الغرب الذي يمثل الباطل؟ هل المشكلة في دينهم؟ أم في فهمهم لهذا الدين؟
وعند التمحيص، يتضح أن ما نبت وترعرع باسم الإسلام من خرافات وجهل وخمول يستحيل أن يكون من حقيقة هذا الدين. غير أن الهجمات التي تعرض لها المسلمون لم تستهدف الجسد وحده، بل طالت أيضًا الوعي الإسلامي الذي يُضفي الروح على هذا الجسد. وكان من الجليّ أن فقدان هذه الروح سيؤدي حتماً إلى اندثار الجسد ذاته. ولهذا السبب فإن الخطاب الإسلاموي الذي برز في القرن التاسع عشر اتسم بكونه خطابًا محافظًا ودفاعيًّا بطبعه؛ فهو صرخة جسد لا يزال حيًّا، وإن أنهكه الدهر وأثقلته العلل، لقد نشأت هذه الحركة كرد فعل على الهجمات الواردة والتهديدات التي استشعرتها.
ومن هنا، كان من المحتم سياسيا أن تتصدر فكرة “وحدة الأمة الإسلامية” المشهد بوصفها المحور الأساسي لهذه الحركة. ولذلك فإن فكرة “الوحدة الإسلامية” كانت المحور الرئيسي والقاسم المشترك لجميع الإسلاميين ابتداء من عبد الحميد الثاني، وما تلاه من التيارات الإسلاموية في عصره، كمجلة “سبيل الرشاد” وصحيفة “بيان الحق”، بل وحتى داخل جمعية “الاتحاد والترقي”. ففكرة الوحدة الإسلامية كانت أيضًا السبيل الوحيد الممكن للحفاظ على وحدة الجسد السياسي العثماني. ولهذا لم تكن حتى العناصر غير الإسلاموية في حزب الاتحاد والترقي ـ الذي يزعم السعي إلى “الاتحاد” ـ بمنأى عن هذه الفكرة. ولكن لا شك أنهم كانوا يختلفون في مدى شمول هذا الاتحاد، وفي مثله العليا، وفي الممارسات السياسية التي تطبّق في سبيل تحقيقه.
(يتبع..)