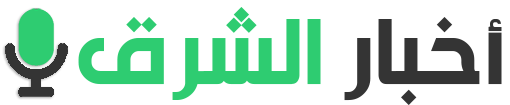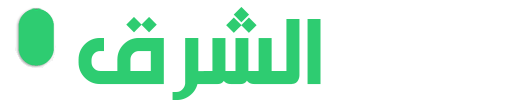أسير الشوك ورهين القرنفل | جريدة الرؤية العمانية

نور بنت محمد الشحرية
حين كتب زعيم حركة حماس يحيى السنوار “الشوك والقرنفل”، لم يكن يدوّن حكاية ذاتية، بل أرّخ لوجع شعب مُحاصر، واختار من بين رماد القهر أن يزرع وردة أمل. لم تكن الرواية مجرد سيرة ذاتية، بل كانت وعدًا مؤجلًا بالثأر النبيل والانتصار الهادئ الذي ينبت من شقوق الجدار.
في تلك الرواية، تجلّى السنوار ككاتبٍ يحمل قلبًا رحيمًا، يصف الألم لا ليُبكي القارئ، بل ليمنحه القوة. رجل يعرف تفاصيل الوجع، لا يكتبه من بعيد، بل من جوف النفق، ومن ظلال الزنزانة. من قرأ “الشوك والقرنفل” عرف أن السنوار لم يكن مجرد مقاتل، بل رجل يحمل في داخله إنسانًا مرهفًا، يُؤمن بالحب، ويتألم من أجل شعبه أكثر مما يتألم لنفسه.
هذا السنوار الكاتب، ليس نقيضًا لمن أعلن الحرب، بل هو دليله على أن من اختار السلاح لم يكن ساديًا، بل رجلًا لطيف القلب، طيّب النية، أجبره العالم على أن يقاتل كي لا يموت صامتًا.
لكن الأعجب من ذلك أن السنوار، في سنوات سجنه الطويلة، لم يكن مجرد أسير، بل كان مُفكّرًا صامتًا يُعيد رسم الخريطة. خلف القضبان، نسج خيوط العملية الأوسع في تاريخ الصراع. لم يحتج إلى ضجيج، بل إلى عزلة، ليحوّل الهزيمة إلى خطّة، واليأس إلى دهاء.
حين خرج من السجن، لم يخرج بلا شيء، بل خرج بمخططٍ كامل، بنظرة أبعد من القضبان، وعقلٍ يُدرك أنَّ المعركة ليست بعدد الجنود، بل بصلابة الإرادة وحكمة التوقيت.
ورغم الحصار، أنشأ السنوار قوة تفوقت على جيش يتجاوزها في كل شيء: في السلاح، في الدعم، في التكنولوجيا، وفي التحالفات. لكنه نسي أمرًا واحدًا: أنَّ غزة لا تُقاتل بما تملك؛ بل بما تؤمن به. وأن الغزّي لا تُقاس قوته بعدد عضلاته، بل بجلده على الصبر، وثباته حين يُخذل، وعزيمته التي تتغذى على الندرة والجوع والخطر.
في الرواية، لا يضطر الكاتب إلى تبرير فعلته، لكن التاريخ يُجبره على أن يشرح للقراء لماذا لم يعد الصمت خيارًا. لذا، حين اختار السنوار إعلان الحرب في 7 أكتوبر، لم يكن يركض خلف ضوء كاميرا؛ بل كان يوقظ العالم على صوت غابةٍ تحترق، لأنهم تجاهلوا كثيرًا لهيبها المختبئ تحت الرماد.
ومن يلوم السنوار على إشعال فتيل الحرب لم يذُق طعم الحصار، ولم ينَم على ركام منزله، ولم يحمل طفلًا شهيدًا بين ذراعيه. لذا فإن من لم يختنق بالغاز في نفق، ولم يفقد عائلته في غارة، لا يحق له أن يُعلِّم الفلسطيني كيف يُطالب بحقه. الحرب ليست خيارًا مُريحًا، لكنها أحيانًا الصرخة الأخيرة حين يصُمُّ العالم أذنيه.
وفي زنزانة موصدة على طرف الزمان، جلس السنوار على كرسيه مثلما جلس نيلسون مانديلا يومًا في سجنه. كلاهما سُلبت حريته عقودًا، لكن أحدهما خرج ليستقبل الفجر في جوهانسبرج، والآخر بقي في ليل غزة الطويل. كلاهما عاش في سجن، لكن الفارق أنَّ العالم بكى يوم سقط الأبارتايد (نظام الفصل العنصري)، بكى فرحًا، لأنَّ صفحة سوداء من التمييز العنصري طُويت. كانت دموعهم احتفالًا بانتصار العدالة، ومباركة لعهد جديد من المصالحة.
أما في غزة؛ فالعالم ذاته بارَكَ دمارها، واحتفى بانهيار جدرانها، وسقوط أجساد أطفالها، وكأنَّ العدالة لا تستحق أن تُولد من رحم فلسطيني.
السنوار لم يمت فجأة؛ بل مات واقفًا. مشهده الأخير ليس لحظة ضعف؛ بل لحظة بطولة، لا تنحني. كانت طريقة موته ختمًا على صلاحه، وتصديقًا لمبدئه، ووفاءً صامتًا لعقيدته. من كانوا يشككون فيه، الشجعان منهم فقط اعترفوا أنَّهم ظلموه حين لم يرَوا فيه سوى قائد عنيد متهور، وقاد شعبه للهلاك كما زعموا. أما البقية، فلم يُسمع لهم صوت في لحظة الحقيقة، إلا حين حاولوا التقليل من عظمة نهايته، مدّعين أنَّ المقطع مفبرك، وأن من ظهر ليس السنوار.
الأبطال لا يحتاجون بطاقة تعريف حين تسقط أجسادهم، فالنهاية التي تليق بهم تفضح الصامتين وتُسكت المشككين.
وحدهم الشرفاء في هذا العالم من كل ملةٍ وعرقٍ ولسان أدركوا من رحيله حجم الخسارة.
حتى من كانوا يختلفون معه في الفكر أو في السياسة، وحتى الشعوب التي تحارب حكوماتها غزة وتخذلها، عرفوا أنَّ غيابه ليس مجرد غياب جسد؛ بل سقوط رمح كان يشُق العتمة بحَدِّ الإيمان.
في عيون الأحرار، لم يكن السنوار مقاتلًا فقط؛ بل كان حلمًا صامدًا تمرد على كل من قال إنَّ الهزيمة قدر، وإنَّ الاستسلام مخرج.