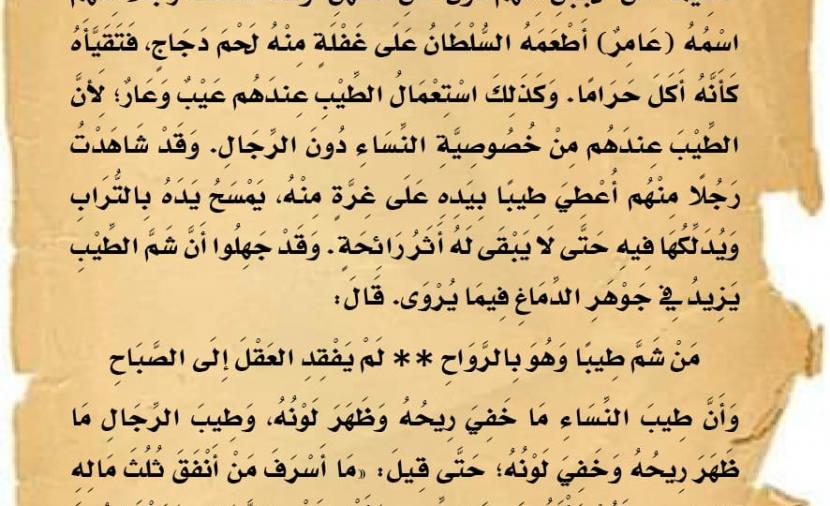تحقيق: ناصر أبوعون
قال الشَّيخُ القاضِي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ:[وَمِمَّا يُضْحِكُ عِندَهُم أَنَّ اِقْتِنَاءَ الدَّجَاجِ عَيْبٌ عِندَهُم، وَمِن أَعْظَمِ العَارِ، وَأَكْبَرِ النَّقْصِ أَكْلُ لَحْمِهَا وَبَيْضِهَا، لَا سِيَّمَا أَهْلُ الجَبَلِ مِنْهُم دُونَ أَهْلِ السَّهْلِ؛ وَقَدْ شَاهَدْتُ رَجُلًا مِنْهُم اسْمُهُ (عَامِرٌ) أَطْعَمَهُ السُّلْطَانُ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ لَحْمَ دَجَاجٍ، فَتَقَيَّأَهُ كَأَنَّهُ أَكَلَ حَرَامًا. وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الطِّيْبِ عِندَهُم عَيْبٌ وَعَارٌ؛ لِأَنَّ الطِّيْبَ عِندَهُم مِنْ خُصُوصِيَّةِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ. وَقَدْ شَاهَدْتُ رَجُلًا مِنْهُم أُعْطِيَ طِيبًا بِيَدِهِ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ، يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ وَيُدَلِّكُهَا فِيهِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرُ رَائِحَةٍ. وَقَدْ جَهِلُوا أَنَّ شَمَّ الطِّيْبِ يَزِيدُ فِي جَوْهَرِ الدِّمَاغِ فِيمَا يُرْوَى. قَالَ:
مَنْ شَمَّ طِيبًا وَهُوَ بِالرَّوَاحِ ** لَمْ يَفْقِدِ العَقْلَ إِلَى الصَّبَاحِ
وَأَنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيحُهُ وَظَهَرَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ؛ حَتَّى قِيلَ: “مَا أَسْرَفَ مَنْ أَنْفَقَ ثُلُثَ مَالِهِ فِي طِيبٍ”؛ فَهُمْ يَأْنَفُونَ مِنَ الطِّيبِ، وَأَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ، وَيَفْتَخِرُونَ بِحَلْبِ البَقَرِ، وَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا حَلْبَهَا نَفَخُوهَا مِنْ خَلْفِهَا، فَتَدِرُّ لَبَنًا غَزِيرًا بِذَلِكَ؛ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الكَرَاهَةِ نَقْلًا وَعَقْلًا].
…………..
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [(وَمِمَّا يُضْحِكُ عِندَهُم أَنَّ اِقْتِنَاءَ الدَّجَاجِ عَيْبٌ عِندَهُم، وَمِن أَعْظَمِ العَارِ، وَأَكْبَرِ النَّقْصِ أَكْلُ لَحْمِهَا وَبَيْضِهَا، لَا سِيَّمَا أَهْلُ الجَبَلِ مِنْهُم دُونَ أَهْلِ السَّهْلِ].
مراتب الضحك في العربية
[مِمَّا] تتكوّن من مقطعين (حرف الجر (مِنْ)+ (ما) الزائدة)، وتقع ضمن باب في فن الإملاء ويُسمّى (الوصل والفصل)”(01) [يُضْحِكُ]؛ فعل لازم يدل على الانبساط والسرور، وفي اللغة العربية رصد لنا الثعالبيّ مراتب الضحك، وهي: (التبسُّمُ)، ثم (الإِهْلَاسُ)؛ أي: إخفاؤه، ثم (الافْترارُ، والانكِلَالُ)، وهما الضحك الحسن، ثم (الكَتْكَتَةُ)؛ وهي درجة أشد من الانكلال، ثم (القَهْقَهَةُ)، و(القَرْقَرَةُ) و(الكَرْكَرَةُ)، ثم (الاستغراب)، ثم (الطَّخْطَخَةُ) وهي: أن يقول: طِيخ، طِيخ، ثم (الإهْزَاقُ والزَّهْزَقَةُ)؛ وهي: أن يذهب الضحكُ به كُلَّ مذهبٍ”(02).
اِقْتِنَاء الدَّجَاجِ عَيْبٌ في ظفار
[اِقْتِنَاء] مصدر من الفعل المتعدي (اقتنى)، ومعناه في السياق: اتخاذ الشيء للنفس لا للبيع. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول أبو المُثَلِّم الهُذَليّ، يمدح قومًا: “وَجَدْتُهُمُ أَهْلَ (الْقِنَى) فَـ(اقْتَنَيْتُهُمْ)/ وَأَعْفَفْتُ فِيْهِم مُسْتَرَادِي وَمَطْعَمِي(03)“[الدَّجَاج] اسم جنس مفرد، بفتح الدال المهملة (دَجاج)، وفي لغة أخرى بضم الدّال(دُجاج)، وجمعه على صيغتين: (دجائج)، و(دُجُج)، ويُطلق لفظه ولفظ مفرده على الذكر والأنثى، وهو طائر أهليٌّ قصير الجناحين والذَّنَب، له منقار حاد وثلاث أصابع في قدميه، ينتفع الإنسان في غذائه من لحمه وبيض أناثه. ونقرأ شاهده في قول الأسود بن يَعْفُر النَّهْشَليّ:” بَكَرْتُ عَلَيْهِ، وَالدَّجَاجُ مُعَرِّسٌ/ جَثُومٌ، وَضَوْءُ الصُّبْحِ لَمْ يَتَبَيَّنِ(04)“[عَيْب] النقص الخُلُقيّ المُلْحِق ذمًّا، وهو مفرد، وجمعه: (عيوب). ونقرأ شاهدها اللغويّ في قول تأبط شرًّا الفهميّ:”وَآخَرُ مِثْلَهُ، لَا (عَيْبَ) فِيْهِ/ بَصَرْتُ بِهِ لِيَومٍ غَيْرِ دَوِّ (05).
“[العَار] كلُّ ما يُعابُ به، ويُوبّخُ عليه. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول جعفر السَّبيعيّ الهَمَدانيّ:”فَلَا تَقْعُد عَلَى ذلٍّ لِمَلْكٍ/ فإنَّ الذُّلَّ أَكْبَرُ كُلِّ (عَارِ) (06)“[النَّقْصِ] العيب ناتج عن حماقة لا تُدَاوى. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول المُثَقِّب العَبْدِيّ “وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّمَ نَقْصٌ لِلْفَتَى/ وَمَتَى لَا يَتَّقِ الذَّمَ يُذَمْ(07)“.
إعراب لا سيّما وما بعدها
[لَا سِيَّمَا] “اختلف النُّحاةُ في عَدِّ (لا سِيَّما) من أساليبِ الاستثناءِ، والصَّحيحُ أنَّها ليست من أدواتِ الاستثناءِ؛ إذ لا يجوزُ إيقاعُ (إلَّا) مَوقِعَها، والمشهورُ والمعروفُ أنَّ ما بعد (لا سِيَّما) أَولى بالمُسنَدِ الذي لِما قبلها من المُسنَدِ إليه؛ فإذا قُلتَ: تفوَّق القومُ لا سيَّما زَيدٌ. تريدُ أن زيدًا أَولى النَّاسِ بالتفَوُّقِ، لا أنَّه خارجٌ من المُسْتَثنى منه، وأنَّه لم يتفوَّقْ؛ ولهذا لا يجوزُ إحلالُ (إلَّا) محَلَّها. فأمّا إعراب (لَا سِيَّمَا) (لا): حَرفٌ ناسِخٌ مَبْنيٌّ على السُّكونِ لا مَحَلَّ له مِنَ الإعرابِ. (سيَّ): اسمُ (لا) النَّافِيةِ للجِنسِ مَبْنيٌّ على الفَتحِ في مَحَلِّ نصبٍ. (ما): إمَّا حرفٌ زائِدٌ، وإمَّا اسمٌ موصولٌ. وأمّا إعرابُ ما بَعْدَ لا سِيَّما؛ فله حالات مختلفة: فإذا كان الاسمُ بَعْدَها نَكِرةً فيجوزُ فيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ: الجَرُّ، الرَّفعُ، النَّصْبُ، وهي على الترتيبِ مِن حيثُ القُوَّةُ، وإذا كان الاسمُ بَعْدَها مَعرِفةً فيجوزُ فيه وَجهانِ: الجَرُّ، الرَّفعُ”(08).
أهل الجبل في ظفار
وقول الشيخ عيسى الطائي: [أَهْلُ الجَبَل] إشارة إلى سكان سلاسل جبال ظفار الممتدة “من الشرق إلى الغرب بطول حوالي (400 كيلومتر) من قُبَالة (جزر الحلانيات) إلى الحدود مع الجمهورية اليمنية، وهي تشكل سلسلة جبال واحدة متصلة أبرزها (جبل سمحان) في الشرق، وهو الأعلى ارتفاعًا و(جبل القمر) في الغرب؛ أو (غب القمر) كما ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب وتتقاسمه اليمن وسلطنة عُمان وجبل (القرا) يتوسط بينهما، وهو الأكبر حجمًا ومساحةً”(09). أمَّا [أَهْلِ السَّهْلِ]؛ وهم سكان الحواضر والمدن، وهي: (سدح)، و(حدبين)، و(مرباط)، و(طاقة)، و(صلالة عاصمة ظفار)، و(ريسوت)، و(رخيوت)، و(ضلكوت).
تقيأ الدجاج كأنه أكل حرامًا
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَقَدْ شَاهَدْتُ رَجُلًا مِنْهُم اسْمُهُ (عَامِرٌ) أَطْعَمَهُ السُّلْطَانُ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ لَحْمَ دَجَاجٍ، فَتَقَيَّأَهُ كَأَنَّهُ أَكَلَ حَرَامًا].
[رَجُلًا] (رجُل) بضم الجيم المعجمة، أو بسكون الجيم (رَجْل) الذكر من الناس إذا شبَّ واحتلم. ويُجمع على صيغتين (رِجَال – رَجْلَة). ونقرأ شاهده في قول مالك بن فهم الأزديّ: “أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ أَبْنَاءَ فَهْمٍ/ بِمَأْلُكَةٍ مِنَ (الرَّجُلِ) الْعُمَانِيّ(10)” [مِنْهُم] (مِنْ) هنا للجنس، يقصد (مِن سكان أو أهل الجبل)؛ ونقرأ شاهدها اللغويّ في قول الله:{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ(11)} [أَطْعَمَهُ السُّلْطَانُ] السيد تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (1886م1965م) سلطان عُمان ومسقط وترتيبه السادس في حكم عُمان من 15 أكتوبر 1913م، إلى 10 فبراير 1932م.[أَطْعَمَهُ] فعل مُتعدٍ، أي: جعل الدجاج طعامًا، وقدّمه له ليأكله. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول مهلهل بن ربيعة التغلبي:”النَّاحِرُ الْكُومَ مَا يَنْفَكُّ (يُطْعِمُهَا)/ وَالْوَاهِبُ الْمِئَةَ الْحَمْرَا بِرَاعِيْهَا(12)“[عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ] (غَفْلَة) (مصدر) من (غ. ف. ل)، أو (اسم مَرَّة) من (الغفول)، أي: الذهول. وتعني السهو وعدم التنبُّه. ونقرأ شاهدها اللغويّ في في قول كعب بن زهير بن أبي سُلْمى المُزَنيّ:” (غَفَلَتْ) (غَفْلَةً)، فَلَمْ تَرَ إِلَّا/ ذَاتَ نَفْسٍ، مِنْهَا، تَكُوسُ غَقِيْرَا(13)” [فَتَقَيَّأَهُ] فِعْلٌ مُتعَدٍّ، ومَعناه: بَالَغَ في استخراج ما في جوفه عامِدًا مُتَكَلفًا، ونقرأ شاهدها اللغوي في الحديث النبويّ: “عن حضين بن المنذر الرقاشي، قال: شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وقد أوتي بالوَليدِ بنِ عقبةَ وقد صلَّى بأَهْلِ الكوفةِ أربعًا، وقالَ: أزيدُكُم قالَ: فشَهِدَ عليهِ حُمرانُ ورجلٌ آخرُ. قالَ: فشَهِدَ عليه أحدُهُما أنَّهُ رآهُ يشربُها وشَهِدَ الآخرُ أنَّهُ رآهُ يقيئُها. قالَ: فَقالَ عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ لم يَقيئها حتَّى شربَها قالَ فقالَ عثمانُ لعليٍّ: رضيَ اللَّهُ عنهما أقم عليهِ الحدَّ فقالَ عليٌّ لابنِهِ الحسنِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أقم عليهِ الحدَّ . فقالَ الحسَنُ: ولِّ حارَّها مَن تولَّى قارَّها قالَ: فقالَ عليٌّ لعبدِ اللَّهِ بنِ جعفرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أقِم عليهِ الحدَّ فأخذَ السَّوطَ فجعلَ يجلِدُهُ وعليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ يعدُّ حتَّى بلغَ أربَعينَ ثمَّ قالَ لَهُ: أمسِكْ. ثمَّ قالَ: إنَّ النَّبيَّ (صلى الله عليه وسلم) جلدَ أربعينَ وجلدَ أبو بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أربعينَ وجلدَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ ثمانينَ وَكُلٌّ سنَّةٌ وَهَذا أحبُّ إليَّ”(14)، ويُقال (استقاءَ) لمَن (بَالَغَ في استخراج ما في جوفه عامِدًا مُتَكَلفًا)، وفعل (الاستقاء)، أي: تقيأ عمدًا قال عنه ابن سيرين: “لم أعلَمْ أحدًا استقاءَ مِنْ طعامٍ غيرَ أبي بَكْرٍ رَضي اللهُ عنه فإنَّه أُتي بطعامٍ فأكَلَ، ثمَّ قيل له: جاءَ به النُّعَيمانُ، قال: فأَطعَمتُموني كهانةَ النُّعَيْمانِ؟! ثمَّ استقاءَ(15)“؛ لذا قال الشيخ عيسى الطائيّ: [كَأَنَّهُ أَكَلَ حَرَامًا]، و(الحَرَام) مصطلح في أصول الفقه، يشير إلى ما نهى عنه الشارع نهيًا جازمًا، وتوعّد فاعله بعقابٍ، وأثاب تاركه امتثالًا. ونقرأ شاهده الفقهيّ واللغويّ في قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ(16)}.
الطِّيبِ عَيْبٌ وَعَارٌ للرجال
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ:[وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ عِندَهُم عَيْبٌ وَعَارٌ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ عِندَهُم مِنْ خُصُوصِيَّةِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ. وَقَدْ شَاهَدْتُ رَجُلًا مِنْهُم أُعْطِيَ طِيبًا بِيَدِهِ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ، يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ وَيُدَلِّكُهَا فِيهِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرُ رَائِحَةٍ].
[الطِّيبِ] اسمٌ مفرد، وجمع: على صيغتين: (أَطْياب طُيوب)، وهو كلُّ شيْ يُتَعَطَّرُ به. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول الحارث بن كعب المَذحجيّ، يوصي بنيه: “زَوِجُوا النِّسَاءَ الْأَكْفَاء، وَإِلَّا فَانْتَظِرُوا بِهِنَ الْقَضَاء، وَلِيَكُنْ أَطْيَبَ طِيْبِهِنَ الْمَاء(17)” [خُصُوصِيَّةِ] مصدر صِناعيّ من (خ، ص، ص)، ومعناه تفرُّد الشيء عن غيره. ونقرأ شاهده في قول محمد بن الحسن الشيبانيّ: “إنَّ اللهَ تَعَالَى أَكْرَمَ نَبِيّنَا (صلى الله عليه وسلم)، بِأَنْ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ. وَقِيْلَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِسَائِرِ الْأّنْبِيَاءِ، وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ لِنِبيّنا(18)“[النِّسَاءِ] اسم جمع من (ن، س، و)، وهو جمع كلمة (امرأة) من غير لفظه. ومعناه: إناث الأناسيّ. ونقرأ شاهده في قول رقاش بنت مالك بن فهم الأزديّ. تعاتب أخاها الذي زوّجها دون إذنها:”أَنْتَ زَوَّجْتَنِي، وَمَا كُنْتُ أَدْرِي/ وَأَتَانِي (النِّسَاءُ) لِلتَزْيِينِ(19)“[يَمْسَحُ] يزيل أثر العطر عن يده. ونقرأ شاهدها في قول الطفيل الغَنويّ. يصف قدحًا من قِداح الميسر: “وَأَصْفَرُ مَشْهُومِ الْفُؤَادِ كَأَنَّهُ/ غَدَاةَ النَّدَى، بِالزَّعْفَرَانِ مُطَيَّبُ – تَفَلْتُ عَلَيْهِ تَفْلَةً وَ(مَسَحْتُهُ)/ بِثَوْبِي حَتَّى جِلْدُهُ مُتَقَوِّبِ(20)“[التُّرَاب] اسم من (ت. ر. ب)، وجمعه (أَتْرِبة)، وهو مَا لَانَ من أديم الأرض ونَعُمَ. ونقرأ شاهده في قول تأبَّط شرًّا الفهميّ. يصف شِعْبًا به ماءٌ صافٍ: “بِهِ نُطَفٌ زُرْقٌ قَلِيْلٌ (تُرَابُهَا)/ جَلَا الْمَاءُ عَنْ أَرْجَائِهَا، فَهُوَ حَائِرُ(21)“[يُدَلِّكُهَا]. يَحُكُّها ويدعكها. ونقرأ شاهدها اللغويّ في الحديث النبويّ: “وَضَعْتُ لِرَسولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) غُسْلًا وسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ علَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ قالَ: سُلَيْمَانُ لا أدْرِي، أذَكَرَ الثَّالِثَةَ أمْ لَا؟ ثُمَّ أفْرَغَ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ (دَلَكَ) يَدَهُ بالأرْضِ أوْ بالحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، وغَسَلَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، وغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ علَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً ، فَقالَ بيَدِهِ هَكَذَا، ولَمْ يُرِدْهَا(22)“.[أَثَرُ] بألف القطع المهموزة الفوقيّة، وفتح (الثاء المثلثة)، وفي لغة ثانية بسكون الثاء (أَثْر) وفي لغة أخرى (إثْرُ) بألف القطع المخفوضة، وسكون (الثاء المثلثة). ومعناه: بقية ما يُرى من العطر وما لا يُرى بعد أن تبقى فيه عُلْقَةٌ. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول جذيمة بن مالك بن فهم الأزديّ: “وَأَدْخَلَتْهُ عَلَيْهَا مِنْ لَيْلَتِهَا فَوَاقَعَهَا، وَاشْتَمَلَتْ عَلَى حَمْلٍ، وَأَصْبَحَ جَذِيْمَةُ فَرَأَى بِهِ آثَارُ الْخَلُوْقِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الآثَارُ، يَا عَدِيُّ(23)“.
شَمَّ الطِّيبِ يَزِيدُ جَوْهَرِ الدِّمَاغِ
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَقَدْ جَهِلُوا أَنَّ شَمَّ الطِّيبِ يَزِيدُ فِي جَوْهَرِ الدِّمَاغِ فِيمَا يُرْوَى. قَالَ: (مَنْ شَمَّ طِيبًا وَهُوَ بِالرَّوَاحِ**لَمْ يَفْقِدِ العَقْلَ إِلَى الصَّبَاحِ) وَأَنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيحُهُ وَظَهَرَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ؛ حَتَّى قِيلَ: “مَا أَسْرَفَ مَنْ أَنْفَقَ ثُلُثَ مَالِهِ فِي طِيبٍ“].
[جَهِلُوا] [شَمَّ الطِّيبِ] (شَمَّ) قال عالم الأحياء العصبية مايكل ياسا: (حاسة الشم تتمتع بامتياز خاص لكونها مرتبطة مباشرة بدوائر الذاكرة في الدماغ وتشير التجارب التي شملت 43 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 85 عامًا، إلى أن التدهور المعرفي وحالات مثل الخرف تتباطأ ببساطة عن طريق نشر مجموعة مختلفة من العطور قبل النوم كل ليلة)(24).[جَوْهَرِ الدِّمَاغِ] وكلمة (جَوْهَر) اسم فارسي مُعرّب، ومعناها: أصل كلُّ شيء وكُنهه وماهيته. و(الدِّمَاغِ) هو مخُّ الرأس، والجمع (أدمغة). ونقرأ شاهده في قول أبي صالح باذام في تفسير قول الله تعالى: {فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍۢ مُّبِينٍۢ} “غلت أدمغتهم في رؤسهم كما يغلي الماء في المرجل على النار من شدة الحر تحت السحابة(25)“.
الشروط الشرعية لطِيْب النساء
وأمّا قول الشيخ عيسى الطائيّ: [طِيبَ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيحُهُ وَظَهَرَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ]؛ فهو حديث نبويّ شريف؛ وهذا نصّه: “طِيْبُ الرجالِ: ما ظَهَرَ ريحُهُ وخفِيَ لونُهُ، وطيبُ النساءِ: ما ظَهَرَ لونُهُ وخَفِيَ رِيْحُهُ”(26)“. والعلة في قول النبيّ محمد (صلى الله عليه وسلم): (وطِيبُ النِّساءِ لَونٌ لا ريحَ له) يُبيّنها لنا حديث نبويّ آخر: “إذا استعطرتِ المرأةُ فمرَّت على القومِ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ(27)“، وأمّا قول الشيخ عيسى الطائيّ: (قِيلَ: مَا أَسْرَفَ مَنْ أَنْفَقَ ثُلُثَ مَالِهِ فِي طِيبٍ)، فهذه المقولة ليست بحديث نبويّ؛ ولا إسناد لها، ولم تَرِدْ في كُتب السُّنَّة، وإنّما ينسبها البعض إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطائفة تنسبها إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه والبعض الآخر يضعها على لسان الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ؛ ولكنها قول شائع يتناقله الناس استحبابًا وحَضًّا على اقتناء العطور، وهي من العادات التي دأب الأعم الأغلب من سائر البشر على اختلاف دياناتهم وأعراقهم؛ ولذا يقول بعض أهل العلم: “إن الإسراف في العادات شيء نِسْبيّ”؛ ومِنْ ثَمَّ لا يُعَدُّ الإكثار من اقتناء العطور إسرافًا، إلا في حالات، نذكر منها: ألَّا يستدين من أجله، أو يضر بنفقة أهله وأولاده، وألّا يبتاعه ويتطيّب به افتخارًا ومُبَاهاةً، وخُيَلاء، وألّا يُكْثرَ من التطيّب به في غير حاجة.
نفخ الناقة في ظفار والسودان
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [فَهُمْ يَأْنَفُونَ مِنَ الطِّيبِ، وَأَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ، وَيَفْتَخِرُونَ بِحَلْبِ البَقَرِ، وَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا حَلْبَهَا نَفَخُوهَا مِنْ خَلْفِهَا، فَتَدِرُّ لَبَنًا غَزِيرًا بِذَلِكَ؛ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الكَرَاهَةِ نَقْلًا وَعَقْلًا].
[يَأْنَفُونَ مِنَ الطِّيبِ، وَأَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ، وَيَفْتَخِرُونَ بِحَلْبِ البَقَرِ]؛ و”تلك العادات وليدة حكايات شعبية أو أساطير يتناقلها الأحفاد عن الأجداد(28)” وخلاصة القول: إن اختلاف عادات وتقاليد أهل ظفار كجماعة بشرية ليس بِدعًا؛ فهم مثل أي جماعة بشرية ذات خصوصية ثقافية حول العالم؛ “وما هذه العادات إلا أنماط متفق عليها، وتلقائية، وغير مكتوبة، ومتوارثة، ولها درجة عالية من العمومية، ولا ترتبط بأيّ جزاءات سلبيّة أو إيجابية(29)“[يَأْنَفُونَ] من الفعل الماضي المتعدي (أَنِفَ) بمعنى يتنزّهون وتعفُّ وتكره أنفسهم أكل لحم الدَّجاج وبيضه. ونقرأ شاهدها اللغوي في قول بدر شاكر السيّاب:” وَمَهْدِيَ اِخْتِلَاجَةُ الْبَغَايَا/ (تَأْنَفُ) أَنْ تَمَسَّني يَدَاكْ(30)“. وعادة أنفة أهل ظفار من أكل لحم الدجاج وبيضه والماعز والشِّيَاه؛ ذكرها برترام توماس، فقال: “أمّا المواشي (الماعز والشياه والأغنام) فتُربّى في منطقة قطن (هي منطقة المروج تقع خلف الجبال في ولايات صلالة، مرباط، طاقة، ورخيوت) بأعداد غير كثيرة، وفي المناطق التي ينمو فيها العشب، وفي منطقة سهل جربيب (يقع بين جبال ظفار وبحر العرب ويمتد من طاقة شرقًا إلى ريسوت غربًا)، كما تُربّى على نطاق واسع في منطقة السهل بسفح جبل سمحان. وتتألف هذه القطعان من الأغنام. وأهل الجبل لا يأكلون لحومها، وإنما يقدمونها في الولائم والمناسبات للضيوف، كما هو الحال بالنسبة للدجاج وبيضه(31)“[يَفْتَخِرُونَ بِحَلْبِ البَقَرِ](حَلْب) مصدر من (ح.ل.ب)، ونقرأ شاهده اللغويّ في الحديث النبويّ:” عن أبي ضِرارٍ بنِ الأزْورِ قال: أُهدِيَتْ لرسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) لَقحةٌ فأمرَني أن أحلبَها فحلبتُها فجهدتُ حلبَها فقال: دَعْ داعيَ اللبنِ(32)“[إِذَا أَرَادُوا حَلْبَهَا نَفَخُوهَا مِنْ خَلْفِهَا] (نَفَخُوهَا)، أي: دفع أحدهم الهواء من فمه في دُبِرها. ونقرأ شاهده في قول بكر بن غالب الجُرهميّ يذكر سرعة سير إبله إلى مكة، وقد حنَّ إليها:” وَهَلْ أُبْصِرَنَّ الْعِيْسَ (تَنْفُخُ) فِي الْبُرَى/ لَهَا فِي مِنًى بِالْمَحْرَمَيْنِ ذَمِيْلُ(33)“، وقد وصف برترام توماس هذه العادة، فقال: “دعيت لأشهد إحدى عمليات (نفخ البقرة)، والنفخ عادة منتشرة بين قبائل هذه المنطقة، ويعتقدون أنها تساعد البقرة على إدرار اللبن، وعند وصولي وجدت البقرة واقفة ورِجْلاها الخلفيتان مربوطتان ربطًا شديدًا، وكان هناك صبيٌّ يقف أمامها يقدّم لها الطعام لكي تستسلم للعملية، ثم اقترب صاحبها من مؤخرتها وسحب نفسًا طويلًا، ثم أمسك بذيلها ونحّاه جانبًا، ثم وضع فمه بعد ذلك في دُبرها وأخذ ينفخ بشدة ويتوقف بين الحين والآخر ليمنع خروج الهواء منها، ثم يمسك بأضرعها الأربعة، ويدلكها؛ لكي يتأكد من نجاح العملية. وقد قيل إن بعضهم يضع في فمه شيئًا من الملح عند النفخ(34)“، وهذه العادة موجود بشكل آخر في السودان بين قبائل (النوير) في السودان؛ وهي أنهم يمنعون النسوة من الإمساك بضرع البقرة قبل أن يحلبها الرجل. كما يجب أن يضع الرجل شفتيه على ضرع البقرة وينفخ فيه لتدر حليبا.
…………
المراجع والمصادر
(34) البلاد السعيدة، برترام توماس، ص: 112.