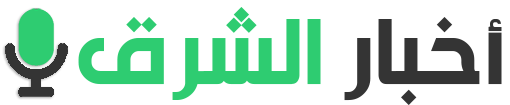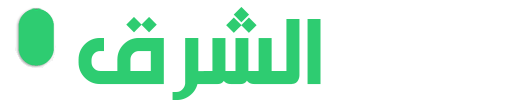من القرن القصير إلى الانهيار الطويل: أوروبا بين رفاه الأمس وقلق الغد

اخبار تركيا
سلّط تقرير تحليلي للكاتب والخبير السياسي التركي سليمان سيفي أوغون، الضوء على التحول العميق الذي شهدته أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مركزًا على تفكك النموذج الليبرالي الديمقراطي الذي هيمن على القرن العشرين، والذي بلغ ذروته بعد عام 1945 وانتهى رمزيًّا بسقوط جدار برلين عام 1989.
وتناول التقرير الذي نشرته صحيفة يني شفق كيفية تحوّل الأحزاب الوسطية اليمينية واليسارية من أدوات للاستقرار وبناء مجتمع الرفاه إلى قنوات ساهمت في تفريغ الديمقراطية من مضمونها، عبر تبني سياسات نيوليبرالية قوضت الإنتاج وأضعفت الطبقة الوسطى.
كما ناقش صعود التيارات المتطرفة والقبلية الثقافية، وعودة مناخات العداء والعسكرة، بما يشير إلى أن أوروبا المعاصرة تتجه تدريجيًا نحو مشهد شبيه بما قبل الحربين العالميتين، وسط تصاعد الخطر السياسي والاجتماعي في ظل غياب بدائل حقيقية.
وفيما يلي نص التقرير:
لقد عبّرت عن ذلك في كل فرصة: القرن العشرون هو فترة زمنية امتدت من عام 1945 حتى عام 1989. وليس عبثًا أن وصفه المؤرخ إريك هوبزباوم بـ”القرن القصير”. أما سبب اعتمادي عام 1989 كنهاية لهذا القرن، فهو سقوط جدار برلين، الحدث الرمزي الذي يُجسّد نهاية العصر.
وهذا بطبيعة الحال تقييم رمزي؛ لأن نهاية القرن العشرين لم تحدث فجأة عند هذا الحدث، بل حدث الانهيار على مراحل، ولا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا، حتى في عام 2025، أي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين من الناحية الزمنية.
ومن التطورات التي دفعتني للتفكير في هذا الانهيار ما جرى في إنجلترا قبل أسبوع. ففي الانتخابات المحلية الجزئية، تصدّر حزب “الإصلاح البريطاني”، بقيادة نايجل فاراج المعروف بعنصريته وعدائه للأجانب، قائمة الأحزاب في البلاد. بينما تكبّد الحزبان الكبيران اللذان شكّلا لعقود دعامتي الديمقراطية المستقرة في بريطانيا، وهما حزب العمال والحزب المحافظ، خسائر فادحة. ويبدو أن حزب الإصلاح والحزب الليبرالي الديمقراطي سيحلّان بسرعة مكان الحزبين التقليديين، ومن المرجّح أن يتنافس هذان الحزبان في أول انتخابات عامة قادمة.
لكن اعتبار ما جرى نهاية لنظام الحزبين الشهيرين في بريطانيا سيكون حكمًا متسرّعًا وبسيطًا. فرغم تغيّر البنية الداخلية، إلا أن الشيفرات لم تتغير. ففي المناخ السياسي للقرن العشرين، كانت الأحزاب اليمينية الوسطية واليسارية الوسطية تشكّل المحور الأساسي. وكان القاسم المشترك بينها هو كونها أحزابًا “معقمة” من كل أشكال التطرّف. فالمناخ السياسي الذي قاد أوروبا إلى الحربين العالميتين كان مناخًا ذا تطرّف أيديولوجي عالٍ واستقطاب شديد. وبعد انتهاء الحرب، تم القضاء على هذه الأجواء إما كما في ألمانيا عبر الإلغاء المباشر، أو كما في فرنسا من خلال التجميد ثم التفكيك.
كانت الأحزاب الوسطية تبدو وكأنها تتقاسم الأدوار فيما بينها لبناء “مجتمع الرفاه”؛ حيث كانت الأحزاب اليمينية تتولى إدارة الاستثمارات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز هذا الرفاه، بينما تتكفّل الأحزاب اليسارية بتوزيعه على الصعيد الاجتماعي. وقد عملت هذه المنظومة كترسين متكاملين داخل نظام واحد يشبه المضخة، وهو ما كان يُعرف حينها بـ”الاستقرار”.
وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت هذه البنية في العالم “المركزي” نموذجًا مثاليًا يُقَدَّم للدول “شبه المركزية” ذات المناخات السياسية المضطربة. وقد تم تقديم هذا النموذج المعتدل، المسمى بـ”الديمقراطية الليبرالية”، كرمز للتحضر، كونه خاليًا من التطرّف، ويزاوج بين المصلحة والعقل. وكان هذا النموذج يُدرّس ويُحلّل في كتب علم السياسة.
كان ذلك العصر الذهبي لأوروبا؛ أوروبا التي دعمتها الرأسمالية الأمريكية، وحمتها المؤسسة العسكرية الأمريكية، وأصبحت شعوبها، في غالبيتها، من الطبقة الوسطى. ومنذ عام 1945، خاصة الألمان، دخلوا في موجة إنتاج هائلة. وقد كانت نتيجة ذلك أيامًا مزدهرة ورائعة، بلغت ذروتها بين 1945 و1980، واستمرت بشكل أو بآخر حتى أوائل الألفية الثالثة.
لكن بعد عام 2000، بدأ كل شيء في الانقلاب رأسًا على عقب. فقد وقعت أوروبا في فخ “الطبقة الوسطى”. وبدأت تتكشف التأثيرات السلبية لمجتمع الرفاه، الذي يُضعف إنتاجية رأس المال والعمل معًا. والأسوأ من ذلك أن المعايير الأوروبية في الهندسة والتكنولوجيا أصبحت متخلفة كثيرًا عن التطورات التقنية والهندسية الجديدة.
تلقت أوروبا أولى ضرباتها من الداخل. فقد تبنت الأحزاب اليمينية الوسطية أيديولوجيا جديدة ذات طابع “أناركورأسمالي”، مفادها أن السبب الرئيسي في تراجع الإنتاجية هو “دولة الرفاه” والنفقات العامة. وعلى هذا الأساس، شنّ زعماء أمثال تاتشر وكول هجومًا على كل المؤسسات والمنشآت التي جعلت من أوروبا ما هي عليه، ما شكّل انهيارًا كبيرًا.
والأغرب من ذلك أن الأحزاب اليسارية الوسطية دعمت هذه التوجهات. فلم يكن ما فعله حزب العمال البريطاني بقيادة توني بلير مختلفًا عما فعله خصومه. إذ بدأت الأحزاب اليمينية الوسطية بفصل “الليبرالية” عن “الديمقراطية الليبرالية”، وحوّلتها إلى شكل من “الاقتصادوية” المتطرفة التي تتجاهل البعد الاجتماعي تمامًا. أما الأحزاب اليسارية الوسطية، فلم تكتفِ بعدم معارضة ذلك، بل شاركت فيه عبر توقيع سياسات داعمة ومكملة.
الأحزاب اليسارية التي انشقت عن هذا الوسط، ونظّمت نفسها تحت عنوان “اليسار الجديد”، حاولت إعادة إنتاج مفهوم الديمقراطية، ليس على أساس المطالب الاقتصادية، بل من خلال ثقافات وهوّيات جديدة. وبهذا ظهرت تيارات عرقية، وجندرية، وبيئية، كوّنت مسارات جديدة.
وخلاصة الأمر، أن الأحزاب الوسطية التي جمعتها الديمقراطية الليبرالية، تقاسمت المكونات بينها: فاليمين أفرغ الليبرالية من معناها الحقيقي وحوّلها إلى أداة اقتصادية محضة، واليسار حوّل الديمقراطية إلى ظاهرة ثقافية فاقدة للتوازن.
لكن هذه السياسات النيوليبرالية القائمة على الاقتصادوية لم تُجدِ نفعًا، بل زادت من تراجع الإنتاجية في أوروبا. أما نماذج “الديمقراطية الثقافية” التي ناقشها مفكرو “اليسار الجديد”، فلم تثمر عن “ديمقراطيات متعددة الثقافات”، بل أدّت إلى “قبائلية ما بعد الحداثية” وصراعات هوياتية وثأرية ثقافية.
في القرن التاسع عشر، وبفعل الثورة الصناعية وما أفرزته من مجتمع صناعي، تحوّل الغالبية الساحقة من السكان إلى طبقة بروليتارية. وكانت هذه الفئة البائسة تُضبط وتُؤطّر إما بلباس العمل (الأفرول) أو بالزي العسكري (الزي الموحد). في الحالة الأولى، كانت تعمل في ظروف مزرية مقابل ما يسدّ الرمق فقط، وفي الحالة الثانية، كانت تُرسل للموت جماعيًّا في الحروب.
أما في القرن العشرين، فقد تخلّت أوروبا عن الزي العسكري. أُلغيت الخدمة الإلزامية، وصغرت الجيوش إلى أقصى حد ممكن. بل إنهم لم يشعروا بالحاجة إلى تجديد معداتهم العسكرية لعقود من الزمن. واستفادوا اقتصاديًّا من هذا الوضع بشكل كبير، إذ تخلّصوا من عبء الإنفاق العسكري، ووجّهوا كل إمكاناتهم نحو التنمية، وأجادوا توزيع هذه التنمية فيما بينهم.
يُنظر إلى “مجتمع الرفاه” على أنه هدية التنمية الاقتصادية، وهذا صحيح إلى حدٍّ ما. لكن من منظور ديالكتيكي (جدلي)، فإن “مجتمع الرفاه” يُنتج في الوقت ذاته أثرًا يُقوّض التنمية من الداخل. والحال البائس الذي وصلت إليه أوروبا اليوم يُجسّد هذا الواقع تمامًا.
فأوروبا التي تراجعت مستوياتها التكنولوجية والهندسية، وتكبدت خسائر فادحة في الإنتاج، وارتفعت فيها معدلات البطالة، وانسحبت منها الضمانات الأميركية، تواجه اليوم خطر العودة إلى أجواء القرن التاسع عشر. ولذلك، فإن فهم صعود الفاشية والنازية والفالانجية مجددًا ليس أمرًا صعبًا على الإطلاق.
وقد اتخذوا قرارًا استراتيجيًّا يرافق هذا المشهد. الغريب أن هذا القرار جاء من الأحزاب الكبرى التي تُشكّل ركائز النظام المؤسسي، والتي تُسمي نفسها ليبرالية، رغم قلقها من صعود اليمين المتطرّف، ورغم استمرار عمل النظام ولو بصعوبة.
أما القرار فكان الاستعداد لمواجهة ما يُسمّى “الخطر الروسي” (أو الحرب مع روسيا)، وذلك من خلال إعادة عسكرة الاقتصاد.
الصورة غريبة للغاية: فالليبراليون، عبر هذا القرار، يُقدّمون خدمة عظيمة لليمين المتطرّف الذي بات من الواضح أنه سيجتاح أوروبا قريبًا.
أما أحزاب اليمين المتطرّف، التي لا تزال حتى الآن في صفوف المعارضة، فهي لا تنظر إلى روسيا بعداء كما يفعل الليبراليون، بل تبدو وكأنها تُكنّ لها تعاطفًا واضحًا. فهل نقول إذن: “ليبراليون محبّو للحرب ونازيون محبّو للسلام”؟ هذا سيكون خطأ فادحًا!
فما إن تصل هذه الأحزاب إلى السلطة، حتى تتبنّى روح العدائية نفسها التي بدأها الليبراليون، بل وترفع راية العداء لروسيا بحماس أشدّ.
وهنا يكمن الخطر المتصاعد الحقيقي.